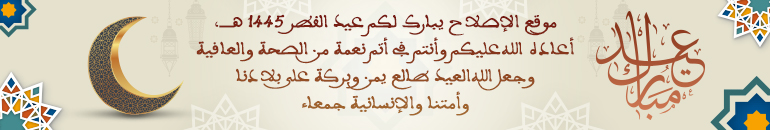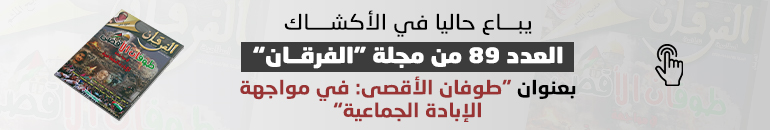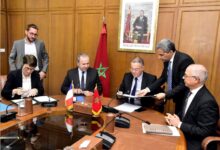عبد الرحيم شيخي: لغات التدريس، نقاش مثمر أم ترويج للمغالطات؟

نظرا لما تكتسيه منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أهمية في حياة مختلف الشعوب والمجتمعات والدول، وتزامنا مع مناقشة مشروع القانون الإطار رقم51.17 بالبرلمان، قدرنا في حركة التوحيد والإصلاح أن يكون إسهامنا في النقاش الدائر مسؤولا يستند إلى الموضوعية والعلمية والواقعية ما أمكن، ويبتعد عن المزايدات والعواطف. وذلك إيمانا منا بأن قضية التعليم في بلدنا كانت دوما وستظل قضية وطنية تهم الجميع، وتنعكس آثارها سلبا وإيجابا على الجميع حالا واستقبالا، ولا يجوز بحال أن نقاربها بمنطق “الغالب” و”المغلوب” أو باستحضار الحسابات الانتخابية الواسعة والضيقة.
وهكذا عكف ثلة من المتخصصين والمهتمين بقضايا التربية والتكوين على إعداد مذكرة للحركة في الموضوع خضعت لمدارسة ونقاش مستفيضين، مع صياغة تتوخى الدقة والوضوح دون إغراق في التفاصيل. وقد عرضت المذكرة في لقاء إعلامي مع عدد من الصحفيين من منابر إعلامية متنوعة، قاموا بطرح مختلف الأسئلة حول الموضوع وقدمت لهم الإجابات الواضحة دون تهرب أو تعميم. فتناولوا الموضوع إثر ذلك بنشر ما ارتأوه من مضامين وآراء وتحليلات.
كما أرسلت حركة التوحيد والإصلاح نسخا من المذكرة لعدد من الهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بالموضوع، وكذا لكافة الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، مع طلب لقاءات مع الفرق لبسط مضامين المذكرة والحوار بشأنها ترافعا من جانبنا وسعيا للإقناع بوجهة نظرنا وأيضا للإصغاء الواعي والمسؤول لكافة الآراء ولوجهات النظر الأخرى، وذلك تلمسا منا للصواب الذي ننشده جميعا. ولا نزعم في حركة التوحيد والإصلاح أننا نمتلكه، فربما جانبنا بعضه لقلة معطيات ومعلومات أو لرجحان مصالح خفيت عنا وأدركها غيرنا. وحتى في حال صواب ما ندعو إليه، لا ندعي أيضا أننا وحدنا على الرأي الأصوب والموقف الأسلم.
وقد تطور النقاش في موضوع القانون الإطار، تزامنا مع النقاش الدائر في اللجنة المعنية بالتعليم بمجلس النواب، وأسهم فيه متخصصون وخبراء ومفكرون ومهتمون وفاعلون، فضلا على عدد من الهيئات الجمعوية المدنية، والنقابية والسياسية. وإذ يعتبر هذا النقاش والحوار المجتمعي أمرا إيجابيا لما للموضوع من حساسية وأثر بالغ على مستقبل أجيال الغد، ومستقبل الوطن برمته، فإن الخطأ في الاختيارات المتخذة فيه تكتنفه مخاطر ومساوئ سيصعب تداركها بسهولة وقد يتعذر تصحيحها.
وفي خضم النقاش الذي لبس أحيانا لبوس الصراع، راجت جملة من المغالطات والأغاليط بإصرار من البعض الذي يحاول فرض خيارات معينة، وكان الأولى النأي بالنقاش عن أن ينزل إلى مستويات غير مقبولة، والارتفاع به لمستوى يتيح للمواطن فرصة الوقوف على حقائق الأمور في مسألة تشغل باله. وينير السبيل أمام متخذي القرار التشريعي ليتحملوا مسؤوليتهم عن بينة دون تشويش مفتعل أو اختباء وراء آراء مرجوحة وتحليلات مضلِّلة، وسعي غير بريء لتوافق هش أو إجماع مغشوش.
ولعل موضوع تدريس اللغات ولغات التدريس على رأس المواضيع التي راجت حولها الكثير من الأغاليط والمغالطات، استهدفت المدافعين عن المبادئ الكبرى التي اعتمدها رواد الحركة الوطنية وبناة نظام التربية والتعليم في المغرب المستقل. كما شككت في وطنية وولاء من دعا للتشبث بمقومات الأمة الدستورية تحت ذرائع واهية، حتى أصبحنا كأننا نبدأ من الصفر أو نعيد عجلة التاريخ للوراء. وهذه بعض المغالطات المتعلقة بالموضوع:
أولا: المدافعون عن اللغات الرسمية الوطنية (العربية والأمازيغية)، لغاتٍ أساس للتدريس، منغلقون معادون للغات الأجنبية وضد الانفتاح:
وهذه تهمة جاهزة لها وقع مباشر على المتلقي لا يراد منها إقناعه بقدر ما يراد دفعه لتكوين صورة ساخرة مشوهة عن هؤلاء المدافعين حتى لا يلتفت إلى ما يكتبونه. فماذا عساهم يقدمون له وهم منغلقون في زمن العولمة، متوجسون من الانفتاح، معادون للُغاتٍ أجنبية تملأ هواتفهم المحمولة وحواسيبهم، وهي لغاتُ دولٍ متقدمة يهفو أبناؤهم اليوم للعيشِ فيها لدرجة مخاطرةِ بعضهم بحياتهم في سبيل ذلك.
ولدفع هذه التهمة عن أنفسهم، تجد بعض المقتنعين بجعل اللغات الرسمية لغات للتدريس، متذبذبين في مواقفهم وخائفين من أن يوصموا بهذا العار فلا يكادون يبينون، ويظنون أنهم بذلك يبتعدون عن تلك “الأقلية” من “المدافعين المنغلقين الحالمين” أملا في أن يُحسبوا ضمن “أغلبية المنفتحين” من أهل العصر.
يراد بهذه التهمة إذن أن تحجب حقيقة دامغة تتمثل في كون شريحة هؤلاء المدافعين واسعة تضم علماء ومفكرين ومثقفين وخبراء وفاعلين من تيارات وطنية مختلفة، يشتركون، على اختلاف مرجعياتهم، في أنهم من الذين يؤمنون بجد بمقومات الهوية الوطنية “الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.” كما جاءت في ديباجة الدستور دون تجزيء أو سعي لإلغاء أو إقصاء أي من هذه المكونات، مع إيمانهم بأن “الهوية المغربية التي تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها”، لا تتناقض مطلقا مع “تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”.
وقد تناول عدد من الخبراء والمتخصصين الموضوع بالكتابة في عدد من المنابر الإعلامية بطريقة علمية موضوعية تجمع بين العلم بالمسألة اللغوية والخبرة في قضاياها لعقود من الزمن، والاطلاع على التجارب الدولية المتعددة والمتنوعة، التي تتجه في معظمها إلى التأكيد بالنسبة للغة التدريس على أن النجاح حليف من اختاروا التدريس باللغات الرسمية الوطنية، وحسب الباحث المنصف أن الدول العشرين المرتبة في ريادة التعليم لا تدرس بغير لغاتها الرسمية، حيث نجد، حسب ترتيب تيمس 2015، دولا كفنلندا وسلوفينيا وهنغاريا والسويد والنرويج وبلغاريا والتشيك وكرواتيا ذات الكثافة السكانية الضعيفة. وأن التدريس بهذه اللغات لم يكن في يوم ما عائقا عن الانفتاح على العالم وتطوارته العلمية والتقنية. إذ التدريس باللغات الوطنية لا يتعارض أبدا مع الانفتاح والتمكن من اللغات الذي لا خلاف بين القوى المجتمعية في أي بلد حول مبدئه، وإنما الخلاف والنقاش محوره ما اللغات الأجنبية ذات الأولوية التي ينبغي استثمار جزء لا بأس به من العمر في اكتسابها؟ ولكل مجتمع ظروفه ومصالحه واختياراته التي تحكم نظرته.
ثانيا: اللغات الأجنبية هي لغات العلم، وهي الأنسب لتدريس المواد العلمية والتقنية:
وهذه مغالطة أخرى تأتي بتصنيف جديد لا تسنده الدراسات العلمية ولا التجارب الدولية التي تظهر بوضوح أن العلم له قواعده وقوانينه العابرة للغات والثقافات وحتى العصور بما تحمله من منطق وما تعتمده من تجارب يدركها العقل الإنساني أيا كانت لغة صاحبه.
والصحيح أن هناك لغات أكثر تداولا في المجال العلمي وفي العلاقات الدولية وفي المجال الاقتصادي العالمي، وكثرة التداول شيء مختلف عن تدريس العلوم القديمة والحديثة التي ينبغ فيها الباحثون من شتى أنحاء العالم. وبين أيدينا جائزة نوبل وجوائز علمية أخرى تبرز بوضوح أن التفكير العلمي له شروطه وسننه التي لا تحابي شعبا على حساب آخر أو لغة على حساب أخرى.
ورغم الملاحظات التي يمكن إبداؤها حول صياغة الدستور الحالي، إلا أنه في قضية اللغات الأجنبية جاء الأمر دقيقا عندما تم التنصيص في الفصل الخامس على أن الدولة تسهر “على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.”
فالحديث هنا دقيق عن “اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم” وهي موجودة بكل تأكيد، لكن ليست هناك لغات علمية بذاتها. وأيضا باعتبار اللغات الأجنبية “وسائل للتواصل” وليس للتدريس بالضرورة. إضافة إلى اعتبارها “وسائل للانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة” الذي لا يقتصر فقط على المواد العلمية والتقنية، بل يشمل الفكر والفلسفة والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ثم باعتبارها أدوات “الانفتاح على مختلف الثقافات” على تنوع هذه الثقافات سواء كانت مرتبطة باللغات الأكثر تداولا أم لا، وسواء كانت شعوبها ومجتمعاتها متقدمة أو دون ذلك، فالثقافة في تعاريفها أوسع من المعارف والعلوم، ومن بين ذلك التعبير الشهير بأنها “ما يبقى بعد أن ننسى كل ما تعلمناه في المدرسة”. وأخيرا “الانفتاح على حضارة العصر” الذي نعيش فيه استيعابا لمنجزاتها، وسعيا للإسهام في ما تقدمه من خير للبشرية.
ومن بين الشبهات المتعلقة بهذه المغالطة أن اللغة العربية تحتاج إلى تأهيل وتطوير وما يتطلبه ذلك من تحديث لمناهج تدريسها وإيجاد المصطلحات المناسبة في ظل المستجدات العلمية المتسارعة والحاجة لحركة ترجمة مواكبة لذلك سواء للمقررات الدراسية أو للدراسات والبحوث. ونظرا لغياب من يقوم بذلك اليوم ينصح البعض بأن ندرس بلغات أجنبية إلى حين تأهيل اللغة العربية لذلك والتي يُحمّل البعض مسؤوليتها إلى أهلها والداعين لاعتمادها، عوض ما هو وارد في الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”. وكيف يمكن للغة أن تتأهل وتتطور دون استعمالها وإيجاد الهيئات والمؤسسات المتخصصة للسهر على ذلك، وكيف سينجح الأمر إذا كانت غائبة أو حضورها ضعيفا في الإدارة وفي عدد من مجالات الحياة العامة؟
وإذا كان هذا ما يقال عن اللغة العربية، فماذا سيقال لنا عن اللغة الأمازيغية التي تعد لغة رسمية للدولة أيضا؟ هل يعني إدماجها في التعليم فقط تدريسها كلغة، وأنه محكوم عليها مسبقا بألا تدَرَّسَ بها المواد العلمية والتقنية؟
ثالثا: تدريس المواد العلمية باللغة العربية سبب تراجع وفشل المنظومة التعليمية ببلادنا:
وهذه مغالطة مكشوفة، حيث تدل مختلف التقارير التي أعدتها عدد من المؤسسات الدولية وأيضا المؤسسات الدستورية الوطنية ذات الصلة بالموضوع على أن تراجع وفشل المنظومة التعليمية ببلادنا يرجع لأسباب متعددة لا يدخل ضمنها تدريس المواد العلمية باللغة العربية.
وإذا ما ذكرت لغة التدريس فلا ينسب السبب للغة العربية وإنما للتردد في الحسم في لغة التدريس والارتباك والارتجال الذي يطبع السياسة اللغوية المعتمدة والتي يتوقف نجاحها، حسب الخبراء والتجارب الدولية، على الإرادة المستقلة الموحدة والوضوح والانسجام في كافة مراحل التعليم وأسلاكه من الابتدائي إلى العالي، وفي كافة أنواعه من عمومي وخصوصي وغيرهما.
فكيف نتهرب من مواجهة الأسباب الحقيقية لتراجع المنظومة وفشلها والمتمثلة أساسا في سوء الحكامة وفي غياب الإنصاف وضعف الجودة، وفي مشاكل البحث العلمي، وفي التخبط الحاصل في توظيف الموارد البشرية وتأهيلها وتحفيزها، وفي المناهج والبرامج والمعينات البيداغوجية. كيف نتهرب من كل هذا وغيره من الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الأولى والحالية، وكشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات وغيره من المؤسسات الوطنية والدولية، ونلقي باللوم على اللغة البريئة من هذا الفشل أو التراجع براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام؟ ! ولو سلمنا جدلا بعلاقة اللغة العربية بتراجع مستوى المتعلمين في المواد العلمية فبم نفسر التراجع نفسه في المواد الأخرى بما فيها اللغات في حد ذاتها؟.
وعلى سبيل المثال، فقد خلص التقرير الموضوعاتي حول “الدراسة الدولية للاتجاهات في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2015)، نتائج التلامذة المغاربة في الرياضيات والعلوم ضمن سياق دولي”، إلى أن “نتائج التلامذة المغاربة دون المعدل الدولي، وترتيبهم في أدنى درجات السلم”، وأرجع تلك النتائج إلى العوامل الآتية:
“- فوارق ملحوظة تمس التلامذة المتأخرين في دراستهم، والتلامذة الذين يتوفرون على السن المنصوص عليه أو السن الأقل منه.
– تلميذ من بين ثلاثة تلامذة في المستوى الرابع لم يسبق له أبدا أن تردد على التعليم الأولي، ومعدل تحصيل هؤلاء التلامذة ضعيف.
– أغلبية التلامذة لهم مواقف إيجابية إزاء الرياضيات والعلوم، لكن نسبة الذين عبروا عن عدم ثقتهم في قدرتهم على تعلم تلك المواد نسبة لا يستهان بها.
– معدل تحصيل تلامذة التعليم الخصوصي أعلى بكثير من معدلات نظرائهم في التعليم العمومي.
– نسبة كبيرة من التلامذة الذين ينحدرون من وسط سوسيو-ديمغرافي ضعيف يعانون من تأخر في مجال التعلم.
– يبدو أن تركيبة المؤسسة التعليمية، ومناخها، وظروف العمل فيها وكذلك المشاكل التي يواجهها المدرسون ليست مواتية للتعلمات.
– نقص في التكوين الأساس: يعرف التكوين الأساس والمستمر للفاعل التربوي الأساسي أي المدرس، نقصا كبيرا في المغرب، بالإضافة إلى تكوين مستمر محدود.”
كما أن التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتاريخ 02/12/2014 عن تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013: المكتسبات والمعيقات والتحديات (الصفحة 21 من ملخص هذا التقرير التحليلي ) يؤكد ضعف المكتسبات اللغوية وانعكاسه على التعلم في مختلف مراحل الدراسة، وهو ما يبدو كذلك على الطلبة الذين يدرسون التخصصات العلمية باللغة الفرنسية حيث يواجهون صعوبات ناتجة عن التباعد بين اللغة التي درسوا بها في الابتدائي والثانوي واللغة التي تفرض عليهم في التعليم العالي:
“يبرز تقييم المكتسبات النقص اللغوي للتلاميذ، الذي يعتبر أحد العوامل المعيقة لعمليات التعلم. وكما بين التقييم المستند إلى مختلف معطيات الدراسات المشار إليها في هذا التقرير، فإن مكتسبات التلاميذ ضعيفة في القراءة والكتابة إجمالا، والحال أنهما تشكلان الأساس الذي تنبني عليه التربية ومنظومتها. فقد أصبح التباعد بين لغة التدريس بالثانوي واللغة المستعملة بالعالي إشكاليا…
وفي جميع الأحوال، تظل الاختيارات اللغوية غير محددة بدقة، كما أن التخطيط اللغوي الذي يمنح لكل لغة (للعربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للبلاد وكذلك للغات الأجنبية) موقعا داخل نظام التربية والتكوين، باعتبارها لغة تدريس ولغة مدرسة، لم يوضح بما فيه الكفاية. لذلك، فإن عدم الانسجام اللغوي المميز لنظام التربية والتكوين، يقتضي إعادة التفكير في السياسة اللغوية ببلادنا، في أفق تحقيق توازن دائم بين مبدإ العدالة اللغوية ومطلب التحكم في اللغات الأجنبية.”
رابعا: تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المواطنين:
على اعتبار أن ذوي الإمكانيات المادية يدرسون أبناءهم في التعليم الخصوصي أو تعليم البعثات، فينشؤون متمكنين من اللغات الأجنبية، وهو ما يخل بالإنصاف وبتكافؤ الفرص بينهم وبين مماثليهم من المتمدرسين في المدرسة العمومية الذين يجدون صعوبة في دراسة العلوم في التعليم العالي وأيضا في الاستفادة من فرص الشغل التي يتطلب الحصول عليها إتقانا لهذه اللغات. ولتحقيق الإنصاف يقترحون علينا أن نعمم اللغة الأجنبية على الجميع لنتيح للفقراء وذوي الدخل المحدود الفرص كغيرهم.
وهي مغالطة أخرى، لأن التمكن من اللغات لا يمر بالضرورة عبر جعلها لغاتِ تدريس وإنما بإيلائها العناية اللازمة كلغات مُدَرَّسة، إضافة إلى كون هذه المغالطة تصرفنا عن الأسباب الحقيقية لعدم الإنصاف وتكافؤ الفرص، والمتمثلة في التوزيع غير العادل للثروة، وفي ضعف العدالة المجالية والترابية وفي الاختلالات التي تعرفها المنظومة على مستوى الموارد البشرية وفي عدم انسجام السياسة اللغوية وفي عدم القدرة على إلزام مختلف المؤسسات التعليمية بالتقيد بالاختيارات الوطنية المعتمدة.
وعدد من أصحاب هذه الأغلوطة يعرفون أنه حتى في حال تعميم التدريس باللغات الأجنبية، فإن الإنصاف وتكافؤ الفرص لن يتحققا، لأن من يشار إليهم بالحصول بيسر على فرص الشغل وتولي المناصب والمسؤوليات هم في واقعنا من ذوي الإمكانات والعلاقات والنفوذ الأمر الذي يمكنهم أولا من اختيار أجود المؤسسات في الداخل والخارج وهذا الاختيار لا تطيقه أغلب الأسر المغربية، وثانيا لكون الفرص أمام هؤلاء مفتوحة رغم عدم كفاءة البعض منهم، إما لأنهم يشتغلون في مشاريع عائلاتهم، أو لأن علاقات أوساطهم الأسرية تَفتح لهم بابَ الولوج لعدد من المناصب والمسؤوليات في القطاعين الخاص والعام.
ولا نبالغ إذا قلنا بأن فرض لغة أجنبية معينة – تكاد تكون اليوم هي اللغة الأم لطبقة اجتماعية ارتبطت ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا بهذه اللغة – سيعمق الفروق أكثر بين أبناء الوطن، ويضرب تكافؤ الفرص بين أبناء هاته الطبقة وأبناء الطبقات الشعبية الذين سيكابدون التعلم بلغة أجنبية، وينتظر منهم أن يحققوا من المكتسبات المعرفية أكثر مما حققوا بلغة عربية تعد مقوما من مقومات هويتهم. وسيكون كل ما حققناه عند التخلي عن تدريس العلوم في الثانوي باللغة العربية هو نقل الصعوبات التي يجابهها اليوم طلبة العلوم إلى تلاميذ التعليم الثانوي.
وبالمناسبة، فإن نظرة على نتائج البكالوريا في الشعب العلمية في السنوات الأخيرة تبرز بوضوح أن تلاميذ المدرسة العمومية يسجلون معدلات متقدمة تضعهم في المراتب الأولى، ولم تقف اللغة حاجزا بينهم وبينها رغم أوضاع بعضهم الاجتماعية الصعبة، وأنهم يتمكنون من ولوج مؤسسات جامعية مهمة.
خامسا: المدافعون عن التدريس باللغات الرسمية “منافقون” يدعون الناس إلى ما لا يختارونه لأنفسهم:
يَتَّهم البعضُ المنافحين عن التدريس باللغة العربية بأنهم يُدرسون أبناءهم في مدارس البعثات الأجنبية ويريدون لأبناء الشعب عدم اللحاق بهم ليظلوا وحدهم المتفوقين الذين تفتح أمامهم آفاق التشغيل وتولي المسؤوليات.
وهذه مغالطة أخرى تتمثل في التعميم والتعتيم. فهي تعمم الحكم على كافة المدافعين، وتعتم الحقائق المتعلقة بنسبة من يقصدون هذه البعثات – وهم نسبة ضعيفة – ناهيك عن التعتيم على الأسباب التي تدفعهم لذلك.
فغير خاف أن الكثير ممن يلجؤون للقطاع الخاص، أو للبعثات، أو للدراسة بالخارج لا يقومون بذلك لعدم اقتناعهم بالمبادئ الوطنية، ولا لقلة إيمانهم بثوابت البلاد، بل لبحثهم عن ظروف تعلم أفضل، الجميعُ اليومَ يرى أنها لا تتوفر في المؤسسات العمومية. هذا إضافة إلى أسباب أخرى، بالنسبة لمن يلجأ للقطاع الخاص، تتمثل في عدم اعتماد التوقيت المستمر بالتعليم العمومي ليوافق توقيت العمل بالنسبة للآباء ورغبتهم في ضمان حضور محروس لأبنائهم بالمدرسة طيلة اليوم تجنبا للأخطار، وعناية العديد من المؤسسات الخاصة بتقوية تمكين المتمدرسين من اللغات الأجنبية إلى جانب تدريس المواد العلمية باللغة العربية.
إن الهدف من هذه المغالطة هو السعي لنزع المصداقية عن جميع المدافعين حتى ولو كانوا محقين في دفاعهم ودفوعاتهم، فكون أبنائهم يدرسون اختيارا أو اضطرارا في المدارس والمؤسسات التي تعتمد اللغات الأجنبية ينزع عنهم حق الدفاع عن اللغات الوطنية في نظر مروجي هاته المغالطة. وإذا سايرنا هذا المنطق فمن يذهب للاستشفاء في المصحات الخاصة أو في الخارج، لأنه لا يجد الخدمة المناسبة والتجهيزات الكافية في المستشفيات العمومية، لا يحق له الحديث عن الصحة العمومية، ومن يتنقل بسيارته الخاصة لا يحق له الحديث عن النقل العمومي، ومن لا يصلي في المساجد لا يحق له الحديث عنها، وهو منطق غير سليم.
سادسا: لغة التدريس مسألة ثانوية، والذين يركزون عليها يهملون المشاكل الحقيقية والأسباب الرئيسية:
يروج البعض أن الهدف هو التمكن من العلوم وأن اللغة لا تعدو أن تكون وسيلة، وهي بذلك مسألة ثانوية ينبغي ألا تأخذ كل هذا النقاش. وإذا سلمنا جدلا بهذا الطرح، فلماذا كل هذا الدفاع المستميت عن لغة أجنبية محددة؟ ولِمَ الانتقال من اللغة العربية لغيرها؟ وتبعا لذلك، لماذا لا يتم وضع الأصبع على المشاكل الحقيقية لتنبيه الناس إليها، ولِم لا يشار بوضوح للأسباب الرئيسية لتتم معالجتها أولا؟
وأمام ضعف الحجج لاعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، هذه اللغة التي لا نكن لها ولا لأهلها بالمناسبة أي عداء، فهم يدافعون عن لغتهم وحضارتهم ولهم كامل الحق في السعي لنشرها. أمام ضعف هذه الحجج، يقفز البعض بنا إلى الأمام بالدعوة لاعتماد اللغة الإنجليزية وهم مدركون لصعوبة الأمر حالا لعدم توفر الظروف والاستعدادات البشرية والبيداغوجية. فيبررون دعوتهم لاعتماد الفرنسية بكونها حلا مؤقتا إلى حين تأهيل الموارد البشرية محاولين إقناعنا بهذا الحل الجديد.
فاللغة الإنجليزية تنتشر بقوتها التداولية الذاتية، وليس وراءها جهات تسعى لفرضها في بلادنا على الأقل. وسيكون على الدولة إن أرادت اعتمادها بذل مجهودات واستثمارات كبيرة على رأسها تكوين الموارد البشرية المؤهلة التي تعد نقطة ضعف التجربة الهشة المحتشمة لما سمي بالباكالوريا الدولية-خيار إنجليزية، هذه التجربة التي ولدت وتركت للموت الرحيم بلا عناية، لتبقى صفة “الدولية ” تعني عمليا لغة واحدة هي الفرنسية. ولم يعد خافيا أن الكلام عن الإنجليزية لغةً للتعليم بالمغرب سيبقى حبرا على ورق، إن لم نقل حقا يراد به باطل. وربما تعود إليه الجهات الوصية بعد تمام سنوات الرؤية الاستراتيجية لتستنجد به وهي تشخص فشل المنظومة وتستعرض أعطابها من جديد لا قدر الله، وتذكر بتوصيات اعتماد اللغة الإنجليزية بعبارة “غير أن هذه التوصيات لم تطبق لحد الآن.” (العبارة أوردها التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين في حديثه عن عدم تطبيق توصيات الميثاق).
وإن سلمنا جدلا بدعوى انتظار تأهيل الموارد وتوفير ظروف التدريس بالإنجليزية، فلماذا لا نُبْقي على التدريس بلغتنا العربية، بدل الالحاح على الانتقال المؤقت للفرنسية؟
سابعا: المدافعون عن التدريس باللغات الرسمية الوطنية أهدافهم سياسية وإيديولوجية:
وهي مغالطة تلقي في روع المتلقي ووعيه أن هذه القضية مسألة تقنية محضة كما لو أنه يستعمل وسيلة نقل أو حاسوبا أو أية آلة لتيسير ظروف عيشه وأسلوب حياته، وأنه لا علاقة لها بالسياسة أو بالهوية أو بالثقافة التي تميزه وتصقل شخصيته ونفسيته ليكون له اعتبار ومكانة في عالم متغير ومتقلب، تحيا فيه الشعوب والمجتمعات المتمسكة بأصالتها وثوابتها وقيمها السليمة، وتندثر فيه الشعوب المُترجَمة والمستنسَخة، وفي أحسن الأحوال تصبح نسخا رديئة لشعوب أخرى، عاجزة عن اللحاق بها والاندماج فيها، غير قادرة على الرجوع لأصالتها التي محيت معالمها وأصبحت غريبة على أجيالها المتعاقبة.
وما العيب في أن تكون الدوافع سياسية، لكنها مسؤولة تروم تصحيح مسار السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم لتستقيم على أسس سليمة، وليس مجرد مزايدات فارغة؟.
وأين سنضع الدفاع عن مقومات الهوية الوطنية والتنزيل الأمثل لأحكام الدستور والحقائق التاريخية والعلمية التي يقدمها الخبراء والمختصون والمهتمون بالسياسات التعليمية. أليس في مجال السياسة التي يضع أصحابها الاستراتيجيات ويعدون القوانين التي سيلزم بها عموم المواطنين ويمتد أثرها إلى حياتهم ومستقبل أبنائهم؟
لقد مضى على المغاربة حين من الدهر كانت الاتهامات الجاهزة هي الدوافع السياسية. أما اليوم فالوعي الجمعي للمغاربة يسير نحو فهم علاقة السياسة بمختلف مصالحهم وانشغالاتهم. وأن الكثير من النقاش العمومي تحسمه القرارات السياسية. فمشروع القانون الإطار 51.17، الذي كان سببا مباشرا في كل هذا النقاش – الذي يريده البعض تجييشا ضد الاختيارات الوطنية، وتبخيسا لها ونيلا ممن تسول له نفسه الدفاع عنها، أو إبداء رأيه فيها – هذا المشروع يناقَش في مؤسسة سياسية هي البرلمان، ومن حق المواطنين أن يبدوا وجهات نظرهم بشأنه، وأن يمارسوا حقهم الاقتراحي على منتخبيهم حتى ينتصروا لهوية الأمة ومصالح الأجيال ولا يرهنوا مستقبل الوطن بخيارات خاسرة، وإن بدت مصالح ظاهرة آنية لفئة من الناس.
وختاما، فإن الغرض من كشف هذه المغالطات أن تنبني اختياراتنا على الوضوح والمصداقية، وأن يسعى مختلف المعنيين بهذا الموضوع إلى طرح الأسباب الحقيقية لاعتماد هذا الخيار أو ذاك دون الإسهام في تغليط الرأي العام، بقصد أو بغير قصد، بإيراد عدد من الآراء المرجوحة والاعتبارات غير الموضوعية ولا العلمية.
فالتربية والتعليم من القضايا الاستراتيجية التي تهم المغاربة جميعا، فهي مستقبل الأجيال وأحد ركائز النموذج التنموي لكل بلد عازم على السير في طريق التنمية والتفاعل الحضاري، منفتح على العالم، مستفيد من الكسب الإنساني في مجال العلم والمعرفة بأوسع معانيهما، غير مفرط في ثوابته الوطنية ولا عابث باختياراته الدستورية.
ذ. عبد الرحيم شيخي