باك كورنا 2020 – الحبيب عكي
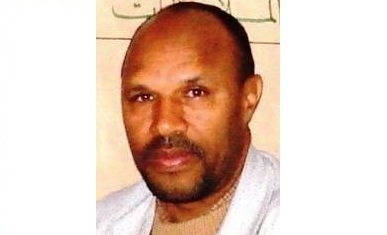
بكالوريا بدون اجتماعات إعدادية ماراطونية بين الطاقم الإداري والطاقم التربوي، وكأنهم يعدون لخوض معركة المعارك، التي قد يتخلى عنها يوما وتصبح مجرد ذكرى، كغيره من الدول التي تخلت عن كل ما هو إشهادي، ولا تجمعات قبلية أو بعدية للأساتذة في قاعة الشاي المنعنع بالتنكيت السياسي والدخان النقابي الفارغ، ولا تجمعات كذلك للتلاميذ بين حصص الإجراء في الساحة يحبطهم فيها فقط فضول سؤال الزملاء كيف أجبتم وكيف حُرِستم، لا اكتظاظ في الأقسام بحكم مسافة الأمان المتخذة بين التلاميذ وفق البروتوكول الصحي للامتحان، فعدد المترشحين في القسم لا يتعدى 10 تلاميذ، وبأستاذين للحراسة كالعادة، مما جعلهم يتغلبون على الحراسة كما ينبغي وعلى تكاليف الإجراء التي مرت بسلام.
لا كثافة في المواد التي يمتحن فيها التلاميذ، بحكم الامتحان الذي جرى فقط في نصف المقرر الدراسي للأسدس الأول الذي كانت فيه الدروس حضورية للجميع، بينما استغني عن دروس التعليم عن بعد التي كانت في الأسدس الثاني رغم كل الجهد الذي بذل فيها، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص وإنصافا للتلاميذ الذين لم يكونوا يملكون عدة الولوج إلى دروس الاستمرارية التربوية مع الأساتذة عن بعد. لا بيروقراطية في تسلم أو تسليم الوثائق وأوراق الامتحان، بحيث كان يأتيك كل شيء إلى القسم في الوقت المحدد للبداية على الدقيقة والثانية، ويسلم منك ذلك أيضا بعد الإجراء على الدقيقة والثانية، بل حتى دعوات الحراسة ولأول مرة في التاريخ بلا شك حددت في الدعوة لكل أستاذ حصص حراسته وفتراتها الصباحية والمسائية وأرقام قاعاتها، فيأتي الأستاذ مباشرة ويلتحق بقاعته دون اضطرار إلى أي انتظار ولا ما قد يكون من فلسفة وعنترية إدارية فارغة.
لا غش ولا احتيال، اللهم ما قد يكون خارجا عن المراقبة والإدراك البشري، ليس لأن المترشحين قد وقعوا على ما سلمتهم الإدارة قبليا من قوانين زجر الغش وعقوباتها، وتعهدوا بتجنب ذلك وصادقوا عليه قي البلديات والقرويات بشكل رسمي، فلا كتب مقررات ولا جذاذات منسوخات ولا أحاديث ثنائية في تحدي سافر للحراسة، ولا هواتف ذكية مشغلة ولا حتى مصحوبة للامتحان، ويحكى أن بعض التلاميذ قد صدموا وصعقوا لما لجن الفحص والمراقبة حصلت عليهم هواتف في محافظهم فطردتهم مباشرة من الامتحان وكتبت ضدهم تقارير غش وسحبت منهم هواتفهم التي لن يسترجعوها إلا بعد إجراءات وإجراءات، لأنهم ما كان عليهم أن يحضروها إلى قاعة الامتحان مجرد الإحضار كما ينص على ذلك القانون الذي احترم بالفعل.
تعبئة بشرية موسعة وغير مسبوقة، وتنظيم محكم كخلية نحل كل عضو فيها بمهمة تتكامل مع مهام الآخرين،بدء من إجراءات البروتوكول الصحي ضد “كورونا” حيث تعيين درجة الحرارة من الباب، وتعقيم الأيادي، وتوزيع الكمامات، وتجنب التجمع والتقارب الجسدي، وتشوير الممرات نحو الأقسام وترقيم الطاولات بأرقام المترشحين، وملفات خاصة بلوائحهم ومطبوع الإجراء والحضور والغياب، وقد تم اللجوء إلى استثمار العديد من المؤسسات التعليمية والمدرجات الجامعية والقاعات الرياضية لتستوعب الجميع، وإمداد أساتذة مؤسسات مراكز الامتحان بغيرهم من أساتذة المؤسسات المجاورة في الغالب، ناهيك عن الشرطة والدرك والماء الشروب والوجبات في الداخلية والنقل المدرسي والإسعاف.. وغير ذلك من من المصالح والجهود المتضافرة.
وبالمخنصر المفيد، يمكن القول وبلا مبالغة أن باك “كورونا”.. كان أحسن باك في تاريخ هذا الإشهاد الوطني، وأن الجهات الوصية قد بذلت مجهودات جبارة وغير مسبوقة ونجحت فعلا في تنزيلها، لولا غول الغش والاحتيال الذي لا زال متجذرا في الكثيرين ويكلف البلاد أكثر مما يتصور العباد، ولولا الاحتياط الشديد من مختلف مظاهره ما كان للعديد من الإجراءات المكلفة مبرر وجود على الإطلاق، على أي، نتمنى أن تؤتي كل هذه المجهودات الجبارة أكلها على مستوى نسبة النجاح إن شاء الله، وإن كانت هذه المسألة مرتبطة بعوامل أخرى في المنظومة، لكن لن يبقى إصلاحها بعيدا ولا مستحيلا إذا قويت الإرادة وخلصت النوايا وتمسكت المنظومة بالسير على هذا الانجاز الناجح ولم تعد حليمة إلى عادتها القديمة بعد جائحة “كورونا”، التي يبدو أن كثيرا من الأمور الجيدة والتي طفت على سطح حياتنا بقدرة قادر، إنما كانت على عيونها “القتالة” .
ويبقى السؤال، لماذا كان مثل هذا الانجاز المبهر قبل الجائحة من سابع المستحيلات؟ لماذا لم تستطع تحقيقه كل مبادرات ومشاريع الإصلاح السابقة،رغم تأكيد المؤكدين و مرافعة المرافعين؟ لماذا كان المسؤولون يرون مجرد التفكير في مثل كذا إصلاح تفكيرا انتحاريا لا يمكن تنفيذه لا داخل ولا خارج الصندوق، وها هو الآن قد أنجز أمام أعين الجميع، مما يعني أن التغيير ممكن وأن الإصلاح في المتناول، ولكن واهم من يتصور كذا إصلاح أو أي إصلاح مهما كان دون متطلبات ومستلزمات، ككل هذا الذي تحدثنا عنه في هذه الملحمة الإشهادية والاستحقاق الوطني، وعلى رأس ذلك كما قلنا ضرورة الحرص على السمعة.. والمصداقية.. والمعنى والمستوى.. والمشروع الحقيقي.. والإطار المرجعي.. والتعبئة.. والتنظيم..وتضافر الجهود..والمسؤولية..والحكامة..والمحاسبة..والإنفاق..
ويبقى السؤال أيضا، ماذا استفدنا من هذه التجربة وكيف يمكن استدامة نجاحها أيضا، وبشكل جوهري لا مظهري فقط؟ ولعل سؤال الأسئلة في هذا الإطار هو: متى ستعود للباكالويا قيمتها العلمية الحقيقية تحصيلا ومهارات ونضج شخصيات وفرص وإمكانيات، قيمتها التي تجعل منها باب الخلاص للحاصلين عليها، وتمكنهم من ولوج أبواب العمل..وأبواب..الاستقرار..وأبواب المردودية والإبداع..وأبواب ..وأبواب..؟ وليس كما هي الآن – مع الأسف – مجرد مفتاح للبحث الماراطوني عن الذي قد يأتي..وفي الغالب لا يأتي..ولو بعشرات الباكالويات وعشرات غيرها من الديبلومات والدكتورات من كل المعاهد والكليات.
وأخيرا، متى تستدرك القوانين التنظيمية لهذه الاستحقاقات الوطنية ضرورة حماية قطب رحاها الذي هو الأستاذ مما يهدده من مخاطر مزاولة الحراسة داخل القسم وخارجه، وكذلك تعويضه على غرار كل المتحركين في مهام الامتحانات، وليس من الإنصاف في شيء – كما يقال – أن نجعل الأستاذ في المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر بالاقتطاع والتضامن، وتنزيل السياسات التقشفية في حقه وحده لجعله في آخر مرتبة عندما يتعلق الأمر بتعويضاته المستحقة والمشروعة.


