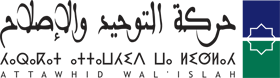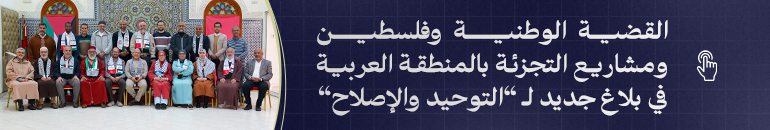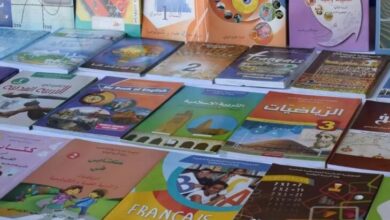بين القانون الداخلي والحالة التربوية للتلميذ – الحبيب عكي

كثيرة هي الأسس النظرية التي تحاول التأسيس لواقع مدرسة مغربية ذات قيمة إنتاجية وجودة تربوية وتراكم معرفي وقيمي مضطرد وبناء، بما يستجيب للأسئلة التربوية والاجتماعية التي يحفل بها علم النفس التربوي وسوسيولوجيا التربية/المدرسة من قبيل: هل المدرسة المغربية مدمجة أم طاردة؟ هل فيها عدالة اجتماعية أم تمايز فئوي ومجالي؟ كيف تخلق ما نرفعه من شعار المساواة الاجتماعية والجودة وتكافؤ الفرص في مجتمع يفتقدهما أصلا؟، لماذا المدرسة تعيد إنتاج كل الظواهر المشينة واللاتربوية التي تعرفها؟ هل المداخل الإصلاحية لهذه المعضلات تكمن في السياسات والميزانيات والدعائم اللوجستيكية، أم في المعيقات الذاتية والمجريات الفصلية والانحرافات غير المنتظرة في الطريق كما تذهب إلى ذلك المدرسة الفينومنلوجية؟
على أهمية السياسات وما توفره من ترشيد الاختيارات وأهمية الميزانيات وما توفره من الإمكانيات، فإن مثلثات الأعطاب ومربعات المطبات وصواريخ الفشل قد تكمن في انحرافات أخرى غير متوقعة ولكنها موجودة كما يذهب إلى ذلك السوسيولوجي “روبرت مرتون” صاحب العوامل المنحرف (effets pervers)، وهي عوامل تسبب في فشل كل “قانون إطار” وزيغ كل “خارطة طريق” وعجز “تدابير أولية” أو إجراءات ثانوية، ويضرب لذلك مثالين أساسيين هما:
1) المعيقات الذاتية: إذ رغم أن المدرسة معممة وتمنح نفس الفرص للجميع وتفتح نفس الشعب أمام الجميع وهي بذلك عادلة وبريئة، لكن التلاميذ وأسرهم لهم اختياراتهم العقلانية وحساباتهم الاجتماعية وهي من ترسم اجتهاداتهم الذاتية واختياراتهم المتاحة وما يقدمون عليه من اجتهاد أو تكاسل، وكلما اختلفت الاجتهادات، طبعا، اختلفت النتائج والفرص والمسارات..، وبهذه الاجتهادات الذاتية يمكن أن نفسر مثلا وجود تلاميذ من أسر فقيرة استطاعوا أن يلجوا المدارس العليا ويتخرجوا منها أطباء ومهندسين وتغير بذلك واقعهم ومواقعهم.
وأيضا هناك: 2) المعيقات الفصلية: أي ما يقع داخل الفصل، أي ظروف التمدرس وفضاءاته وأجواؤه من مثل: ماذا ينتظر الأستاذ/المؤسسة/الأسرة/المجتمع من التلميذ؟ كيف يتمثل هذا التلميذ مادة دراسية أو أستاذها؟، في أي جو حقوقي وقانوني أي تربوي محترم تنسج علاقات الأستاذ بالتلميذ.. بالزملاء.. بالإدارة.. بالأسرة.. بالمحيط.. بالمؤسسة.. بالتكوين..؟ كل هذا يؤثر ولا شك على التحصيل الدراسي وقبلها وبعدها على النجاح بشكل عام. فأستاذ يحكم على تلميذ فقير أنه لا يستطيع أو على تلميذ أنه مشاغب غير منضبط، سيبقى في نظره كذلك ولن يكافئه بالرضا على أي شيء مهما فعل؟، وتلميذ يحكم على مادة أنها صعبة أو على أستاذها أنه في نظره معقد.. غير كفؤ.. غير عادل..، فلن تنسج بينهما علاقة الود ولا حبال التواصل الإنساني فبالأحرى مسالك التواصل التربوي وهو ضروري في كل عمليات التعليم والتعلم؟
هذا الذي يقع داخل الفصل/المؤسسة/المحيط..، والذي كثيرا ما تتحاشاه برامج الإصلاح، التي كثيرا ما حلا لها التجول خارج الفصل في بناء الأسوار وصباغة الأقسام ورسم الجداريات وتقسيم الملاعب وبستنة الحدائق..، على أهمية كل ذلك، لكنها لماذا لا تجرأ على الدخول إلى الأقسام مطبخ العمليات الحقيقية وفرنها الحارق، وما قد يقع داخلها من حروب طاحنة لا تبقي أي شيء لأي شيء في أي شيء؟
لهذا جاء القانون الداخلي للمؤسسة يعترف بشيء اسمه داحل القسم، يدخل إليه، يرصد المجريات، يعترف بالتجاوزات ويحاول معالجة المشين من ظواهر لا تربوية تعود بالسلب على العملية التعليمية/التعلمية وما يرجى منها من نجاح علمي ومعرفي، قيمي وأخلاقي، ولكن، وسط أجواء فصلية تعمل على هدمها وعرقلتها ومن ذلك: اكتظاظ.. شغب.. عنف لفظي وجسدي متبادل.. معرض الأزياء.. تحرش.. تنمر.. سباب.. عراك.. غش متنوع.. تدخين خفي وظاهر.. ترويج مخدرات..، غياب.. تأخر.. إهمال الواجب.. عدم كتابة الدرس.. عدم المراجعة.. ضعف المشاركة..؟
لهذا جاء القانون الداخلي للمؤسسة وانضاف إليه العقد الديداكتيكي للقسم (chartes de la classe) بين الأستاذ والتلاميذ، وهما إن لم يطلهما النسيان بالدوام، مرجعان أساسيان للعلاقة بين التلميذ والمؤسسة وبين التلميذ والأستاذ وبين التلميذ والتلميذ..، وهما في البداية والنهاية المرجع الأساسي والملجأ الأخير والحاسم عند وقوع أية مشكلة بين كل الأطراف.
اطلعت على بعض القوانين الداخلية للمؤسسة، ربما عممها أصحابها للتعميم والتحسيس وكل غاية مفيدة، فوجدت فيها جملة من الممنوعات والواجبات لم تكد تبقي فيها للحقوق والمباحات أي شيء:
1- ممنوع القبعات
2- ممنوع السراويل الممزقة
3- ممنوع السراويل القصيرة
4- ممنوع الهاتف النقال
5- ممنوع الحلاقة القزعية
6- ممنوع الماكياج والوشم
7- ممنوع الأدوات الحادة
8- ممنوع الأشياء النفيسة
9- ممنوع القلائد والأقراط والأساور للذكور
10- ممنوع الأكل في الأقسام ورمي الأزبال
11- ممنوع الكتابة على الجدران
12- ممنوع المطـاردة في الساحة
13- ممنوع دخول الدراجات
وطبعا، لا يمكن للمرء إلا أن يكون مصدوما اتجاه هذه القائمة من الممنوعات التي لا تكاد تبقي للمباحات شيئا، وبالتالي نتساءل: هل فعلا أصبح التلميذ على هذه الشاكلة؟ أو على الأصح كيف أصبح هكذا؟ وهي حالات موجودة على كل حال وإن كانت غير عامة والحمد لله.
السؤال الحارق أيضا، هل يمكن تدريس تلميذ/ة على هذه الشاكلة؟ وهل المدرسة مسؤولة عن الحالة السلوكية للتلميذ/ة؟ كيف يمكن تقويم سلوك التلميذ/ة والأسرة/الإعلام/المجتمع غير مقوم؟ إن القانون الداخلي في الحقيقة يطرح سؤالا جوهريا أعمق وهو سؤال الانضباط (la discipline) في المنظومة التربوية، أي سؤال التربية بين الحقوق والواجبات أو بين الحرية الفردية والانضباط الجماعي خاصة إذا شابه شيء من التسلط التربوي وعدم مواكبة التغيرات المفاهيمية والقيمية بين الأجيال.
سؤال قديم جديد ويتجدد خاصة في هذا العصر الذي تسود فيه الحرية بكل المفاهيم وتحميها القوانين الدولية، إن الانضباط كان على الدوام حجر الزاوية وركن الأركان في العملية التعليمية التعلمية، بما يحققه من بيئة تعليمية آمنة، تساعد الأستاذ على ضبط القسم دون توتر ولا عنف، والتلميذ على التركيز في التعلمات دون خوف أو انحراف، تنمي القيم والمسؤولية بما سيشيعهما أيضا في الأسرة والمجتمع، محاربة العلاقات المتوترة والمعاملات السلبية والمسمومة مثل التنمر والتسلط والعنف المتبادل..
لذا يبقى السؤال أيضا: إذا كان الانضباط (la discipline) في المدرسة وفي الحياة العامة مهما بهذه الدرجة وأساسيا في كل تربية وتكوين وتأهيل وتوظيف.. ومسؤولية، فلماذا لا زال ضعيفا عندنا ولماذا نتعامل معه وكأنه مجرد حبر على ورق وورقة للتعليق على الجدران على أعين الناس كما يقال؟ لماذا نجد بعض المدارس وكأنها لا تنتج غير التسيب والفوضى أكثر من العلم والمعرفة والانضباط السلوكي والأخلاقي؟ خاصة في بعض مدارس الأحواض الشعبية الفقيرة التي لا وجه للمقارنة بين رهطها ورهط مدارس الأحياء الغنية أو حتى أشتات بعض المجموعات القروية النائية، وإن كان لكل منها اضطرابه وانفلاته؟
لا بديل عن الانضباط والاحترام المتبادل غير التسيب والفوضى والانحراف وسوء المعاملة..، لا بديل غير ما نحن بعيدون عنه من البيداغوجيات التربوية القائمة على التعلم الفردي/الذاتي (كتأهيل المرشح لرخصة السياقة) والتعلم التعاوني (انضباط جماعي وتلقائي يستجيب لشرط المنافسة بين الجماعات) أو حتى التعلم الديمقراطي (يساهم فيه التلاميذ في صنع القرار واتخاذ الأحكام).
ولذا، هل لنا في تفعيل هذه الدعامة التربوية التي تسمى الانضباط (la discipline) حتى لا ينضاف ضعفها إلى ضعف المنظومة فتزداد جعجعة الأشياء ولا طحين، في زمن يتبنى فيه الجميع شعارات الجودة والحكامة والعمل بالنتائج الإيجابية المستهدفة والمخطط لها، من أجل ذلك يمكننا التساؤل مع المتسائلين:
ما المقصود من الانضباط، سلوك مظهري أم طبع جوهري؟ هل الانضباط يخص التلميذ/ة وحده أم يهم الجميع كل من موقعه؟ ما مرجعية هذا الانضباط، قيم حضارية خالدة أم قوانين مدرسية عابرة وعادات وأمزجة شخصية فاسدة؟ مدى مشاركة التلاميذ والأسر في بلورة هذا القانون ومدى معرفتهم به أصلا؟ مدى موازنته بين الحق والواجب وبين الحرية والانضباط وبين الشخصي والجماعي؟
مدى مراعاة الديناميات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية وخصوصيات الأجيال؟ أي مجلس تأديبي مسؤول عن الفصل في نزاعاته وهل من تمثيلية حقوقية للتلاميذ فيه؟ ما مدى حزم هذا المجلس في اتخاد ما يفيد من قراراته العادلة وأي صلاحيات له في ذلك؟ أي سياسة تواصلية إعلامية تحسيسية للمؤسسة حول قانونها مع كل جهة وفئة يهمها الأمر؟ ما علاقته بالاختيارات والتوجهات التربوي العامة من تعميم التمدرس وجودة التعلمات وفرص وعدالة اجتماعية..؟
إن الانضباط دعامة تربوية أساسية، وهو لا يعني في شيء لا هيمنة الأستاذ على القسم وتسلطه على التلاميذ، ولا نزوعه إلى الطرق التقليدية العقيمة في التعليم، بل هو تنظيم العلاقات والعمليات والتدخلات..، كل في وقتها وبحجمها وطرفها وآدابها..، والتنظيم أساس النجاح، وسيظل كذلك كلما كانت هذه الدعامة التربوية (الانضباط) شمولية وسلوكا جماعيا ولها الجرأة على تنظيم جوانب أخرى أساسية ومؤثرة في عمق العملية التربوية : كمحاربة الاكتظاظ.. أو المؤسسات الثكنات بالآلاف من التلاميذ متفاوتي الأعمار.. أو ضعف المختبرات وإزالة التفويج من المواد التجريبية.. أو تساهل طرف من الأطراف في تفعيله، كأستاذ لا قدرة له على الرقي إلى روح القانون وتقدير الحالات، أو تلميذ لا قانون عنده إلا قانون الشارع، أو إداري يستثقل التدخل في الحالات، أو ولي أمر يقول أنا من اشتريت هذا الذي تشتكون منه لابنتي..؟
إننا في حاجة إلى تدريس مادة الآداب وفن المعاملة وروح القانون وحرمة المؤسسة والمسؤولية والحقوق والواجبات.. قبل أن يدرسها لنا “التجنيد الإجباري” ومخيمات المهاجرين السريين ولاة حين مناص، إن المعرفة إذا فاتتنا يمكن تداركها وبالعديد من الطرق والوسائل وفي العديد من الأماكن، لكن الآداب والأخلاق إذا أخطأتنا أو اختلفنا حولها فلا علم ولا آداب ولا عمل ولا مسؤولية ولا شيء مما يبني الهوية والمرجعية والقيم..، قيم الحرية والمسؤولية والوطن والمواطن؟