هذه تحديات الدخول المدرسي الجديد. فمن يرفعها 2/2 – الحبيب عكي
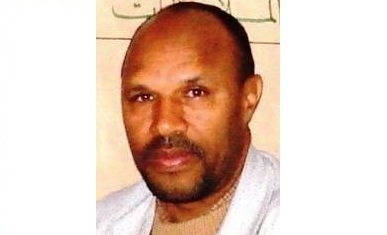
4- التحدي الرابع: اضطرابات تدبير الفائض والخصاص المتكرر بداية كل موسم: وهو أمر مرتبط أيضا في جزء منه بتنظيم الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، ولا أدري أي جرم شنيع يرتكبه الإداريون عندما يعلنون عن نتائج الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، فإذا بمدراء المؤسسات التربوية يقعون في ورطة كبيرة تربك دخولهم المدرسي واستقرارهم التربوي، إذ يكونون قد دفعوا خريطة مدرسية بدون خصاص آخر السنة، وإذا بهم ينجح بعض الأطر العاملين عندهم في بداية السنة، ولا يجدون من يعوضونهم به رغم زوبعة الفائض والخصاص.
فالمديرية الإقليمية ككل قد يكون عندها خصاص في الأطر في بعض المواد، مع حذف ما كان ساريا من الحركة الانتقالية المحلية والحركة الجهوية التي كانت توازن بعض الشيء. أضف إلى ذلك اللواتي يذهبن في رخصة ولادة أو الذين يذهبون في رخصة مرض، فإذا العديد من المؤسسات في أزمة خصاص مع بداية الموسم الدراسي.
وإذا عجز التعويض واستحالته في بعض الأحيان يفرضان المعالجة المرة على الجميع، بحشر التلاميذ في أقسام أربعينية وخمسينية غاية في الاكتظاظ الذي ندعي محاربته، وحذف التفويج في المواد العلمية على المستوى الإعدادي والثانوي، حتى يفجروا أعصاب الأساتذة العاملين وينغصوا عليهم طريقة عملهم التجريبية وكأنهم هم المسؤولون عن هذه الأزمة والاضطراب وعليهم أن يتحملوا وحدهم تكلفة ترقيعها المكلف، بدل العشوائية المقرفة لبرمجة الامتحانات، وبدل غياب مكاتب التخطيط والتوقعات أو سحب القرار منهم كما يسحب من غيرهم، ناهيك عن العشوائية التي يدبر بها أمر تصريف هذا الفائض، فمرة حسب آخر من التحق، ومرة حسب الأقدمية في المنطقة، ومرة بالتكليف، ومرة بالتعيين الإجباري النهائي..، وكلها تدابير تمزق الأستاذ في عمله وأمنه واستقراره.
5- التحدي الخامس: هو خطورة تراجع المبادرة والإخلاص في العمل: الإخلاص ليس بمعنى الحضور والعمل الدائم، ولكن عندما ترى هناك اختلالات ينبغي أن تصلح ولا تصلح ويتغاضى عنها المسؤول رغم كون الأمر ليس ضروريا.
أولا، لأن الرؤية والمخططات والبرامج لا يمكن إنجازها بغير العمل والعمل الحقيقي، وهذا أمر متعثر في المنظومة على أكثر من صعيد، حتى أن المتتبع للشأن التربوي من الداخل كثيرا ما يتساءل هل هناك فعلا رؤية ومخططات.. برامج ومؤشرات أم لا ؟ مذكرة تتحدث عن تفويج الأقسام في المواد العلمية ولا تفويج؟ ومذكرة تمنع الاكتظاظ وهو المستشري، وأخرى تتحدث عن الحياة المدرسية ولا حياة؟ وأخرى تتحدث عن العتبة في النجاح ولا عتبة.. وهكذا؟ وكل ذلك استقال من إصلاحه الإطار فسقط في مجرد تدبير أزماتها ومتاهاتها؟
ثانيا، لأن الإطار في هذه المنظومة أصبح مكبلا في المجمل بالعديد من المذكرات والفصول التي لا تسمح له بكثير، شيء ليس من حقه، ليس من حقه، وكل ما من شأنه فليس من حقه، أولا تشتيتا للمسؤولية وتمديدا لمسارها حتى تسهل مراقبتها في أية محطة تدعو إلى ذلك، ثانيا هذه المقاربة الأمنية الضيقة أدت إلى فقدان الثقة في الجميع من غير الفرق المعلومة التي ترفع شعار ” العام زين” والذي لا يتخذ من القرارات إلا ما يصادم مقاصد أصحاب القرار الفوقي الأكبر في المنظومة.
وهكذا أصبح الأستاذ يرى العديد من مواقف التدخل والمبادرة والإصلاح ولا يتدخل لأن القانون لا يسمح له بذلك: لا تخرج تلميذا، لا تتدخل في سلوك تلميذة، لا تجبر تلميذا على واجب، لا تضعف نقطته، لا تقف ضد نجاحه وانتقاله، لا لا..، حتى أصبح هذا الأستاذ وكأنه غريب عن المنظومة، ولكن ما به من روح إنسانية وطاقة إبداعية تأبى إلا أن تتفتق وبشكل مدهش في أشياء خارج المنظومة، في ممارسة التجارة، في التعليم الخصوصي، في العمل الجمعوي، في النضال السياسي.. فبأي رهان وبأي دخول مدرسي يمكن للمنظومة استعادة أطرها البررة المخلصين المبدعين، وتيسير مبادرتهم وعملهم الجماعي التعاوني على أكثر من صعيد؟
6- التحدي السادس: هو مدى الانفتاح الفعلي على الشركاء والفاعلين: وخاصة الفاعلين الجماعيين والجمعويين، لكن مع الأسف، مدارسنا في المجمل لا زالت منغلقة حتى على الآباء والأسر، بل أحيانا حتى على الأساتذة الذين يعملون داخلها، فما بالك بالطاقات التدريبية والتجديدية والجامعية في محيطها، أو على الصعيد الوطني ولما لا الدولي؟
مع الأسف، بعض المدراء يحسبون مؤسساتهم ضيعات خاصة بهم وليست ملكا للدولة ولا في خدمة الصالح العام، وبالتالي لا يتعاملون معها إلا بحس وظيفي ضيق، شعارهم خير الانفتاح ألا أرى أحدا ولا يراني “هذا نهار الأحد، ما يسال حد في حد”. لكن هل يحاسب هذا المدير على الانفتاح والعلاقات أو على الأقل يشجع على ذلك وتيسر له مساطير ممارسته.
أتذكر مجلسا جماعيا هو من أخذ المبادرة اتجاه المدارس، وكم استفادت منه في إصلاح إنارتها ورسم ممراتها وتشجيرها وتعبيد مداخلها ودعم جوائز تفوقها..، وأتذكر عهد أحد المدراء الإقليميين وما كان يتسم به من سعة الصدر وشجاعة القرار والقدرة على تعبئة الفاعلين لصالح المنظومة، فأمر بوضع المدارس وقاعاتها رهن إشارة الجمعيات لممارسة أنشطتها مع المتمدرسين ومع غيرهم، وكم كان في عهده من دروس محو الأمية للنساء ودروس الدعم والتقوية لليافعين والتربية غير النظامية للمنقطعين والمعلوميات واللغات للشباب، وكم كانت من ألعاب كبرى ومسابقات ثقافية للتلاميذ ورحلات استكشافية ومقابلات رياضية، بل حتى مخيمات حضرية في العطل الربيعية والصيفية، وكل هذا قد انقطع اليوم، رغم أن المدارس لا زالت تحتاج إليه ويدعم دراسة الناشئة، خاصة مع ترسيم التعليم الأولي والحاجة إلى دعمه، ولكن لغياب الانفتاح، كم من جمعية مدنية طفولية متخصصة تسعى للتأطير في مؤسسة تعليمة وتغلق الأبواب في وجهها.
فبأي رهان تربوي وبأي دخول مدرسي يمكن أن نتجاوز مثل هذه الحسابات السياسوية الضيقة في التربية، تلك التي تقصم ظهر التعبئة والشفافية والمقاربة التشاركية والتعاون، تمنح للبعض ما تمنع منه البعض الآخر؟
وأخيرا، فمنظومة الإصلاح هذه وعربة الرهانات متعددة الحلقات لا تستثني أي طرف من الأطراف، التربوية منها والإدارية، التلمذية منها والأسرية، الشركاء والفاعلين والمستثمرين، وليتيقن الجميع أن عطالة حلقة من الحلقات أو عدم ضبطها وإعطائها حقها ومستحقها في الحركة والإحكام والدفع أو المقاومة سيؤثر على النظام ككل وعلى حركته وسرعته، إن لم يكن على وجهته واتجاهه ومردوديته وجودته أيضا، ولن نكون جميعا في المستوى المطلوب إلا برفع هذه التحديات وغيرها، قبل أن تصبح “طرطتنا” التعليمية “حريرة” جارية، ونحن الذين أردناها أجود “الطرطات”، لكن بدون ما يلزم من المواد والمقادير ولا ما يلزم من الكيفيات والمنهجيات والحراريات.
لقد جاء مؤخرا، تصنيف “شنغهاي” لأفضل ألف جامعة أولى في العالم، ولم ترد فيه ولا جامعة مغربية واحدة، فقال أحدهم إنه تصنيف مجتمعات وليس جامعات، فكيفما يكون مجتمعنا تكون مدارسنا وجامعاتنا، وليعلم من يستثقلون استثمارنا في التعليم رغم هزالته (7،6 % من مجرد 480 مليار درهم 2020، بما يعطينا حوالي 72 مليار درهم)، أن “تركيا” قد رفعت من ميزانية استثمارها في تعليمها ب 720% بما يناهز 1220 مليار درهم، أي 20 % من ميزانية الدولة، ورغم أن الميزانية مجرد إشكال في الموضوع، فقد مكنها ذلك من رقمنة برامجها ومقرراتها الدراسية و من بناء 100 جامعة جديدة ليصبح عدد جامعاتها 168، وبذلك نفهم كيف تمكنت من أن تصبح من الدول الكبرى (16 عالميا) في ظرف قياسي (15 سنة فقط).


