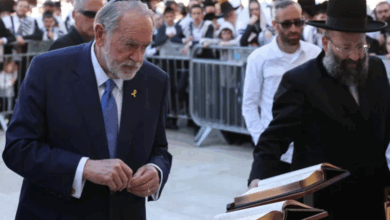نعم انتصرت المقاومة وإسرائيل تتفكك رويدا رويدا – عياد أبلال

أوشكت المرحلة الأولى من اتفاقية وقف الحرب في غزة وما تضمنته من صفقة لتبادل الأسرى على الانتهاء بنجاح، ولكن أصواتًا هنا وهناك لا تفتأ تقلل من انتصار المقاومة الفلسطينية، وتدين، في العمق، حماس بوصفها حركة من حركات الإسلام السياسي، التي لا يهمها سوى السلطة، حتى ولو كان ذلك على حساب الجثث والمعطوبين واليتامى، وفي ذلك تسويق أيديولوجي مقيت للسردية الصهيونية، ولأن هذه الأصوات لم تنشأ في بيئة النضال السياسي الذي تراجع بشكل كبير منذ خيبة 1967، وتوالي النكسات في المنطقة العربية.
وبما أن السردية الغربية، عبر أذرعها الإعلامية، استطاعت أن تسوق الداعمين للمقاومة كمحور للشر والدمار، وأن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي مدخل للاستقرار والازدهار، فقد ألفت هذه الأصوات الخنوع والاستسلام، خاصة بعد تراجع دور المثقف العضوي، وانتشار التفاهة والتسفيل في المجتمعات العربية والغربية على حد سواء، بعدما تحول هذا المثقف إلى مجرد خبير ضمن ماكينة الرأسمالية الاحتكارية والنيوليبرالية التي حولت قيم الكرامة والعزة والنخوة والحرية إلى مفاهيم النجاح والقدرة والقوة.
وبذلك، تسللت إلى صفوف النخب قيم بديلة ارتكاسية من قبيل: الوصولية، والفرص، والأنانية، والأداء والفاعلية، لتتحول هذه النخب بدورها من وظيفتها النقدية إلى وظيفة التسويق للنموذج الغربي في الثقافة والسياسة والاقتصاد.
والدليل على الانهزامية التي بموجبها بات انتصار المقاومة هزيمة، هو ترديد “لأسطوانة الإسلام السياسي والرغبة في السلطة والحكم ضدًا على الأبرياء من المدنيين”، حينما يتم الحديث عن انتصار حماس، فاعتماد المقاومة على العقيدة الدينية لا ينفصل عن العقيدة الفكرية والثقافية لأرض فلسطين.
وكل مقاومة في العالم تستند بالضرورة إلى عقيدة دينية أو فكرية، وإلا لجاز لنا أن نقول على لسان هذه النخب الدائرة في فلك السردية الغربية، إن المقاومة في المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وسوريا، والعراق، وعموم البلدان العربية والإسلامية ضد الاستعمار، هي إسلام سياسي.
ولو ارتكزنا على هذه السردية لكانت بلداننا ما تزال ترزح تحت نيران الاستعمار. ولو صدقنا هذه السردية لكان لاهوت التحرير بأميركا اللاتينية هو مسيحية سياسية قياسًا بالإسلام السياسي، ولو كان الأمر كذلك، لما تحررت هذه البلدان نهائيًا.
إن اشتغال السردية الغربية، والصهيو-أميركية على إعادة تشكيل العقول في العالمين العربي والإسلامي والعالم الثالث بشكل عام، يمرُّ حتمًا عبر إعادة تشكيل المناهج الدراسية والبرامج السياسية، مصحوبة بقصف إعلامي يومي، عمل وما يزال، على فصل الشعوب عن تاريخها الحقيقي، وتبييض تاريخ الاستعمار والإمبريالية، فنسيت الأجيال المتعاقبة معنى المقاومة، وثمن المقاومة، وتضحيات أجيال الأجداد من أجل الحرية.
وهكذا، لم يعد لدرس المقاومة وجيوش التحرير في القرنين التاسع عشر والعشرين وجود في المقررات الدراسية وفي البرامج الإعلامية إلا ما ندر. طبيعي والأمر كذلك أن يتحول انتصار غزة على تحالف دولي مشكل من إسرائيل ودول غربية مدت الكيان المغتصب بالسلاح والعتاد والمال والجنود إلى هزيمة في نظر هؤلاء. بيد أن واقع الأمر مختلف تمامًا، وذلك للحجج السبع التالية:
أولًا: حرب إبادة وليست مواجهة عسكرية متكافئة
إن الحرب الإسرائيلية على سكان غزة لم تكن حربًا في حقيقة الأمر، ما دام أن الأمر لا يتعلق بحرب بين جيشين نظاميين، بل بين جيش حديث ومتقدم ومتطور، تكنولوجيًا وعسكريًا، ومدعوم من الغرب، وبين حركة مقاومة. ولذلك، فالتعبير الأصح هو حرب إبادة. ومن هنا، فاتفاق وقف الحرب في كل الأحوال انتصار لحركة المقاومة.
وبالنظر إلى الأهداف التي حددتها إسرائيل في حرب إبادتها هذه بعد طوفان الأقصى، والتي كانت تتجلى في القضاء على حماس وتجريدها من السلاح، وفي تحرير الرهائن بالقوة العسكرية والاستخباراتية، واحتلال شمال غزة، وضم محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا جنوبًا ونتساريم غربًا في أفق ترحيل الغزيين إلى سيناء حسب الإستراتيجية الاستيطانية الإحلالية للكيان الصهيوني، فقد انتهت بأن عادت حماس أكثر قوة وعددًا.
وهو ما أقر به وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن في آخر ندوة صحفية له بالبيت الأبيض قائلًا إن “حماس جندت عدد مقاتلين يساوي ويزيد عددَ مَن فقدتهم، وأن هزيمة المقاومة الفلسطينية مستحيلة”.
وبدل القضاء على حماس، صارت إسرائيل توقع اتفاقية وقف الحرب معها، بعدما أثخنت الجيش الإسرائيلي، حيث تجاوز عدد قتلاه ستة آلاف، فيما تجاوز عدد مصابيه 16 ألف جريح، 8600 منهم يعانون من إصابات جسدية، في حين يعاني 7500 من اضطرابات وأمراض نفسية، ناهيك عن العاهات الجسدية المستديمة، وهو ما أصاب الجيش الإسرائيلي في مقتل، خاصة بعد انتشار التذمر واليأس في صفوفه، بعد أن وقّع أزيد من 200 ضابط عسكري بيانًا برفض الحرب لعدم قدرتهم على الاستمرار. ناهيك عن ارتفاع أعداد الانتحار، والتهرب من الخدمة العسكرية، ورفض الانضمام أصلًا لجيش الاحتلال.
وقد رأينا أيضًا كيف أن السجون الإسرائيلية، بموجب صفقة التبادل، تم تبييضها جزئيًا من المعتقلين الفلسطينيين من كل المذاهب والتوجهات السياسية، بما يفيد أن حركة حماس حركة مقاومة وطنية تعلو على الانتماء الحزبي والمذهبي وتنتصر لفلسطين، عكس ما تروجه السردية الصهيونية. وها هي إسرائيل بموجب بنود الاتفاق قد انسحبت من شمال غزة وجنوبها وغربها مقابل عودة الغزيين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم.
وبالرغم من مماطلة الكيان الصهيوني وتنكره لاتفاقية تسليم الأسرى بضغط وتهديد أميركي غير مسبوق بتحويل غزة إلى جحيم، وتلويح ترامب بتهجير الغزيين، صمدت حماس على مواقفها المبدئية، مما جعل الكيان الصهيوني يرضخ ويتمم الصفقة في مرحلتها الأولى.
كما أن الدعم الدولي الذي لقيته المقاومة عقب ذيوع مشروع ترامب/ نتنياهو بخصوص التهجير، اتخذ صيغة رفض وتنديد من عدد كبير من العواصم العربية والإسلامية والدولية على حد سواء، وهو ما يعتبر انتصارًا سياسيًا ودبلوماسيًا لفلسطين وللمقاومة.
ثانيًا: الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي أمام مقاومة خبيرة وذكية
إن فشل إسرائيل وهي التي تمتلك أجهزة استخباراتية من الأكثر قوة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها “الموساد” و”الشاباك”، مدعومة بأعتى الأجهزة الاستخباراتية في العالم، والمزودة بأعظم ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة من أقمار صناعية وبرامج تجسس واستطلاع في كشف سر الأنفاق وتحرير الرهائن، لدليل قاطع على ذكاء وخبرة المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس، وكتائب القسام وباقي الفصائل.
وهذا المعطى الإستراتيجي يجب ألا يغيب عن ذهن المحللين والخبراء المستسلمين للفكر الانهزامي وللسردية الغربية، فتضافر جهود كل هذه الأجهزة الإسرائيلية والأميركية وأجهزة الناتو في التعاون والتشبيك وتبادل المعطيات حول أنفاق غزة في مساحة كلية لا تتجاوز 360 كيلو مترًا مربعًا، وهي مساحة كل قطاع غزة فشلَ فشلًا ذريعًا في تفكيك المقاومة والانتصار عليها وتحرير الرهائن.
ثالثًا: الصمود الأسطوري لسكان غزة رغم الدمار والمعاناة
بالرغم من حجم الدمار الذي شمل غزة، بسبب آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ، بما فيها الفوسفورية، والممنوعة دوليًا، طيلة أزيد من خمسة عشر شهرًا، ومقابل أزيد من خمسين ألف شهيد، ومئات الآلاف من المصابين والمفقودين منذ طوفان الأقصى، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، وتشريد أزيد من مليون غزّي، فلم تستسلم المقاومة، ولا انتفض المدنيون ضد حماس وكتائب القسام، ولا انتشرت سلوكيات الخيانة وبيع الذمم للإيقاع بالمقاومة، بل ظلّ الغزيون صامدين مقاومين يدعمون مقاتليهم بشكل أسطوري، حتى في أوَج البرد والجوع والسكن في الخيام بعد أن دمر الكيان الصهيوني أزيد من 70 في المئة من المساكن والبنيات التحتية، ولم ترتفع بالنهاية ولو راية بيضاء واحدة.
رابعًا: المقاومة قيمة إنسانية وتاريخية ضد الظلم والاستعمار
كانت المقاومة عبر التاريخ، وخاصة تاريخ الإمبريالية الغربية، دفاعًا عن الشرف والكرامة والحرية، وعن قيم الخير ضد الشر.
كانت منذ بدايتها دفاع الأقلية الضعيفة ضد الأكثرية القوية، دفاع العدل ضد الظلم والحرية ضد العبودية، كانت منذ بدايتها، في القرن التاسع عشر، رفضًا للاستعمار والعبودية، وضد قيم الغرب الإمبريالي.
ولذلك، فغزة لم تكن تدافع عن نفسها، بل كانت تدافع عن العالم الحر، عن قيم الإنسانية والتحرر. من أجل ذلك، ليس عبثًا اصطفاف الغرب بزعامة أميركا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وعموم الناتو داعمة لإسرائيل ضد شعب أعزل. لهذا، من الطبيعي أن تكون كفة وموازين حرب الإبادة مختلة بين تحالف قوى الشر وبين شعب في بقعة أرضية صغيرة جدًا، ومن الأكثر كثافة سكانية في العالم.
تقودنا العودة إلى التاريخ حتمًا لاستخلاص أنه بالرغم من كل ما حصل في غزة من دمار انتصرت حماس على الكيان الصهيوني وحلفائه من الغرب، فما بين 1899 و1901 سقط أزيد من مئة ألف قتيل، معظمهم من المدنيين في الصين عقب ثورة “الملاكمين”، وهي انتفاضة شعبية صينية ضد تزايد النفوذ الغربي والياباني الذي كان يشكل تحالف القوى الإمبريالية في بداية القرن العشرين، وفي الأخير تحررت الصين وصارت لما هي عليه اليوم كأكبر قوة اقتصادية وتكنولوجية بعد أميركا، بل ومنافسها الشرس على زعامة العالم مستقبلًا.
وما بين 1954 و1962، طيلة سبع سنوات فقط تركت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في شمال البلاد وحده أزيد من مليون شهيد، وفي الأخير تحررت المقاومة الجزائرية وطردت المستعمر الفرنسي من أرضها.
وفي الحرب الفيتنامية قدرت أعداد القتلى بأربعة ملايين قتيل معظمهم من المدنيين، وفي النهاية انتصرت المقاومة الفيتنامية وتحررت البلاد من الاحتلال الأميركي والفرنسي.
وهو الأمر عينه الذي ينطبق على المقاومة في سوريا، والعراق، ولبنان، والمغرب، وتونس وفي عموم بلدان أفريقيا ضد الاستعمار الغربي والرأسمالية الاحتكارية والإمبريالية. فما عاشته شعوب هذه البلدان من تقتيل وتجويع وتعذيب وإبادة يتكرر اليوم في غزة.
ولذلك، فما خلفته المقاومة الفلسطينية من خسائر في صفوف الكيان الصهيوني على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي والمعنوي يعتبر انتصارًا كبيرًا.
خامسًا: انقلاب الرأي العام العالمي وهزيمة إسرائيل سياسيًا
إن السرعة التي كانت تسير بها صفقة القرن وإعادة تفكيك وتركيب وتشكيل الشرق الأوسط “الجديد” من تقسيم للدول وإضعاف لها، ومن تطبيع موازٍ مع الأنظمة العربية، مقابل النفوذ الإسرائيلي في المنتظم الدولي، انقلبت بـ 360 درجة بعد طوفان الأقصى، وما ترتب عنه من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، إذ سرعان ما انقلب الرأي العام الغربي في أوساط كثيرة من الصحفيين والكتّاب والطلبة وعموم الجماهير؛ بسبب صور الدمار والتقتيل والإبادة المنهجية التي شنها الكيان الصهيوني، كسياسة وإستراتيجية، للقضاء على الشعب الأصيل صاحب الأرض.
ولذلك، فما يحدث الآن في الرأي العام العالمي من انقلاب جوهري يصب في صالح انتصار المقاومة، ذلك أن هزيمة إسرائيل السياسية تتجلى في تفكك معاقلها في الغرب، فنتيجة مساعي أيرلندا وإسبانيا والنرويج واعترافها بالدولة الفلسطينية، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 مايو/ أيار 2024 اعتماد قرار اعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية.
وبالرغم من أن هذا القرار وهذا الاجتماع غير ملزمين، فإنهما أحدث شرخًا عميقًا في وحدة الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام في دعمه اللامشروط لإسرائيل. ناهيك عن قرار الجنائية الدولية ومذكرة الاعتقال في حق نتنياهو وغالانت بوصفهما مجرمَي حرب في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وما تلاه من إعلان عدد من الدول موافقتها على هذه المذكرة واستعدادها لاعتقالهما وتسليمهما للمحكمة.
وبالرغم من الدعم اللامشروط للولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل، فإنه لأول مرة منذ حرب فيتنام، يشهد الشعب الأميركي انقلابًا جوهريًا في الوعي، خاصة من قبل الصحفيين والجمعويين والطلبة، فلم تكد تمر ندوة صحفية للرئيس بايدن أو لوزير خارجيته أنتوني بلينكن إلا وتمت مقاطعتها بأصوات المحتجين على حرب الإبادة وعلى مشاركة أميركا فيها بالعتاد والسلاح والأموال من دافعي الضرائب الأميركيين، دون أن ننسى أصوات التنديد التي ارتفعت في البرلمانات الأوروبية، وخاصة في إسبانيا وأيرلندا، والنرويج، وهولندا، وإيطاليا، وفرنسا… إلخ ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.
الأمر نفسه والذي تآكلت معه صورة إسرائيل في الخارج هو مقاطعة المهرجانات والمحافل الفنية والرياضية والمؤتمرات باحتجاجات مدوية، ناهيك عن المسيرات المليونية في عدد من العواصم العالمية، كان آخرها ليلة الاحتفال برأس السنة 2024، في بريطانيا، وأميركا، وهولندا، وأيرلندا… إلخ.
كل ذلك قلب الأزمنة وجعل مشروع أبراهام للتطبيع الذي قاده دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، في مهب الريح بعدما ارتفعت أصوات الشعوب منددة بما قامت به إسرائيل من تقتيل وإبادة في غزة، وقد كانت هذه الجماهير الشعبية قد بدأت تستسلم لشعارات الاستقرار والرخاء والسلام مع إسرائيل، بعد أن بدأت تنتشر أصوات الصهيونية الوظيفية في الأوساط العربية.
وهنا تكون إسرائيل قد خسرت، سياسيًا وإستراتيجيًا ومعنويًا، بالنظر إلى حجم وتكاليف صناعة صورة إسرائيل بالخارج عامة، وفي صفوف النخب في البلدان العربية والإسلامية خاصة، وهي صناعة كلفت مليارات الدولارات في العقدين الأخيرين. ناهيك عن خسارة ما كانت ستجنيه اقتصاديًا من اتفاقية أبراهام، خاصة أنها كانت ستشمل باقي بلدان الخليج العربي وعموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سادسًا: خسائر إسرائيل الاقتصادية الفادحة
بالرغم من دعم الولايات المتحدة الأميركية وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، فإن حجم الخسائر الذي تكبده الاقتصاد الإسرائيلي منذ طوفان الأقصى، حسب الحكومة الإسرائيلية غداة توقيع اتفاقية وقف الحرب، يجعل المنتصر الأكبر هو المقاومة في فلسطين، ذلك أن إسرائيل خسرت 67 مليار دولار خسائر إجمالية، منها 34 مليار دولار خسائر عسكرية مباشرة، و40 مليار دولار حجم العجز في الميزانية العامة، وهو الأكبر في تاريخ إسرائيل، وهناك 60 ألف شركة أغلقت أبوابها خلال 2024، وحجم الخسائر في السياحة تجاوز 5 مليارات دولار، و4 مليارات خسارة في قطاع البناء. وبالنهاية، أصبح ثلث سكان إسرائيل يعيشون تحت عتبة الفقر، وربع عدد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
سابعًا: الهجرة العكسية وتراجع الثقة بمستقبل إسرائيل
إن الانهيار الأكبر الذي عرفته إسرائيل، يتمثل في موجات الهجرة والهروب الجماعي من إسرائيل منذ طوفان الأقصى، والذي تقدره الحكومة الإسرائيلية بنحو نصف مليون إسرائيلي تركوا وراءهم الأرض “الموعودة”، وأرض “شعب الله المختار”، راجعين إلى بلدهم الأصلي من بلدان أوروبا وأميركا. وحسب استطلاعات الرأي، عبَّرَ ثلث الإسرائيليين عن رغبتهم في الهجرة من إسرائيل، وأن نصف الجيل الحالي من الإسرائيليين لديهم خطط لمغادرة دولة الاحتلال.
ولعلنا نجد في المقال التحليلي الذي كتبه “خوان كول” المؤرخ الأميركي المختص في شؤون الشرق الأوسط ورئيس تحرير موقع ” أنفورميد كومنت”، خير مثال على انخفاض وتراجع ثقة الإسرائيليين وعموم اليهود في إسرائيل، حكومة وجيشًا، بالرغم من ارتفاع حجم المنح والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة للراغبين في العودة والاستقرار في إسرائيل.
بل وتذهب التقديرات والدراسات الجارية حاليًا إلى أن الارتفاع في موجات هجرة العودة من إسرائيل إلى أوروبا وأميركا سوف تعرف ارتفاعًا مذهلًا في القادم من السنوات.
ثامنًا: انتصار المقاومة الأخلاقي وتفوقها في حرب الصورة
لا يخفى اليوم دور الصورة في الحروب والصراعات المعاصرة، وإذا كانت المقاومة قد انتصرت على المستوى الميداني، من دون أدنى شك، فإن انتصارها في حرب الصور والعلامات والرموز، يعد أحد أهم الأسلحة التي وظفتها المقاومة في كسب الرأي العالمي، وتعميق مستويات الهزيمة الإسرائيلية، وهو ما اعترف به قادة الكيان الصهيوني قبل غيرهم.
إن الإخراج الاحترافي لعمليات التسليم وفق ترتيبات لا تخلو من جمالية، جعلت صورة حماس في الإعلام الدولي تتربع على عرش النقاش العالمي، بوصفها تترجم قوة وإرادة وذكاء من الصعب توفرها اليوم، خاصة أن هذه الخصائص تعكس في الحقيقة انتصارًا أخلاقيًا كبيرًا، مقابل الأفول الأخلاقي للكيان.
وسواء تعلق الأمر بالمعاملة الحسنة والرائعة للأسرى، أو منحهم هدايا وتذكارات، أو باحتفالية توديعهم وتسليمهم للصليب الأحمر، مقابل الوضعية المزرية للأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان، فإن الخلاصة هي الانتصار الأخلاقي مقابل هزيمة قوى الشر والضغينة التي يمثلها جيش الاحتلال الإسرائيلي وداعموه من الغرب.
إن التفكيك القادم لإسرائيل هو التفكيك من الداخل، خاصة مع ارتفاع موجات رفض المد اليميني المتطرف وتراجع مستويات الديمقراطية وهيمنة مؤسسة الجيش والاستخبارات على معاقل السلطة والحكم داخل إسرائيل، وهو ما أسهم فيه بشكل كبير طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث، خاصة في ظل تمدد موجات الدعم الدولي والشعبي للقضية الفلسطينية، حتى في صفوف اليهود في أوروبا وأميركا.