كيف تستفيد المدرسة من محيطها الجمعوي الحيوي؟ – الحبيب عكي
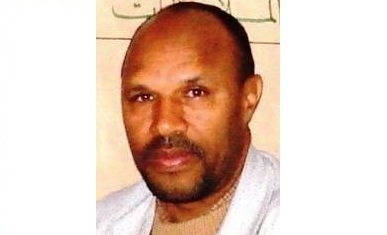
من الملاحظ، أن المدرسة المغربية، وفي الوقت الذي ترفع فيه شعار:” ضرورة الانفتاح على محيطها الخارجي والتعاون في أداء مهامها مع الأسرة والجمعيات والجماعات وغيرهم من الفاعلين”، نجدها في الغالب منغلقة على ذاتها وعلى جمعيات المجتمع المدني خاصة، وربما، إلى درجة لا تستفيد فيها حتى من الجمعيات التي يفرضها عليها القانون وتقوم هي بتأسيسها كالجمعية الرياضية، وجمعية الآباء، وجمعية مدرسة النجاح التي قد تكون علاقتها بها محصورة في مجرد بعض الجبايات من التلاميذ وبعض التدخلات المناسباتية على بساطتها ونذرتها.
والواقع أن هذا خلل تدبيري تتولد عنه العديد من الاختلالات التربوية والتي كلما حاولت المدرسة حصرها ومعالجتها إلا وتفاقمت واستفحلت، وطبعا أثرت بشكل سلبي على سيرها ومردوديتها. ترى ما هي أسباب انغلاق المدرسة على جمعيات المجتمع المدني في محيطها الحيوي؟ أي دور لهذه الجمعيات لتنمية التربية والمدرسة؟ وهل بإمكانها النجاح في ما قد تفشل فيه الدولة وغيرها من الأحزاب والنقابات؟ ما هي معوقات وعراقيل الممكن من التواصل السلس والطبيعي بينهما؟ وما هي مقترحات تدابير الحلول والمعالجة لتحقيق الممكن من الانفتاح والتعاون والشراكة التي ستخدم تمدرس النشء قبل كل شيء؟
1- جزء أساسي من الإشكال تصوري وهو خاطئ: عندما يتصور السيد المدير المحترم مثلا، أن مؤسسته التعليمية ليست في حاجة إلى الجمعيات، وأنها يمكنها أن تؤدي رسالتها التربوية والاجتماعية بمفردها، وأن دخول الجمعيات إلى المؤسسة إنما هو إضافة “صداع الرأس” هو في غنى عنه، وربما معارك إيديولوجية وأسئلة وتقارير أمنية غير مرغوب فيها في الوسط التربوي على الأقل، ومن تمة تقوم الدوائر الإدارية العليا من مديرية وأكاديمية وغيرها بتعقيد بروتوكول التواصل مع جمعيات المجتمع المدني أو طيف منها، وتأويل مواده حسب هواها والمتنفذين في مكاتبها، بل وتجاوز ما ورد في الموضوع من مذكرات وزارية شاملة (1992/28) ناهيك عن دورية الوزير الأول بشأن الشراكة والمناولة (2003/7) والفصول الدستورية بشأن الديمقراطية التشاركية (12 و26 و33 و34 و170..).
2- وجزء من الإشكال أيضا تأهيلي ويمكن تجاوزه: صحيح أن العديد من الجمعيات ليس لها أطر متخصصة في التربية والتكوين وتمتلك فيها رؤية واضحة وذات قيمة مضافة، ولكن جل الجمعيات إن لم نقل كلها لها أطر يمارسون داخل المنظومة، ولديهم خبرة طويلة ومعتبرة في العديد من المجالات الهامة التي تحتاجها المدرسة، في التنشيط التربوي والتعليم التفاعلي، في التعليم الأولي وبيداغوجيا الامتاع، في محو الأمية وإعطاء دروس الدعم والتقوية، في التربية غير النظامية، في تنمية المهارات والدورات التكوينية، في المخيمات الصيفية، في المشاريع المدرة للدخل، في الحملات التحسيسية لمحاربة التدخين والمخدرات، في الأمسيات والمسابقات والدورات والدوريات، في تعبئة رؤوس الأموال الوطنية والدولية عبر المشاريع والشراكات، في بناء بعض الفضاءات التربوية وتجهيزها بلوازمها من أدوات ومعلوميات، في توفير بعض وسائل النقل الفردية والجماعية، وكل هذا وغيره كثير، يمكن أن تستفيد منه المدرسة بمقتضى شراكة بينها وبين الجمعية المؤهلة، شراكة تحدد فيها طريقة العمل الجمعوي داخل المؤسسة التربوية، أوقاته وملفاته وبرامجه ومؤشراته التربوية والاجتماعية وغيرها.
3- وتظل جمعيات المجتمع المدني توزع الفرح رغم العراقيل: لعل أبسطه هذه الأدوار التأطيرية والتنشيطية والاجتماعية والخدماتية التي عجزت المدرسة بانغلاقها وتوجسها أن تستفيد منها حتى، ومن باب التجربة، كم كانت أسرة تفرح لأن في حيها وبجوارها جمعية تربوية تستوعب فراغ أبنائها وتصقل مواهبهم بمتعة وإفادة؟، وكم كان معلم يفرح لأن أطفال التحضيري كانوا يأتونه من روض جمعية مجاورة وهم قد تجاوزوا الكثير من إشكالات القراءة والكتابة عكس غيرهم.
وكم كان أستاذ يفرح كلما كثر عنده تلاميذ من رواد جمعيات لأنهم يمتلكون الكثير من المهارات والسلوك المدني ولا يجد معهم من إشكالات السلوك والانحراف الذي يشين غيرهم، وكم كان مدير مؤسسة يفرح عندما يجد جمعية مدنية متطوعة تفك له ما أشكل عنده من الحالات الاجتماعية للتلاميذ والتلميذات أدوات وحملات..، ربما أكثر جدوى وأسرع تنفيذا حتى من المديرية المعنية، وكم كانت هذه المديرية ذاتها تفرح عندما تجد من يمثلها في المنافسات المسرحية والرياضية والقرائية وغيرها، مبدعي ومؤطري أنشطتها من الأطر الجمعوية التي ألفت الإبداع في الجمعيات والمخيمات ولا تتأفف من مشاق التأطير ولا مجانية التطوع.
ويبقى دور المجتمع المدني اتجاه المدرسة أجل وأكبر، من هذه الخدمات البسيطة على أهميتها، ومن ذلك مثلا:
1- ضرورة اقتحام مجالات عمل معاصرة تستدعيها حالة المدرسة: كالعمل على تطهير محيط المؤسسة من كل ما يمس بالتربية والقيم والأخلاق، والعمل داخل المؤسسة في محاربة المستجد من الظواهر التي تهدد تمدرس التلاميذ وأخلاقهم: الاكتظاظ ونقص في الفضاءات، ظواهر العنف والغش، والتحرش والابتزاز، والتدخين والمخدرات، وصعوبات التمدرس بمختلف أشكالها، وترك الصلاة وتراكمها طوال اليوم وغيرها من مظاهر ضعف الحافزية والتحصيل والمردودية بشكل عام.
2- العمل حسب الإمكان على نمذجة الفضاء المدرسي واستكمال مرافقه: لا أقول تعويض الدولة أو القيام بمهامها أو إعفائها من ذلك ولكن حسب الإمكان، وذلك باستكمال اللازم من القاعات وبستنة الساحات ورسم الممرات وتدوير المتلاشيات وتزيين الفصول والمداخل والمآرب والواجهات ونظافة المرافق الصحية وتنظيم الملاعب الرياضية وتزيينها وتجهيز المختبرات والمكتبات وقاعة العروض والندوات، وكذلك توفير الممكن من اللوجستيك الثقافي والفني والرياضي ووسائل النقل وفضاء الإقامة لمحاربة الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي..
ويكفي أن نعطي مثالا على إمكانية ذلك، فكم جمعية غيورة بنت مؤسسة ابتدائية أو إعدادية في قريتها وزودتها المديرية الإقليمية بالأطر التربوية اللازمة، فحققت حلمها في تمدرس أبنائها دون تنقل ولا إقامة مكلفة خارج بيئتها، ولا انتظار الذي قد يأتي ولا يأتي، وكم جمعية تدخلت تدخلا ناجحا في توفير وسائل النقل وإدارتها أو إقامة الفتاة القروية ومطعمتها.
ومؤسسة “زاكورة” للتربية غير النظامية والقروض الصغرى(وبغض النظر عن ماهيتها وممارساتها) فقد تمكنت من تأسيس 419 مدرسة للتربية غير النظامية ومحو الأمية وتعليم الفتاة القروية، استفاد منها 22 ألف مستفيد(ة)، وهي اليوم – حسب أرقامها – تعمل مع 50 ألف طفل في التعليم الأولي ومع 500 جمعية وألفين مؤطر(ة)، وقد راكمت 94 مشروعا إدماجيا مدرا للدخل بدعم من القطاع الخاص والرأسمال الأجنبي.
3- الترافع القوي والجماعي لدى الهيئات المعنية حول الرؤية الأسلم للتربية والتعليم: ومخططات الإصلاح المتعاقبة، حول المدرسة في العالم القروي وبدعة الأقسام المشتركة ومآلاتها، حول قضايا الفئات المحددة ممن تحتاج مثلا إلى وسائل النقل، وفضاء الإقامة، وتوفير الاطعام الصحي الجيد والمتوازن للمحتاجين والنضال عليه منحة وكمية ومسؤولين مؤتمنين، وجودة وكيفية، والاستمرار في الدراسة عند التعثر ولو في مسالك أخرى جديدة، وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم، وبعض الظواهر غير الحقوقية التي قد تحط رحالها في هذه المؤسسة أو تلك، إلى غير ذلك مما لن تستقيم دراستنا إلا به شئنا أم أبينا.
4- الدفاع عن التعليم المدني وضرورة نيل المتمدرسين حظهم منه: وذلك عبر نيل المتمدرسين حظهم منه داخل وخارج المؤسسات، وتثمين الخريجين عبره باعتبار ما اكتسبوه من المهارات وصقلوه من المواطنة والسلوك المدني وأتقنوه من الثقافة التطوعية، خاصة في هذا الزمان العابر للقارات والذي أصبحت فيه المعاهد والأكاديميات المدنية وبرامجها الراقية في التنمية الذاتية والمجتمعية أغلى ما يطلب في السوق الاقتصادية ويدعم الاستقرار النفسي والسلم الاجتماعي، وأهم ما يرفع بشأن متملكيه ويتيح لهم الاشتغال بشواهدهم وتدريباتهم عن بعد وعن قرب.
يقال أن أكبر الجامعات في العالم “السوربون” في فرنسا و”كامبريدج” في بريطانيا و “بادوفا” في إيطاليا، ومكتبة “نيورك سيتي” وهي أكبر استثمار معرفي تشغل اليوم أزيد من 3000 موظف، بنتها الفعاليات المدنية من طلاب وأساتذة ومحسنين مدنيين متطوعين، ولم نذهب إلى أوروبا وأمريكا، وتاريخنا الوطني وحضارتنا الإسلامية لا زالتا تحدثنا بمثل هذا مشخصا ومجسدا في جامعة “القرويين” التي بنتها امرأة صالحة أم المؤمنين فاطمة الفهرية، بنتها بكل ما يتطلبه الصرح التعليمي من فضاءات، ووسائط ومكتبات وكراسي علمية، ووقف وإقامات، وتمويلات وخدمات، وتأليفات وابتكارات، واستضافات، وطلبة خارجيين..؟
وأخيرا، لابد من فك الإشكال القانوني والتشريعي في الموضوع، بما يسهل تواجد جمعيات المجتمع المدني في الأوساط المدرسية بقوة القانون لا بمجرد المن والصدقة وعراقيل بيروقراطية وعصبية الانتماء وتهافت الاستقطاب، تواجد تعاوني تشاركي على طلب عروض ودفتر تحملات وبروتوكول تنظيمي يضمن الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، وقبل هذا وذاك المشاركة الفعلية في صنع القرار التربوي الذي يدعم المؤسسة ويواكبها ويقيم مردودها ويقوم سيرها، أولا، لأن أمر التربية أمر الجميع وأكبر من أن تنهض به جهة بمفردها مهما كانت قوتها، ثانيا، لأن المجتمع المدني لا يدخل الأوساط التربوية إلا بقيم مضافة فريدة ومتعددة، ثالثا، لأن أبناء المدارس أبناء الجميع، فلا داعي لادعاء أي جهة ما الحرص عليهم دون غيرها أو أكثر منها، رابعا، لأن أمر التربية هو تأثير الجميع في الجميع ويستحيل إبعاد الجمعيات عن المدارس وهي التي تحتضن النشء خارج الدوام ربما أكثر مما تحتضنه المدارس خلال الدوام.





