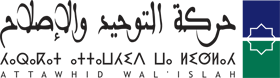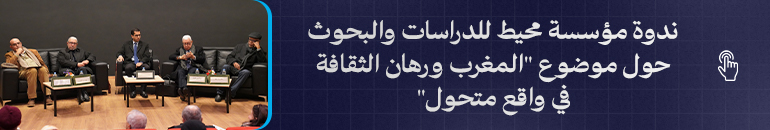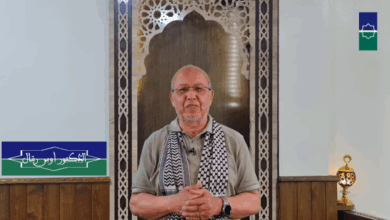د كريم عيار يكتب: التقصيد فيما يُظن في موضوع الدعاء وتأخر النصر والتأييد (الجزء الثاني)

ثانيا: ما الذي أخبرنا به سبحانه من حيث الأصل في الحياة الدنيا؟ هل الأصل فيها أنها دار جزاء وعدل؟ أم دار ابتلاء وعمل؟ هل حتمي فيها الاقتصاص من الظالم أم أنه قد لا يقتص منه؟
الجواب يتطلب فهم طبيعة الدنيا، ووظيفتها في ميزان الله، والفرق بين الدنيا والآخرة من حيث الجزاء والقصاص. إن استقراء النصوص يفضي إلى القول دون شك بأن الدنيا دار عمل ودار ابتلاء بالخير والشر، قال تعالى عن الدنيا: (وَنَبْلُوَكُمْ بالشَرِّ والخَيْرِ فِتْنَةَ) [النحل: 61]، وقال عن الآخرة: (الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، لا ظُلْمَ الْيَوْمَ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) [غافر: 17].
فليس الغرض من الحياة الدنيا هو إقامة العدالة المطلقة، لأنه بكل بساطة لو كانت كذلك لانقلبت هذه الدنيا إلى آخرة، بل لم يعد هناك داع للآخرة، فلو أُهلك الظالم في لحظة ظلمه، وأُنجِي المظلوم في ساعة مظلمته، لاقتصر الظلم على العهود الأولى، ولانمحى الظلمة من الوجود أصلا، ولما بقي معنى للصبر، ولا قيمة للجهاد، ولا حاجة لرسل ولا كتب ولا حساب، ولما بقي جدوى لهذه الحياة، ولما عايشنا شرا ولا أذى ولا ظلما ولا كفرا، لأن إقامته سبحانه العدالة في الحال، بقدرة قاهرة، للعيان ظاهرة، كاف للردع والزجر، ومنع الفساد والشر، والإلحاد والكفر، لكن آنذاك تُنتزع حرية الإنسان، ويفقد الابتلاء معناه، ويتحول الوجود إلى مسرح إكراه، لا ساحة اختيار، متجرد عن الاختبار.
قال سبحانه (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ) [النحل: 61]، وقوله تعالى : (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) [فاطر: 45]، وهذا لو حصل، لأفقد الحياة وظيفتها العظمى، وأسرارها الكبرى، التي قال عنها سبحانه: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) [الملك: 2].
لكن نفي الجزاء في الحياة الدنيا لا يفيد نفي المعاقبة الإلهية للظالمين أو لبعضهم، فالمقصود أن الحياة الدنيا ليست دارا للجزاء المطلق النهائي، فذلك خاص بالدار الآخرة، ولكنها لا تخلو من الجزاء الجزئي، فقد يُعجل الله جزءا من العقوبة لبعض الظالمين في الدنيا، وقد يُكرم بعض المؤمنين ببعض ثوابهم فيها.
وتبقى القاعدة الشرعية الكلية هي أنك إذا رأيت ظالما يتمدد ظله، فاعلم أن الله لا يُهمِل، لكنه يُمهِل، وإذا رأيت مظلوما لا يُستجاب له، فاعلم أن الإجابة قد قيض الله لها طريقا أخرى، أرقى وأبقى وأنقى، قال تعالى: (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ..) [سورة الرعد: 42].
ثالثا: كما أنه سبحانه وعد بإجابة الدعاء في عدة نصوص، فقد جعل لهذا الدعاء فقها شرعيا لابد من الإحاطة به، وهذا لا يتحقق إلا باستقراء النصوص للوقوف على التقصيد المسدّد، والتأصيل المرشّد، من حيث الوقوف على أمرين مهمين، أولهما متى تكون إجابة الدعاء؟ وثانيهما كيف تكون هذه الإجابة؟ فضبطهما يحل سوء الأفهام، وزلل الأقدام، وضلال الأقلام، خصوصا في صفوف العوام، وبعض المحسوبين على الثقافة والفكر من الأعلام:
– بداية، الدعاء المستجاب يتوقف على تحقق شروطه وآدابه وانتفاء موانعه، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا…، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟” .
– الانتباه الأول، انتباه لزمن الاستجابة، فالدعاء بالخير يتنافى مع الاستعجال في الاجابة، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي” ، زد على ذلك محبة الله للعبد الملحاح، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ اللهَ لَيُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ” ، فهذا الحديث وإن كان في سنده مقال، إلا أن معناه صحيح مليح.
قال المناوي في فيض القدير عن الملح كلاما بديعا رغم طوله: “وهو الملازم لسؤال ربه في جميع حالاته، اللائذ بباب كرم ربه في فاقته ومهماته، لا تقطعه المحن عن الرجوع إليه، ولا النعم عن الإقبال عليه، لأن دعاء المُلح دائم غير منقطع، فهو يسأل ولا يرى إجابة، ثم يسأل ثم يسأل فلا يرى، وهكذا فلا يزال يلح ولا يزال رجاؤه يتزايد، وذلك دلالة على صحة قلبه وصدق عبوديته واستقامة وجهته، فقلب المُلح معلق دائما بمشيئته، واستعماله اللسان في الدعاء عبادة، وانتظار مشيئته للقضاء به عبادة، فهو بين عبادتين سريتين، ووجهتين فاضلتين، فلذلك أحبه الله تعالى، وهذا عام خص منه الخواص في مقام الابتلاء، فمقام التسليم لهم فيه فضل لكونه أدل على قوة أنفسهم ورضاهم بالقضاء…” .
وهذا كله ينم عن ثنائية تربوية قائمة على التواصل الدائم للعبد مع ربه، وهي عدم الاستعجال من جهة العبد، ومحبة الإلحاح من جهة الله، فهما يتساوقان ويتكاملان، لأن عدم الاستعجال يُظهر أدب العبد مع ربه، والإلحاح يُظهر حبّه له وتعلّقه به، فالعبد مطالب بأن يُبطئ عن الشكوى، لكنه يُكثف الرجاء، ومطالب بأن لا يعجل، لكنه لا يملّ من التكرار.
– الانتباه الثاني، انتباه لمواطن الاستجابة وكيفيتها، إذ أهم ما ينبغي التذكير به، هو أن صور استجابة الدعاء قد عددها الشرع، فعدم تحقق ما يرجوه الإنسان من خير الدنيا لا يلزم منه عدم الاستجابة، لأن هناك صورا أخرى تتحقق من خلالها الاستجابة، لكن الإنسان ليس له سبيل إلى معرفتها، فما عليه إلا أن يدعو وهو موقن بالإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: “مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلَا بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السوء مثلها، قال: إذا يكثر؟ قال: الله أكثر” ، بمعنى أن الاستجابة مضمونة، لكن صورتها تختلف، فتخلف ما ظنه العبد خيرا، لا يعني أن الدعاء قد رُدّ، بل قد يكون قد صعد في ساعة قبول، لكنه صُرف إلى وجه أنفع، أو حُفظ لساعة أحوج.
– وخلاصة ما ينبغي قوله هنا، أن الدعاء عبادة، والجهاد طاعة، وهذا لا يعني أن اشتغال العبد بالطاعة، يوجب على الله تحقيق الاستجابة. إن الله تعالى أمرنا بالدعاء لا لأنه لا يعلم حاجاتنا، بل لأنه يحب أن نظهر فقرنا إليه، وأمرنا بالجهاد والطاعات، لا لأنها تُلزم رحمته، بل لأنها مظاهر خضوع نُقدّمها لله، ونرجو بها وجهه، لا لنحتم مقابله.
فتقصيد الدعاء يقتضي القول أن العبد يدعو ربه لأداء وظيفته، أكثر من السعي لتحقيق أمنيته، وتقصيد الجهاد يقتضي القول أن العبد يجاهد ليشهد لله بالولاء، أكثر مما يسعى لصناعة النصر، فإنْ تَحقق المأمول هنا أو هناك، فبفضله، وإن تأخر فلحكمته.
وهذا فيه إشارة لمقصد رباني، وغرض عرفاني، يتمثل في أن الشارع جل وعلا قاصد إلى الاختبار بالأحوال ونقيضها، بالسلم والحرب، وبالنعمة والمصيبة، وبالنصر والهزيمة، وبالفرح والحزن، فتغير الأحوال اختبار للثبات على الدين في النقيضين معا، والحالين معا، أحدهما يستوجب شكرا والآخر صبرا، وإلا إن اقتصرنا على عبادة الرخاء، تحولنا إلى عبادة الحرف التي قال عنها سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ) [سورة الحج: 11.
رابعا: وأخص هذه الفقرة بالتحليل بسبب حديثها عن مصطلح مبارك هو مصطلح الطوفان، والمناسبة إلحاق الطوفان بالطوفان، فطوفان الأقصى المبارك يقتبس شعاعه ونوره وهديره من طوفان نبي الله نوح عليه السلام، فليس في التاريخ لحظات تتكرر، ولكن في التاريخ سنن تعود، وقواعد تسود. ومما يشار إليه في هذا السياق ارتباطا بموضوعنا، هو أهمية النظر إلى طوفان نوح عليه السلام متى حصل؟ ومتى تحقق به النصر؟ لقد تم في وقت متأخر من حياة نبي الله نوح عليه السلام، أي بعد 950 سنة من الدعوة والبلاغ عن الله، يروح ويغدو، يبلغ ويدعو، يتلقى السخرية والتكذيب، و يتعرض للاستهزاء والترهيب، ليس سنة بعد سنة، ولكن قرنا بعد قرن، ومع ذلك لم تنكسر روحه، ولم يضعف صوته، ولم يتراجع عن رسالته.
فلنتأمل طول هذه الفترة التي لا يُتصور القدرة على تحمل مشقتها، حتى إذا بلغ الابتلاء ذروته، وإذا بالمصلح الوحيد بين قومه، يشعر أنه استُنفدت كل وسائل التبليغ والتغيير، والإصلاح والتطهير، فيرفع يديه مستنصرا ربه: (أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) [القمر: 10]، فجاء الرد السماوي: (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ) [القمر: 11]، فالطوفان لم يكن استجابة لدعاء آن، بل كان تتويجا لمسيرة دامت تسعة قرون ونصف.
إن الطوفان لا يولد من رحم التسرع، ولا يكون لحظة واحدة ثم ينتهي، بل هو مدّ يتعاظم، ومشقة تتفاقم، وغضب يتراكم، وحق لا يتقادم، أهله لا يستسلمون، ولا يأبهون للمستسلمين، والمطبعين من المسلمين، فضلا عن المتصهينين، يحدوهم رغم مشقة الطريق، أمل طليق، مبني على إيمان عميق، وفكر دقيق، وعقل حقيق. وبهذا فالمقاومة الطوفانية في الأقصى ليست إلا نداء نوحيًا متجددًا في وجه الظلم والصهيونية بمختلف أجناسها وقبائلها.
خامسا: ومسك الختام، لحسم موضوع النصر الذي لا يناله الأنام، بالتمني ولا بالكلام، ولكن بالعز والإقدام، فذلك تحكمه سنن في الكون بثها سبحانه على الدوام، وسنن في الشرع أيضا طالب بها سبحانه على التمام، يمكن تجميعها في ثلاثة أركان، محال لمن ضيعها أن يُرى له في الميدان مقام، أولاها الأخذ بهما لزام :
الأول والأساس قوة الإيمان، ذلك النور الذي يسكن الجَنان، فيجعله راسخا عند الزلزلة، مطمئنًا عند المحنة، لا يضطرب مع الهزيمة، ولا يغترّ عند الغنيمة، وقود القلب حين تتزاحم الفتن، ومصدر الثبات حين تتكاثر المحن.
وثانيها استفراغ الجهد والوسع، باعتبار أن الواجب الأساس ليس هو التحصيل من القوة ما هو فائق، ولكن السعي الدؤوب الصادق، بكل الجهد إلى تحصيل المستطاع الرائق، فالله لم يكلف بما فوق وسع كل طائق (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [الأنفال: 60].
وثالثها القوة الكافية والعدة الوافية، لملاقاة العدو، والتي من شأنها أن تخيف وتردع، وترهب وتمنع، وتقاوم وتدفع. لكن يبقى التعويل كل التعويل، عند الإعداد والتحصيل، على الركنين الأولين، لأنهما تحت الطاقة، بخلاف الثالث فإنه من الممكن أن يكون فوقها، لأن القوة العسكرية تتطلب إمكانيات لا قبل لأهل فلسطين بها فضلا عن حركات المقاومة.
فطوفان الأقصى لاشك أنه انبنى على الأولين بفاعلية، فأهل الرباط هناك تحقق فيهم الإيمان، واستفراغ الوسع وعمل ما في الإمكان، لكن هل ذلك يعد من الاستعدادات الوافية؟ أم لابد من امتلاك القوة الكافية، لقوة العدو موازية؟ هذا ما يقع فيه الظن، ولا سبيل فيه للقطع، فعلم ذلك عند ربي، لأن النصر بيد الله وحده، صاحب الحكمة في تعجيله أو تأجيله، فلا يُتصوّر أن يُجبر الله على النصر لمجرّد تحقق الشروط، لأن إرادته ومشيئته فوق كل الأسباب، يفعل ما يشاء بحكمة لا يعلم مداها إلا هو (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [آل عمران: 126]، ثم إن النصر ليس محصورًا في صورة واحدة، فقد يتحقق النصر بسبل متعددة، قد لا يأبه بها المتابعون، ولا يلتفت إليها الملاحظون، كانكسار العدو وعدم قدرته على تحقيق الانتصار المبين ، وأحيانا بثبات المؤمنين، وأحيانا بفضح الظالمين.
ولعل الشواهد من التاريخ الإسلامي على موضوع استجماع أسباب النصر وإفضاؤها إليه، أو تخلفها عنه، كثيرة متعددة، وفيرة متشعبة، تحمل أوجها تصل إلى حد التناقض، فما وقع في غزوة بدر من نصر بين، استجمع عناصر النصر، يختلف عن غزوة أحد التي لم يبذل فيها بعض المسلمين الجهد المطلوب لحفظ المخطط الحربي، فضيعوا واجب الوقت آنذاك، وهو ما يحيل إلى الركن الثاني المتعلق باستفراغ الجهد المقدور عليه. كما يختلف أيضا عن سياق غزوة مؤتة، التي كان التفاوت فيها بين الجيشين مهولا من حيث العدد والعدة، مما اضطر خالدا بن الوليد إلى التخطيط للانسحاب، باعتباره الأقرب للصواب، لتفادي وقوع المسلمين في مزيد من الاضطراب، خاصة بعد استشهاد من استخلفهم رسول الله على إمرة الجيش وحصول حالة من الارتياب، ولعل ما وقع يحيل إلى خلل في الركن الثالث، المتمثل في البون الشاسع في القوة العسكرية، بين جيش عرمرم، وجيش ململم، لم يتجاوز قوامه ثلاثة آلاف.
وكل ذلك يختلف عن أحداث أخرى، فرط فيها المسلمون في كل مقومات النصر، وهو ما عاشته الأندلس في آخر أيامها على سبيل التمثيل، حيث ضيعوا كل ما يقوم به النصر من أركان، بدءا وانتهاء بمقوم الإيمان، بسبب الانشغال عن الجهاد بالترف والهوان، والاستعباد للشهوات بإطلاق العنان، ولا شك أن من انفرط فيه عقد الإيمان فلا تسأل عن البيان، عن ما تبقى من الأركان، فهو لها حتما أضيع.
وخير الختام، كلام نبينا العدنان، عليه أزكى الصلاة والسلام: كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، وَأَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ»(مسند الإمام أحمد).