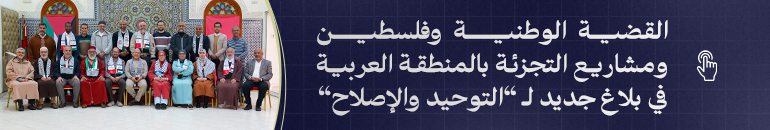ذكرى الإسراء والمعراج في لحظات إستثنائية – شيروان الشميراني

لا أظن بأن يكون الحديث عن الإسراء والمعراج مطابقاً لما يحدث على الأرض بقدر ما هو عليه الآن، في هذه السنة، حيث محاولة الحفاظ على مقام إمامة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- للأنبياء في بيت المقدس جارية بتقديم كل الغالي وكل النفيس من المرابطين على أرض الرباط، والجهاد من أجل الإبقاء على طهارة المكان ونقاوته، هذه الروح المجاهدة التي تسير بسرعة البُراق في سبيل حماية طريق البُراق وحائطه من الهدم والتدمير، فهي الوحدة الروحية التي لم تنقطع بين الحاضر والماضي حيث ليلة الإسراء بعبد الله “محمد” – صلى الله عليه وسلم- في لحظة سمو روحاني وسفر جسماني إلى الله سبحانه، وهو الربط بين حلقات التاريخ المشرقة، الحلقات التي تشكل الأنوار المضيئة أمام الأجيال تدلهم كالأقمار في ظلمات الليل الحالكة بنورها الوهّاجة على الطريق الصائب الموصل إلى الهدف الديني والإنساني.
ليست العيون فقط، ولا التفكير فحسب، وإنما المشاعر والأحاسيس كلها لا تشعر بشيء ولا تحسّ سوى بما يحدث الآن.. هناك، حيث أرض الرباط، هناك.. حيث بيت المقدس..والجهاد عروجاً إلى الله تعالى..ما يجري هو ترجمة لطبيعة الطريق الذي قطعه رسول الله، وتحمل مشاقّه بعده كما فعل – صلى الله عليه وسلم- وهو يقطع المسافة الطويلة من مكة إلى الأقصى ومن هناك إلى السماوات العلى، فإذا كان الإعلان عن إمتلاك ميراث النبوة عبر التاريخ إتخذ من بيت المقدس موضعاً سيراً إليه من المسجد الحرام، فهذا يعني أن المرابطين في بيت المقدس هم من يحافظون على هذا الإعلان من دون القَبول بالعودة إلى الوراء، إلى ما قبل نزول القرآن وإلى ما قبل المعراج النبوي، فهو طريق الوصول الى الله الذي لا يعرف حدّاً يتوقف عنده، والذي بحاجة إلى السير والعروج وبذل الجهد وصرف الطاقة لمنتهاها لحدّ يتوقف فيه العقل البشري عن التفكير ويعجز عن الإستيعاب، جهاد المرابطين الجاري على تلك الأرض المباركة هو التصوير الحقيقي والمشهد المجسد لإسراء ومعراج رسول الله، حيث تقديم الروح والنفس والراحة والمال والأهل والأولاد ثمناً للوصول إلى النقطة التي عرّج منها رسولهم – صلى الله عليه وسلم- وليس بأقل منها.
وربما هذا يفسر أيضاً أجْرَ الرباط، ومكانةَ المرابطين المنصوص عليها في الحديث النبوي الذي أخرجه الطبراني عن الطائفة التي على الدين ظاهرين ولعدوهم قاهرين، إنهم “ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس”، هؤلاء القوم الذين قدّموا من التضحيات ما يعجز الإنسان عن مجرد تخيله، وما يَبْكم أمامه الشعراء والبلغاء الراغبين بوصفه، قدّموا ما جعل البشرية تقف حائرة عاجزة عن تفسيره، هذه التضحية التي هي على غير مثال سابق في التاريخ هي ثمن يقدمه المرابطون على طريق العروج إلى الله.
عندما يتحدث سعيد النورسي – رحمه لله – عن المعراج يصوره كطريق التزلّف إلى الله سبحانه، فالله الذي هو “أقرب إلى كل شيء من كلّ شيء، يكون الإنسان أبعد إليه من كل شيء”، لكنّ الإنسان مأمورٌ بحكم العبودية أن يكون قريباً من الله ويعمل على ذلك، والتقرُّب إليه بحاجة إلى سلك الطريق الصّعب وبذل الجهد وتَحَمُّل المتاعب، “ومن هذا تفهم: سرّ المسافة الطويلة جدّاً في المعراج مع عدم وجود المسافة التي تعبر عنها الآية الكريمة:)وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدْ( [ ق: 16]، وكذا ينبع من هذا السرّ: ذهاب الرسول – صلى الله عليه وسلم- وطيّه مسافة طويلة جداّ ومجيئه في آن واحد إلى موضعه”(1). المعراج هو طيّ المسافة الطويلة جداً في رحلة الحياة المعنوية، هذه الرحلة التي غادر من أجلها رسول الله مكة لتبدأ من المسجد الأقصى وليس من الكعبة المشرفة، إنها تعني فيما تعني إن التقرب إلى الله يكون بقطع الإنسان المسلم المسافة الفاصلة عن المسجد الأقصى وليقدم كل ما يلزم في سبيل الوصول إليه، وفي هذا السياق وأسوة برسول الله تأتي في هذه اللحظات التاريخية الصلاة داخل الأنفاق وحلقاتُ القرآن في دهاليزها وإعداد زاد الطريق لقطع تلك المسافة أو طيّها بأمر الله كما فعل هو – عليه الصلاة والسلام-، و حَصْد كل ما و “كل من” يقف في الطريق معرقِلاً ومعارِضاً، سيراً إلى الله وعروجاً إليه، وهو فوق كل مستويات التفكير ولا يقبل الركون الى راحة الأهل ومتعة المال. وإن لم يكن ذلك ممكنا من فوق الأرض فليكن السير نحو العروج من تحت الأرض، فرسول الله لم يمش على الأرض بل طارت به البراق في سرعة البرق، وفي سبيل الوصول إلى المسجد الأقصى لتتوقف كل موازين البشر إن كان لازماً، ولتتغير القوانين المعهودة وتنقلب. يقول سيد قطب :” والذين يدركون شيئا من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغربون في الواقعية شيئا، فأمام القدرة الإلهية تتساوى جميع الأعمال التي تبدو في نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة ، حسب ما اعتاده وما رآه، والمعتاد المرئي في عالم البشر ليس هو الحكم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة الله”(2). وعندما يتوكل المرء على الله القدير ويفي بكل ما هو واجب عليه من الإعداد يظهر منه ما لا يستطيع المحرومون من نور الله رؤيته.
ورد في السيرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلّم – رافقه جبريل على البراق في رحلة الإسراء لتسليمه ميراث النبوة والإمامة في المسجد الأقصى، وجبريل من الملائكة، ومصاحبة الملائكة بحاجة إلى درجة عالية من الصفاء الروحي، يدلّ على ذلك الحديث الذي يرويه – مسلم- حيث أن الصحابي حنظلة بن ربيع قال عن نفسه: نافق حنظلة، والسبب هو تغيّر في الحالة الروحية السامية بين أوقات الحضور في مجلس النبي، ومغادرته، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذِّكْر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طُرُقِكُمْ، لكن يا حنظلة ساعة وساعة» بمعنى أن من يريد السير إلى المسجد الأقصى ” محَرّراً” لإستكمال طريق النبوة، لابد له من صفاء روحي عالي جداً، يكون في مستوى نزول الملائكة مَدداً من الله جنداً مسوَّمين، وإن التربية الرّوحية التي يحمل صاحبُها القرآنَ في صدره بصدق، من موجبات النجاح في ذلك السير.
***
(1) النورسي، المكتوبات، 483.
(2) في ظلال القرآن، م/ 4، 518 .