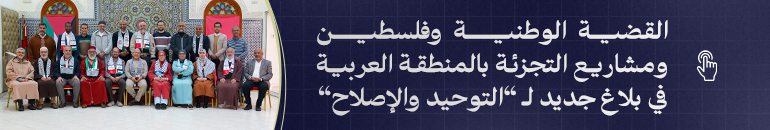من وحي الجائحة – بنداود رضواني

ضمد أحزانك بالثقة في الله
حين تثق في الله جلَّ جلاله فأدرك أنه لن يعاملكَ إلا برحمته، ولن يبسط لكَ في دنياك إلا ما فيه خيرك و فلاحك..
انظر في البيان الإلهي و أثر الثقة بالله في زمرة من الناس، حين قالوا: ( وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ )، البقرة/12.
إنها ثقة لا يشوبها شك… وطمأنينة لا يخالطها قلقَ…
فمن أين أتتهم هذه الثقة في الله عز وجل ؟
أتتهم من مصدر أوحد لا ثاني له، جاءتهم من عميق الإيمان بخالقهم، والثقة في قدرته وتصرفاته جل جلاله….
فلم الأحزان – إذن -، ولم القلق…؟ وضماد جراح الإبتلاءات كامن في الثقة في الحكمة الربانية، ودواء الشدائد مبثوث في الوثوق بالتدبير الإلهي…..
( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ )، التين/8.
(أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ )، الزمر/36.
( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )، البقرة/185.
إن إيمان العبد بربه يجعله دائم الرضا بما قضى الله له، مستسلم لما قدر عليه، مدرك أنه لا يجري سبحانه هذه الأسقام والأوبئة عبثا…، لذا فالمؤمن لا ينكسر أمام الأحزان ولا يضعف أمام القلق والأوهام، ولا يعني ذلك بأية حال أنه يتواكل في مدافعة قَدَر البلاء والأسقام بقَدَر التعافي والسلامة..
دنياك مهما كانت تظل ناقصة !.
الدنيا ظل زائل، ومتاع باطل…
يقول سبحانه:
(الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا”)، الكهف/46.
(إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ )،غافر/39.
(وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا )، الكهف/45.
لكن لماذا ينزع الإنسان إلى شهوات الدنيا ولذائذها…، رغم هذه القوارع القرآنية !؟
ولم يظل مشدودا إلى بريقها ومتعها…!!!؟، مع أن ” محب الدنيا لا ينفك من ثلاث: همّ لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي “. إغاثة اللهفان/ إبن القيم.
ومهما عَظُم متاع الدنيا فعاقبته حزن لا محالة، إما بذهابه عن المرء وإما بذهاب المرء عنه، إلا العمل لله جل جلاله.
فهل من عُقار لداء التعلق بالدنيا ؟ هل هناك علاج يضعف الدنيا في عقل الإنسان وقلبه حتى يراها فعلا كما صورها الله سبحانه وتعالى ؟
الجواب هو أن ما من سبيل يفضي إلى تعريف الذات بضعفها وعجزها، لا شك أنه سيحفظ هذا القلب من التعلق بأستار الدنيا، ويقيه من الولع بمفاتنها….، وما الوباء الذي يطوقنا اليوم إلا واحدا من السبل التي تنبه الإنسان إلى هذه الحقيقة.
إن الأسقام والأوبئة التي تقعد في طريق الإنسانية، ما هي إلا نافذة نطل منه خلالها على النهاية التي تنتظرنا، وفجوة نبصر عبرها الموت الذي يتربص بنا…
ومهما صور القرآن وحديث النبوة وكلام المذكرين تفاهة الدنيا، ومادام الإنسان يقابل ذلك بالمزيد من الإعراض، فلا بد أن يظل مشدوداً إلى الدنيا بكل ما فيها…
لكن متى نظر ابن آدم ببصيرته إلى الموت الذي ينتظره ويتربص به، ورأى تجسيد ذلك في الذين سبقوه، فإنه يحوز بذلك الترياق الذي يجعله يستصغر الدنيا وينظر إليها وهي فعلا تافهة كما بين سبحانه وتعالى.
لقد أبانت جائحة كورونا عن حقيقة هذه الدنيا التي تهافت الناس عليها وتنافسوا وتصارعوا من أجلها – ولا زالوا – وَأُشْرِبت نفوسهم حبها والركون إليها، وانتشرت إثر ذلك الأمراض القلبية من حسد، وحقد، وكذب، وبغضاء، وشحناء….
ومع كل ذلك، فالدنيا مهما ازينت وأبرقت في أعيننا ستظل ناقصة وتافهة ما دامت الأوبئة والرزايا تتربص بنا، وما بقي الموت فيها ينتظرنا…!!
(يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ )، غافر/39.
ادفع الأوهام بالضراعة إلى الله
ثمة أفكار مقلقة وأوهام تقض المضاجع، غدت معها أيام الحجر الصحي – عند البعض – عذابا وجحيما…
فالخوف المرضي من وقوع نقمة أو زوال نعمة في القادم من الأيام قد يفضى إلى اضطراب نفسي وقلق عصبي، ويمكن وسم هذا الحالة المرضية ب ” فوبيا المستقبل “.
ولقد وجدت رياح أخبار الوباء وأرقام ضحاياه فرصة لبعثرت نمط العيش لبعض الناس، وزيادة في الأوهام وتضخيما للوساوس عند نفر آخر يعاني ابتداء من مشاكل نفسية واجتماعية.
ومما لاشك فيه أن المرء إذا سلم رقبته لأوهام ووساوس الإفلاس والفشل والموت والفقر….!!! مات غما وهماً، وإذا تحرر منها نال سكينة وأمنا..
فمن دروس الحياة، أن الأوهام مهما أرقت الإنسان وقضّت مضجعه وأزعجته، فستتلاشى حتما متى زاحمها اليقين الإيماني بالله تعالى…، لكن إذا وجدت فقرا روحيا تكاثرت وازدادت إلى أن ترمي به بين مخالب الضياع…، وإن الأقدار مهما قست عليه – في ما يبدو – فلن يجد أبر به وأحنى عليه من خالقه جل جلاله. فلم تحبطنا الأوهام – إذن – ؟ وربنا يقول: هو علي هيّن.
لقد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما أنزل الله داءً إلى وأنزل لهُ دواءً إلا السام أي الموت”، فكذلكم الأدواء السلوكية و النفسية..
فما من بلية يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عبداً له إلا وإلى جانبها الدواء الذي ينجيه من وقعها الأليم..
فما هو عُقار هذه الأوهام والظنون التي تكبل اليوم العديد من المحجورين ؟
اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء هو العُقار
إنه العلاج الأول الذي يقي الإنسان من شرور الأسقام النفسية ونتائجها لكن الإنسانية اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم في شغل شاغل عن استعمال هذا الدواء.
لقد شاء حكمة الله أن يخلق الإنسان ضعيفا بقدرات وإمكانات محدودة، في المقابل نجد ألوانا من البلايا والرزايا والأمراض تطوف به مدى حياته، فإذا ركن الإنسان إلى ذاته في مواجهتها شعر بالتخاذل والخيبة لا محالة، لكن إذا انقدحت في فؤاده مشاعر الحاجة إلى ربه، وشعر بأنه بأمس الحاجة أن يمد يده بالضراعة إليه، آنذاك يكون قد فقه المقصد من تسلط الأمراض والأوهام والوساوس عليه، وأدرك الأسرار الكامنة في الأمر بالفرار إلى سيده ومولاه ..يقول الله جل جلاله ( فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ). (الذاريات)