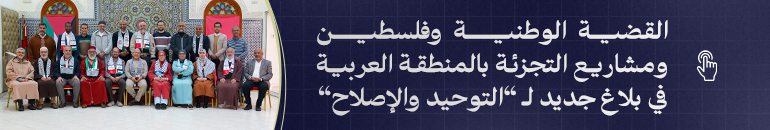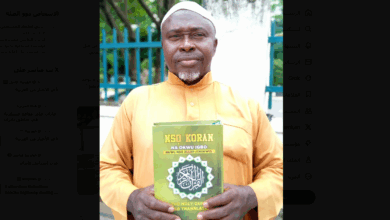مواقف الثبات في سيرة المصطفى: دروس في الصمود واليقين – سحر الخطيب

يا من حمل النبوة في قلبه قبل أن يحملها في يديه، يا من كانت خطواته على الأرض صلاة، وصمته ذكرا، وحديثه حكمة.
لقد كان ثبات رسول الله نبعا لا ينضب من الطمأنينة، شجرة إلهية أصلها ثابت في أعماق اليقين، وفرعها يمتد في سماء الرسالة. لم يكن جمودا، بل كان نهرا متدفقا من الإيمان، يحول الصعاب إلى معابر، والألم إلى عزيمة.
لنتأمل معا ذلك القلب الكبير، يخرج من الطائف حزينا طريدا، ترميه الحجارة حتى تدمى قدماه، فيرفع كفيه إلى السماء بدعاء يذوب رقة: ” اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس..”
ثم لا يزيد على ذلك إلا رجاء في قوم آذوه: “عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا”… أي ثبات هذا الذي يحول الألم إلى أمل، والجرح إلى جرأة؟!
لنتأمله في الغار، وهو يهمس لصاحبه: “لا تحزن إن الله معنا”.
كلمات تخرج من قلب امتلأ يقينا كأنه يقول للخوف: “ليس في روحي متسع لك، فقد شغلها الإيمان”.
وحين يقف على قبر أمه آمنة، تفيض عيناه، لم يكن بكاؤه ضعفا، بل كان ثبات الإنسانية في أصدق لحظاتها، ثبات القلب الذي لا يتجمد أمام الفقد، بل يذوب رحمة وحنينا. كان ثباته صلى الله عليه وسلم كالشمس تشرق من وراء الغيوم، لا تعرف الانكسار، ولا تعترف بالغياب، تصنع من الظلام فجرا، ومن اليأس بصيرة. علمنا أن الثبات ليس أن تكون صخرة لا تشعر، بل أن تشعر بالألم كله، ثم تختار الرحمة. ليس أن لا تخاف، بل أن يكون إيمانك أكبر من خوفك. ليس أن لا تبكي، بل أن يكون دمعك طهرا لا انكسارا. فهيا نمش على دربه. لنثبت كما ثبت. بقلوب تفيض يقينا، وأرواح تتوق إلى السماء، وأقدام لا تعرف غير السير إلى الله.
فالثبات اختيار يومي.. أن نختار المحبة في وجه الكراهية، والرحمة في زمن القسوة، واليقين في عالم الشكوك.
فحقا، إن في سيرته لذكرى للعالمين لمن كان له قلب يعيش، أو لديه روح تتوق إلى النور.
بالتأكيد كان الثبات سمة أساسية من سمات حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجلى في أبهى صوره في أشد المواقف صعوبة وتحديا. لم يكن ثباته مجرد صبر سلبي، بل كان ثباتا إيجابيا قائما على اليقين بالله، والحكمة، والعزيمة التي لا تلين. فهلا تناولنا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم من عدة زوايا:
1 – الثبات على المبدأ والدعوة (الثبات الفكري والعقدي)
منذ بدء الوحي في غار حراء، واجه النبي صلى الله عليه وسلم أعتى أنواع المعارضة: السخرية، والتكذيب، والإغراء بالمال والسلطة، ثم التعذيب الجسدي والنفسي، ثم الحصار الاقتصادي والاجتماعي.
واجه الإغراءات بقلب يرفض أن تباع الحقيقة في سوق المصالح، وبصوت لا يخشى إلا الله.. وقف النبي يحاصرهم بيقينه، كانت عروضهم ذهبا وسلطانا، وكان رده نورا وضياء: “والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه”. كلمات تثقل بالمعنى، كأن الكواكب تحط على أكتافه فلا يميل! لقد عرضوا عليه العالم، أفصح لهم عن روحه وقضيته.. وعلم العالم كله أن الوعد إذا خرج من قلب يناجي السماء.. لن تستطيع الدنيا جميعا أن تسحبه إلى الأرض.
أما تحمله للأذى.. فقد كان سحابا يمر على جبل صبره فلا يحركه: رأيناه وهو يصلي وسلى الشاة على ظهره الطاهر لم ينثن، لم يغضب لنفسه. بل زادته الهواجر صلابة ووداعة.
وفي شعب أبي طالب، حيث الحصار والجوع والوحدة.. كان يبني بصمته أمة، يربي القلوب على أن الحرية لا تبتاع برغيف،
وأن العقيدة لا تسقط جوعا. لقد صنع الثبات من ألمه نورا، ومن صبره قوة تسري في عروق الأمة إلى يومنا هذا ليقول لكل داعية وكل حامل لراية الحق:
“لن تخسر شيئا حقيقيا إذا ربطت قلبك بالله، فالذي أمسك القمر بيمينه والشمس بيساره، هو السند الذي لا ينكسر”.
إن حصار الشعب كان محنة تكشف معدن القلوب: ثلاث سنوات كاملات، كانت درسا إلهيا عمقه كعمق الإيمان نفسه. لم يكن الحصار أثقالا من الحجارة. بل كان حواجز من العزلة والجوع والخوف.. لكنه في الحقيقة، كان رحمة تتربع في ثياب البلاء. لم يكن الحصار إلا خوف القلوب العطشى من نور الحق، خوف الجبابرة من صوت الضعفاء إذا قرأوا: “قل هو الله أحد”.
في ظل هذا الحصار، ولدت مواقف كالنجوم: أبو طالب، يقف كالجبل يظلل الرسالة بجسده. خديجة، تبيع حليها لتشتري به زادا للبطون الجائعة وبعض القلوب في قريش لم تستطع مقاومة الإنسانية فكانوا يمررون الطعام سرا، كأنهم يرمون شرارة أمل في ليل طويل.
تعلمنا من هذا الحصار اليوم في غزة أن الحق لا يباع بالرغيف وإن فرض التجويع. أن الوحدة في البلاء، تحول العزلة إلى جماعة، أن الصبر ليس انهيارا، بل بناء في الخفاء. أن النور القليل يكفي لكسر ظلمة ألف سنة. لنتذكر أن أصحاب الشعب خرجوا من حصار ثلاث سنين ليفتحوا بإيمانهم دنيا كاملة. لنعلم أن كل حصار، ليس إلا مفتاحا لفتح قادم، إن صبرنا وثبتنا كما ثبتوا.
2 – الثبات في مواجهة الشدائد (الثبات النفسي والجسدي)
يا للعزيمة التي تنبت من صميم الألم. ويا للثبات الذي يصنع من الجراح معالم! أما ثباته في الطائف: خرج صلى الله عليه وسلم يحمل نور الرسالة بين الجبال في صحراء الجفاء، فقوبل بالحجارة ودم يسيل من قدميه الكريمتين، وقلب يرفع أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماء: “اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس”. لحظة تذوب فيها العظمة بدمعة العبودية ليست ضعفا، بل قوة المستكين بين يدي القوي، ثم تأتي المعجزة الأكبر:
ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فيقول الرحمة المتجسدة: “بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده”. أية روح هذه التي ترميها الحجارة فترد بالرجاء والاستشفاع لقاذفيها بالحجارة؟!
وأما في أحد: حينما انكشف الصف. وشج جبين النبوة. وكسرت رباعية الذي قال: “أنا نبي الرحمة” وسادت الهزيمة.
وانتشرت شائعة “قتل محمد” إذا بالصوت الذي لا يموت يعلو: “إلي عباد الله.. إلي عباد الله”. لم يكن يندب جرحه. ولم يكن يلوم أحدا. كان يجمع شتات القلوب بكلمة. كان يبني من الكسر أمة.
في الطائف، علمنا صلى الله عليه وسلم أن الثبات رحمة تسبق الانتقام. وفي أحد: علمنا أن القائد الحقيقي لا يسقط مع أول دمعة. بل يكون سندا حتى وهو ينزف. لقد كان ثباته ﷺ نبعا من يقين، ونورا يسري في ظلمات المحن. فالثبات إذن ليس عنادا. بل هو اتكال على من له الجبروت والكمال. وهو اليقين بأن الغيمة لن تدوم، وأن وراء كل أحد فتحا، ووراء كل طائف رحمة تنزل من السماء.
3 – الثبات العاطفي والقلبي (الثبات مع الله)
يا له من سر عظيم، سر الثبات الذي لا تهزه الرياح! لم يكن ملجأ النبي ﷺ حصنا من حجارة، ولا سلاحا من حديد. إنما كان ملاذه مناجاة بينه وبين رب السماوات.
أما توكله صلى الله عليه وسلم في الهجرة: حين كانت قريش تتعقب أثره بالذهب والسلاح، وكان الموت ينتظره خارج الغار.. إذا بصوت الطمأنينة يهزأ بالخطر: “لا تحزن إن الله معنا «كلمات كأنها نسمات الفجر في قلب الليل. لم يقل: “الله سينجينا” فحسب. بل قال صلى الله عليه وسلم: “إن الله معنا”، فالمعية نصر قبل النصر، وأمان قبل الخلاص!
وأما صبره على الفقد: فقد مر على قلبه صلى الله عليه وسلم رحيل تلو رحيل كالأعاصير: رحيل خديجة، القلب الذي احتمى به والحضن الذي آواه و آزره. رحيل أبي طالب، السند الذي كان يظلل الرسالة. رحيل فلذات كبده، واحد تلو الآخر. لقد كان يستقبل الفقد كما تستقبل الأرض نزول المطر، بصمت يعرف أن وراء الغيث نباتا جديدا.
لم يقل: “لماذا؟” بل قال صلى الله عليه وسلم: “إنا لله وإنا إليه راجعون.” فكان فقد الأحبة زادا لرحلة اليقين.
لقد كان اتصاله بالله هو الحبل الذي لا ينقطع يقوم الليل حتى تنفطر قدماه، ليس هروبا من الدنيا، بل ليملأ قلبه بما يكفيه لحمل هموم العالمين. ليوصل لنا رسالة مفادها أن السلاح الأقوى أن ترفع كفيك وأنت في قعر الغار. وأن الصبر ليس نسيانا للفقد. بل هو استشفاف للوجود الأعظم خلف كل رحيل، وكل فقد سيكون جسرا إلى لقاء أجمل عند من لا يفوته شيء.
4 – الثبات في العهد والوفاء (الثبات الأخلاقي).
يا له من ثبات يبني بالوفاء صرحا أشمخ من الجبال، ثبات لا تزعزعه المصالح! فقد وقع صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية بشروط تثقل على النفوس، شروط تظهر للعيون أنها إجحاف، ولكن بصيرته رأت فيها نور الفتح المبين. لم يقل: “الغاية تبرر الوسيلة”.
بل قال: “الوفاء نصف الإيمان”، فكان قلم الوفاء أقوى من ألف سيف، يكتب به نصرة لم تكتبها السيوف! فهذا كان ثباته في صلح الحديبية، وأما عفوه يوم الفتح، فقد دخل مكة وقد سال من أجلها دم الأحبة، وتذكر عشرين سنة من الأذى، لكنه لما أمسك بمفتاح القوة، لم يفتح به باب الانتقام، بل أرسل صرخة العفو التي هزت أركان التاريخ:
“اذهبوا فأنتم الطلقاء”
لم يكن عفوا من موقف ضعف، بل كان نصرة القوي الذي لا يخشى إلا الله، نصرة الروح على الغضب، ونصرة الإنسانية على الحقد. لقد علمنا أن الثبات الأخلاقي هو أصعب أنواع الثبات. فالعاصفة قد تنتهي، والغضب قد ينطفأ، ولكن الوفاء والعفو يبقيان نبضا في قلب الأمة. فاليوم، حين تتزعزع العهود، يبقى هذا الدرس النبوي ينادينا: “إنما البقاء لما يرضي الله.. ليس لما تحققه المكاسب العاجلة”. فلنثبت على الوفاء حتى وإن غدر الغادرون. ولنثبت على العفو حتى وإن أساء المسيئون. فهذا هو الفتح الأعظم: فتح القلوب بالرحمة، وبناء العلاقات بالوفاء.
بقلم الإيمان وحبر الوعي، نقف بين موقفين يفصل بينهما أربعة عشرة قرنا، ويجمعهما نفس السماء، ونفس الوعد، ونفس السلوك.
ها هم في غزة، يرمون بقنابل تهز الأرض والسماء، وتبقى الجباه ساجدة..
وها هم في غزة، يأكلون العشب والطين، ويموتون من الحصار و التجويع ولكن صيحة “الله أكبر” تعبر الحدود.
وها هم في غزة، يفقدون الأب والأم والولد في لحظة واحدة، بل تمحى عدة أجيال لنفس الأسرة في آن واحد، ويقولون: “إنا لله وإنا إليه راجعون”..
وها هم في غزة، يقولونها وهم بين الرفات والأشلاء: “حسبنا الله ونعم الوكيل”
وها هم في غزة، يعتنون بالرهائن ويحمونهم بما يتاح لهم، على نهج القائد الأعلى عليه السلام في التعامل مع الأسرى.
وها هم في غزة، يقولون للعالم:
“سنبني بيوتنا من جديد.. ولا نريد إلا العدل والحق”..
لقد صارت غزة محرابا لثبات نبوي جديد: ليس بطولتهم في أنهم يقتلون، بل في أنهم لا يموت فيهم الإنسان، رغم أن الموت والنزوح والتجويع والتعذيب يصب عليهم صبا ويعتصرهم عصرا ويمزقهم إربا.
فالنبي ﷺ كان يثبت ليقيم دين الله.
وأهل غزة يثبتون ليقولوا للعالم:
“إن هذا الدين لم يمت “، وإن القلب الذي ينبض ب “الله أكبر “لا تقتله الصواريخ و لا تنال منه المسيرات و لا المدرعات و لا المفخخات. ليس الثبات فقط أن نحمي الأرض، بل أن نحمي الإنسان فينا، ونحرس سلطان الإيمان في قلوبنا وأن نرفع سطوة الحق فوق رغبات الانتقام.
إن الثبات الذي يجسد حقا أشد أنواع الثبات على الإنسان هو الثبات على المفاهيم، وعدم تغييرها حسب الأهواء والمصالح!
كما جاء في الحديث النبوي الشريف: “يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه، كالقابض على الجمر.” رواه الترمذي
ومن ذا الذي يثبت قابضا على الجمر؟! لذلك بشر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن الثابت من أولئك له أجر خمسين من الصحابة، وقال:
“إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، أجر خمسين منكم”.
سلسلة الأحاديث الصحيحة
فالثبات اليوم على أصول الدين وقيمه ليس مثله كالثبات في زمن الفتوحات!
إنما هو كالقابض على جمرة من نار، تحرق كفه، ولكنها تنير دربه. تؤلم جسده، ولكنها تطهر روحه.
فإنهم أصحاب البشرى بأجر خمسين صحابيا لأنهم يحملون الراية وحيدين في وقت تخذل فيه الرايات!
فللقابضين على الجمر في زمن الخذلان. ولمن يحملون دين الله في زمن يريد أن يجعل الإسلام أغنية في حلبة الأهواء!
ألا إن الجمر إذا مر باليد أحرقها، وإذا مر بالقلب أضاء فيه مصباح اليقين!
في هذا العصر، هناك مظاهر للثبات، إن تم التمسك بها، كان المؤمن قادرا على المواجهة وعلى الممانعة. اليوم، صار ارتكاب الكبائر ممارسة “حريات شخصية”. والمسلم الثابت يقف كالجبل يعلم أن الحرية الحقيقة هي أن يحرر نفسه من أسر الشهوات لا أن تستعبده! فللواقفين بشاطئ الحق في طغيان البحر، هذه صيحة الثبات تعبر أمواج الغرور! اليوم صار المنكر متخلفا، والعاصي متحضرا! والمسلم الثابت يقف كالجبل، ليس بقسوة الحجر بل بصلابة اليقين! يعلم أن الحرية الحقيقة ليست في أن يفعل ما يشاء بل في أن لا يفعل ما يسخره لشهواته .
فيصبح عبدا لما يظن أنه سيد له! لقد أصبح الثابت اليوم غريبا، يحاصر بأنواع من الفتن: فتنة التطبع.. حيث يسمى العصيان “انفتاحا”، وفتنة التنازل.. حيث يسمى الانحراف “تقدما”، وفتنة الخنوع.. حيث يسمى الثبات “تطرفا”.
لكنه يثبت لأنه يعلم سرا لا يدركه مدعو التحرر: أن الحرية الحقيقية هي أن تملك زمام نفسك لا أن تكون أداة في يد شهواتك! فإذا رأيت نفسك تضعف، تذكر أن الجبل لا يهزه هبوب الرياح وأن العقول الكبيرة لا تستعبدها اللذات الصغيرة.
وأن القلوب الكبيرة لا تسكنها الهواجس التافهة!
فالثبات، الثبات.. لنكون من الذين قال فيهم ربهم:
“رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا” (سورة الأحزاب، الآية 22)
فالحرية ليست في كثرة الخيارات بل في صحة الاختيار وليست في انعدام القيود بل في حسن اختيار القيود التي ترضي الرحمن.
أما الحجاب كمظهر من مظاهر الثبات، فقد صار في أعين الجاهلية قيدا وهو في حقيقته تاج. يا له من اختبار، أن ترفض امرأة أن تكون سلعة في سوق العري والخلاعة. فيقولون: “قيدت حريتها”! أية حرية هذه التي تبيع الكرامة بالتقاط الأنظار؟! الحجاب ثورة صامتة ضد ثقافة التبضيع. هو صرخة المرأة في وجه العالم: “إنني لست جسدا.. إنني روح وعقل وقيم”!.
في زمن انحدار المرأة إلى شيء للاشتهاء، يصبح الحجاب إعلان تمرد على ثقافة العري ورفضا قاطعا لأن تكون المرأة وسيلة للتسلية. فالحجاب ليس غطاء للرأس فحسب، بل هو توقيع الكرامة على جبين الحياء، تاج العزة، ورمز الستر والعفاف والحفظ من الألاعيب المحاكة والوعود الكاذبة والأوهام الملغومة. الحجاب ثبات في زمن شقت فيه الطاعة لكثرة وخبث ما يبث وما ينشر من تضليل وتعتيم وتلبيس.
يبرز مظهر من مظاهر الثبات أيضا في مقاطعة داعمي الاحتلال، المقاطعة التي لا تعد موقفا سياسيا أو إقتصاديا أو ثقافيا فحسب، بل هي صوت الضمير الإنساني الذي يرفض أن يكون شريكا في الظلم. ليست البطولة هنا في ترك شراء بضاعة، بل في إصدار حكم القلب على كل من يرفض كرامة الإنسان. إنها وقفة العباد الذين يعلمون أن الميزان الأعظم يوم القيامة ليس ميزان الذهب والفضة، بل ميزان القلب والسماع والطاعة.
فعندما يقال : “وماذا ستغير قطعة الجبن التي لم تشترها؟”، فإنك لا ترد بحساب الأرقام والأرباح، بل بلغة اليقين التي تعلم أن كل فعل وقول مدون: “إني أريد أن أسجل في سجل السماء، أني لم أكن شريكا لظالم”. لقد أصبحت المقاطعة لغة أخلاقية في عالم يفقد الأخلاق. إنها رسالة من المستضعفين إلى سدة القوة: “إن قوتكم لن تجعلنا نبارك ظلمكم”. إنها إحياء لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدوات العصر.
فلا تستصغرن من المعروف شيئا، فقد تكون البضاعة التي ترفض شراءها، والخدمة التي لا تريد الانتفاع بها هي الفاصل بين كلمة حق تقال، وصمت عن الباطل يمارس. وتذكر أن الأمم لا تبنى بالهتافات فحسب، بل بالإرادات الفريدة التي ترفض أن تكون في صف الظالمين.
لقد وعد الرسول ﷺ أن للثابتين في هذا الزمان أجر خمسين من صحابته لأن الصحابة كانوا يقاتلون مع الجموع والقابض على الجمر اليوم يقاتل وحيدا بينما الجموع كلها تقاتل دينه!
فالثبات، الثبات، لأن الملائكة في السماء تتعجب من هذا الثابت وتكتب في ديوان الأبطال: “هذا امرؤ لم تزعزعه العواصف”. فإذا رأيت نفسك تضعف.. تذكر أن الجمر إذا أمسكت به سيضيء دربك وسيحميك من أن تقع أسير الهوى..
فالصبر الصبر، فإن بين العبد المؤمن الثابت وبين الجنة إما قبضة من جمر وإما لذة ساعة ولعمر الله.. إن الجمر أهون!
الثبات على المبدأ هو النور الذي لا ينطفئ، إنه ليس مجرد موقف عابر.. بل هو النهر الجاري الذي لا يغير مجراه مع كل منعطف،
فالأقدام التي تسير على درب الحق لا تعرف المساومة، والأرواح التي تشرب من معين اليقين لا تقبل أنصاف الحلول. يحتاج الثبات إلى نسيج لا يتمزق يشد بعضه بعضا عبر صبر جماعي، فيا لجمال القلوب التي تتناغم في محنة واحدة!
ليس الصبر الفردي كالصبر الجماعي: فالأول قد يخور، أما الثاني فيصبح قصة تروى على ألسنة الأجيال.
ونموذج فلسطين وغزة ماثل أمامنا، إنه البناء المتين الذي تقف فيه كل روح سندا لأختها، فيصنعون من الشدة منارة تضيء للأمة طريقها.
لا يتأتى ذلك إلا باللجوء إلى الله، الملاذ الذي لا يخيب، عندما تعجز الحيل، وتنقطع السبل، وتتكدس الغيوم، يظل باب السماء مفتوحا للقلوب الواثقة. إنه الحبل المتين الذي لا ينقطع، والملجأ الذي لا تهزه العواصف، فلا عجز مع الدعاء، ولا ضعف مع الالتجاء، ولا خوف مع الاتصال بالله. سر الثبات الخالد هو اليقين بالله، ذلك الوقود الإلهي الذي يضيء الطريق في أحلك اللحظات. إنه النظر إلى ما وراء الأسباب، والوثوق بوعد الله عندما تنقضي كل الوعود.
ولا يتأتى الثبات أيضا إلا بامتلاك الرؤية الواضحة: البوصلة التي لا تضل، أن يعلم المؤمن أن لوجوده سرا عظيما،
لم يكن مخطوطا في صحائف الوجود ليأكل ويشرب ويمضي! كان يقرأ آية الخلق: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” سورة الذاريات، الآية 56.
فصارت هذه الآية نور دربه وسر ثباته. لم يتحير بين الأهواء. ولم يضل بين الأفكار، لأنه كان يعلم من أين.. وإلى أين.. ولماذا! ثم أنه لم يكن وحده أبدا. كان له عدة القلب التي لا تنضب:
الوحي يمده بالبشارة عند الضيق. والصبر يتساقط عليه كالمطر عند الحاجة. يعلم أن القوة ليست في كثرة الأتباع ولا في عدد السلاح بل في اتصال القلب بمن له ملك السماوات والأرض.
ثم أن الثبات يتطلب دعما بشريا وصحبة صالحة كما جسدته الأيدي التي تحمل الرسالة، لم تكن رحلته ﷺ وحيدا في صحراء الجهالة. كان معه الصديق أبو بكر الذي لم يتردد مقدار أنملة في دعمه ﷺ، وقوة عمر الذي أضاء بالعدل ظلمات العالم. وغيرهما من الصحابة الكثير. لقد كانوا المرآة التي ترى فيها الرسالة جمالها والسند الذي تستند إليه وقت العواصف.
إن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج العملي الذي جسد قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون} [آل عمران: 200]. هذا الثبات هو الذي حفظ الدعوة الإسلامية في مهدها، وهو الدرس الخالد للأمة في كل زمان ومكان لمواجهة التحديات والفتن بالحكمة واليقين والعزيمة الراسخة.
فإذا أردت أن تثبت كما ثبت ﷺ .
فاعرف لماذا ولدت.
واغرس قلبك في رضا ربك.
وابحث عن أصدقاء الدرب الذين يسحبونك إلى الجنة.
لا إلى الهوى!
إنه درب الأنبياء.
ليس سهلا. ولكنه يستحق أن تبذل فيه الروح!
اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم: ﴿ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا﴾.(سورة البقرة، الآية 250)