حول التراث المائي في حضارتنا الإسلامية – الحبيب عكي
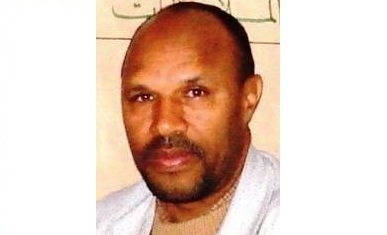
كثيرا ما يتساءل المرء كيف بوضعنا المائي أصبح اليوم يشكو من عدة اختلالات واعتلالات لم تكن يوما في تراثنا المائي الحضاري الإسلامي؟ وهو المعروف بكونه دبر المسألة المائية عقائديا وثقافيا.. سلوكيا وميدانيا.. قوانين وأعراف.. سقوية وخدماتية.. ترفيهية وجمالية بشكل غير مسبوق عبر غيرها من الحضارات؟ ثم يتساءل المرء الحصيف بعدها هل استلهام هذا التراث اليوم يمكن أن يكون له دور أي دور في معالجة اختلالاتنا المائية المعاصرة؟ أم أن الأمر مناخي طبيعي يغزو طيف مخاطره كل العالم وتتجاوز أضراره القدرية كل المعتقدات والثقافات والقوانين والسلوكات السليمة منها والمنحرفة كائنة مرجعيتها مهما تكن؟
أولا، كيف كان التراث المائي في الحضارة الإسلامية؟ ما هي ملامحه وإرثه الحضاري الخالد؟ ما موارده المائية وكيف كان يعبئها.. ما امتداد هذا التراث على مختلف الشرائح والكائنات.. كيف كان يحكم مختلف الاستعمالات؟ ما تدخلاته حتى عند الكوارث والأوبئة كالجفاف والفيضانات؟.
فأولا، كان المسلمون يعتبرون الماء من العناصر الأربعة الأساسية التي تقوم عليها الحياة وأمزجتها وهي الماء والهواء والنار والأرض، وهو العنصر الحاسم في تحديد مكان إقامتهم وترحالهم.. أمنهم واستقرارهم.. تحالفهم وتنافرهم.. سلمهم وحربهم.. في حواضرهم وبواديهم التي يقيمونها دائما على منابع من الماء وعيونها ومجاريها…
وهو نعمة من الله تعالى يقابلونها بالشكر والحمد، قال تعالى: “وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد” ق/9. ماء مباركا ترتبط به حياة كل الكائنات كما في قوله تعالى:” وجعلنا من الماء كل شيء حي” الأنبياء/30. هو أول ما يستقبل به الوافد المولود وآخر ما يغسل به الميت المفقود، وهو عندهم طاهر يصلح للعبادة.. وطهور يصلح للعادة.. يغسل الذنوب وينعش الأرواح كما ينظف الأبدان من الأدران ويبعثها على النشاط والأفراح، قال تعالى:” وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام” الأنفال/11. وهكذا لا تجد مسجدا إلا وفيه ماء.. ولا حتى ضريحا إلا وفيه بئرا أو حوله ينبوع.. فالماء عندهم طهارة.. رواء.. بل شفاء، إنه من الأطباء الصم كالشمس الدافئة والهواء النقي والطعام الصحي، قال (ص): “إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء” رواه البخاري؟.
ومن مبادئ الماء في التراث العربي الإسلامي أنه حق للجميع والناس فيه شركاء لا يحق احتكاره ولا حرمان قوم منه، قال (ص): ” الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلأ” رواه أحمد وغيره. و واجب على الناس الاقتصاد وعدم الاسراف في استعماله ولو كان الأمر للوضوء والعبادة، ولو كان المرء على جنب نهر أو شط بحر، والماء عند المسلمين صدقة جارية بل من أفضل الصدقات، قال(ص):” أفضل الصدقة سقي الماء” رواه أحمد. وهو نعمة لا تلوث كما في الحديث:” لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (الذي لا يجري) ثم يغتسل منه” رواه مسلم. فلما للعديد من ودياننا وشواطئنا أصبحت اليوم من التلوث لا تطاق ولا تصلح لا للعادة ولا للعبادة.
أما “السقاية” و”التسبيل” المائي فقد بلغ عند المسلمين أن وقفوا لهما حسب الحاجة حتى لم تبقى لأحد إليهما حاجة، فكان أنه لا يذهب ذاهب أنى ذهب إلا وجد الماء والماء الصالح للشرب، في المسجد.. في الحج.. في الصحراء مع قوافل المسافرين.. في المراعي مع فيالق المواشي.. على صهاريج الطيور والخيول والأبقار والجمال.. في الحقول والمنتجعات.. في الحمامات والحامات.. وقد عبئوا من أجل ذلك كل الموارد من تساقطات الثلوج والأمطار.. وحمولات السدود والمجاري والأنهار.. وفرشات العيون والآبار.. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يشتري بئر يهودي في المدينة ويجعل مائها للمسلمين قطعا للاحتكار.. وهذه “زبيدة بنت أبي الفضل” زوجة هارون الرشيد، تشيد عينها تسقي بها الحجاج على امتداد حوالي 40 كلم وهي أكبر وقف مائي بعد وقف عثمان بن عفان للتمور، ورغم ذلك تأمر عمالها بالتشييد والبناء ولو كلفتهم ضربة فأس دينارا من الذهب.
لقد جمع المسلمون في تعاملهم مع الماء بين العبادة والعادة حتى أن بعض المتصوفة جعلوا طريق صناعة الواصل منهم من يقل في الماء والأكل عموما.. وجمعوا فيه بين الانتفاع والترفيه المباح.. فلم يفت الأندلسيين أن جعلوا لهم حدائق غناء ذات بهجة وبهاء.. وربما قد دفعهم إلى ذلك ما عاشوه من حياة الخصب والسلم والترف، ولكن أيضا ما استلهموه من كثرة حديث القرآن الكريم عن الجنة وأنهارها وحدائقها ذات بهجة ونعيم وجمال فوق الخيال، فأين منا تلك الأيام الخوالي والسنين الغوالي وكثير من حدائقنا دب فيها الجفاف ونافوراتنا معطلة لم تعد تمطر وسقاياتنا جافة لم تعد حتى تقطر.
لقد كان المسلمون يأخذون بالعرف في تدبير الماء وما جرت عليه عادة القوم وهم أعرف بشأن مائهم ودنياهم، ولكنهم كما يقول د. عادل عبد الرشيد في مقال له بعنوان ” التراث المائي العربي الإسلامي”، أبدع المسلمون خلال حضارتهم محاكم الماء تفض نزاعاته بين الناس وهي بمعنى قوله: ” محاكم شعبية محلية تتميز بالبساطة والشفاهية والسرعة والفعالية والمجانية والرضا بين المتنازعين”، كما أبدعوا في معرفة الأراضي التي يكون في عمقها الماء ما لم تتوصل إليها التقنيات الاستكشافية الحديثة. وأبدعوا في تخصيص نوع المزروعات التي تناسب أرضا دون غيرها.. ومنطقة دون غيرها.. وموسما دون غيره.. سقوية كانت الفلاحة أو بورية.
وأخيرا، لم يفتهم استدامة مواردهم المائية، بالدعاء وصلاة الاستسقاء، حتى أن بعض السلاطين يخرجون فيها بذواتهم متذللين وبأكفهم مبتهلين.. وكانوا يمطرون حتى أن عهدهم وصف بعزير المياه؟. أضف إلى ذلك عملهم بحديث الخصال الخمس لابن ماجة ومن بينها: ” ما منع قوم زكاة أموالهم إلى منعوا القطر من السماء”، ومن بينها: “لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع “، ومن بينها: ” ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخِذوا بالسنين”، ومن بينها: ” ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًّا من غيرهم”، ومن بينها ” وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم “، ومن بينها.. ومن بينها، ورغم كل ذلك كان يحدث أن يصاب القوم بالجدب والسنوات العجاف، لكنهم يخففون من وطئها عليهم بالسدود كسد “إرم ذات العماد” باليمن يسقي قومه كما أجذبوا، ويخففون من وطئها عليهم بالتضامن الاجتماعي الذي يعيدهم إلى أصلهم كالناس شركاء في ثلاث، وإلى فصلهم” من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له” ومن كان له فضل دابة.. ومن كان له.. ومن كان له..، فالفضل كله لله.. فلننفق من فضله ولنترك على قول “زبيدة” الحساب لرب الحساب يوم الحساب .


