ترغيب نوح عليه السلام قومه وحثهم على الاستغفار – علي محمد الصلابي
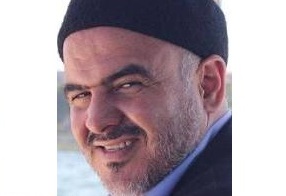
رغّب نوح عليه السلام قومه بالاستغفار حتى تتنزّل عليهم الخيرات، قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ (نوح: 10- 12).
بعد دعوة نوح الأولى لقومه وإصرارهم على الكفر والفسوق والعصيان، واستكبارهم عن اتباع رسول ربهم إليهم، صاروا على علم بمضمون دعوته، غير خالي الأذهان من أركان الإيمان وأركان الإسلام، وقواعد الدين الكبرى، ولم يبقَ لهم عذر بعد التبليغ، وصاروا كفرة مذنبين عن إرادة جازمة وتصميم، ولا بدَّ أن يكون نوح قد أبان لهم أنهم كفرة مذنبون، ولذلك تحّول عليه السلام مع قومه من الدعوة إلى مبادئ الإيمان وأركان الإسلام، وقواعد الدين الكبرى إلى بيان ما يجب عليهم من الإقلاع عن الذنوب التي هم غارقون فيها من الكفر إلى كل ما دونه من فسوق وعصيان .( الميداني، نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد، المرجع السابق، ص 185)
فحثّهم على الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى يقبل منهم التوبة مهما عظمت ذنوبهم وتكاثرت خطاياهم، فكأنه يقول لهم: لا تجعلوا خطاياكم الكثيرة حاجزاً بينكم وبين التوبة، ولهذا جاء بصيغة المبالغة “إنه كان غفاراً”، حثاً لهم وتشجيعاً لهم واستنهاضاً لهممهم، فإن القوم من كثرة ذنوبهم مُنع عنهم القطر من السماء، وأجدبت الأرض وضاقت بهم أنفسهم . (الرقب، منهج الدعوة إلى الله في سورة نوح، ص 67)
﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾:
أي: فقلت لهم: اطلبوا من الله أن يغفر لكم ذنوبكم، ومعلوم أنه لا يستغفر الله من ذنبه إلا من صحّ إيمانه، وأقلع عن ذنوبه، فهو إذا يدعوهم إلى الإقلاع عما هم فيه من كفر وفسوق وعصيان، ويدعوهم إلى طلب المغفرة من الله بعد ذلك .
وفي حديث نوح عليه السلام وتذكيرهم بأهمية الاستغفار، وطلب ذلك من الرب جل وعلا “ربكم” أهمية واضحة في التذكير باسم الكريم الرب، والرب: هو المالك المتصرف، ومعنى قوله تعالى “رب العالمين” ربوبيته للعالم تتضمّن تصرفه فيه، وتدبيره له، ونفاذ أمره كل وقت فيه، وكونه معه كل ساعة في شأن، يخلق ويرزق، ويُميت ويحيي، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويصرّف الأمور بمشيئته وإرادته، وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه . (ابن القيم، الصواعق المرسلة، 4/ 1223).
والربُّ هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا: تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعائهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه التربية الخالصة .( السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 5/ 486).
والربُّ في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام ، وفيه معنى الحنو الرعاية والعطف، ونوح عليه السلام في سيرته كان مستحضراً وتعبداً وداعياً لله بهذا الاسم فعلى سبيل المثال نجد ذلك:
في قول الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾.
وفي قوله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾.
وغير ذلك من الآيات التي جاءت على أبدع ما يكون ضمن السياقات المعروفة في قصة نوح عليه السلام.
ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه “الربّ”:
إن اسم “الربّ” سبحانه وما يستلزم من الأسماء والصفات، يتضمن تعريف الناس غايتهم التي خلقوا من أجلها، وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم، فكونه رب العالمين لا يليق به أن يترك عباده سدىً هملاً لا يعرفهم بنفسه ولا بما لا ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وما يضرهم فيها، فهذا هضم للربوبية، ونسبة للرب إلى ما لا يليق: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (المؤمنون: 115).
الإقرار بربوبية الله عزَّ وجل – يقتضي ويستلزم توحيد الله عز وجل- وعبادته لا شريك له، إذ إن الخالق لهذا الكون وما فيه والمتصرف فيه بالإحياء والإماتة، والخلق والرزق، والتدبير هو المستحق للعبادة وحده، إذ كيف يعبد مخلوق ضعيف، ويجعل نداً لله تعالى في المحبة والتعظيم والعبادة، وهو لم يخلق ولا يملك لنفسه تدبيراً فضلاً عن أن يملكه لغيره، وهذا ما احتج الله عز وجل به على المشركين الذين أقروا بربوبيته سبحانه، لكنهم لم يعبدوه وحده، بل أشركوا معه غيره، وقد جاءت هذه الاحتجاجات الكثيرة في القرآن الكريم بأساليب متنوعة منها: قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (الزمر: 38).
الإيمان بصفة الربوبية لله عز وجل: الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، إذ إن من صفات الرب سبحانه كونه قادراً، خالقاً، بارئاً، مصوراً، حياً قيوماً، عليماً، سميعاً، بصيراً، محسناً، جواداً، كريماً، معطياً، مانعاً، وقل ذلك في بقية الأسماء والصفات، فكل أثر من آثار الإيمان بالأسماء الحسنى هو في الحقيقة راجع إلى ما يتضمنه اسم “الرب” سبحانه . ( الجليل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ص 98.)
يقول ابن القيم: إنَّ الربَّ هو القادر الخالق الباري المصور الحي القيوم، العليم السميع البصير، المحسن المنعم الجواد المعطي المانع، الضار النافع، المقدم المؤخر، الذي يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، ويُسعد من يشاء، ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى .
ولما كان من معاني “الرب” أنه الذي يربي عباده وينقلهم من طور إلى طور، وينعم عليهم بما يقيم حياتهم ومعاشهم، وهو الذي أحسن خلقهم، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فإن هذه المعاني من شأنها أن تورث في قلب العبد المحبة العظيمة لربه سبحانه، وحب ما يحبّه ومن يحبّهن وبغض ما يبغضه ومن يبغضه، والمسارعة في مرضاته وتعظيمه وإجلاله وشكره وحمده الحمد اللائق بجلاله وعظمته وسلطانه وإنعامه.
ولما كان من معاني “الرب” أنه المتكفّل بأرزاق خلقه، وعنده خزائن السماوات والأرض، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، فإن هذه الصفات تورث في قلب العبد العارف لربه سبحانه قوة عظيمة في التوكل عليه سبحانه في جلب المنافع، ودفع المضارّ، وفي تصريف جميع أموره، فلا يتعلق إلا بالله تعالى، ولا يرجو إلا هو، ولا يخاف إلا منه سبحانه، إذ كيف يتعلق بخلوق ضعيف مثله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً .
ولما كان من معاني الربوبية اختصاصه سبحانه بجلب المنافع ودفع المضارّ، وتفريج الكروب، وقضاء الحاجات، فإن العباد بما أودع الله في فطرهم في معرفة ربهم بهذه الصفات – يلجؤون إلى ربهم ويتضرعون إليه في الشدائد والملمّات، وينفضون أيديهم من كل سوى الله عز وجل، وكلما عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته أثر هذا في دعائه وقوة رجائه، ولجوئه، وتضرعه لربه سبحانه، والوثوق بكفايته سبحانه، وقدرته على قضاء الحوائج ، وغير ذلك من الآثار في اسم الله عز وجل “الرب”.
وقد استعمل نوح عليه السلام عبارة “ربكم” في حديثه لقومه، لأن ربوبية الله لهم دائمة لا تتوقف على إيمانهم بها، بخلاف عبارة “إلهكم” أي: معبودكم، إذ هم لا يعبدون ربهم.
﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾:
أي: إن من صفات الله الدائمة أنه كثير المغفرة لعباده، فصيغة “غفّار” من صيغ المبالغة، ووصْف الله بصيغة المبالغة لا مبالغة فيه، بل هي الصيغة الأقرب للدلالة على حقيقة صفة الله عز وجل. واستعمال فعل “كان” للدلالة على الكينونة المستمرة، والوجود الدائم، وهكذا سائر النصوص التي استعمل فيها هذا الفعل بالنسبة إلى صفات الله عز وجل .
و”الغفّار”: سبحانه وتعالى: الستّار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته، ومعنى الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه، ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم .
قال ابن القيم:
وهو الغفور فلو أتى بقرابها
من غير شرك بل من العصيان
لأتاه بالغفران ملء قرابها
سبحانه هو واسع الغفران
قال الشيخ السعدي: الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب، ويتوب على كل من يتوب . وقال أيضاً: العفو والغفور والغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة لمن أتى بأسبابها، قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (طه: 82).
ومن ثمار الإيمان بأسمائه “الغفور والغفار”:
محبة الله عز وجل وحمده وشكره على رحمته لعباده، وغفرانه لذنوبهم، وهذا الأثر يثمر في قلب المؤمن توقي معاصي الله تعالى قدر الطاقة، وإذا زلّت القدم ووقع المؤمن في الذنب فإنه يتذكّر اسمه سبحانه
الغفور والغفار، فسيرى الرجاء في قلبه، ويقطع الطريق على اليأس من رحمة الله تعالى، ويُحسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميعاً.
فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعالى، والمسرفين على أنفسهم بعظائم الذنوب كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الزمر: 53).
الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات لأنها من أسباب الحصول على مغفرة الله تعالى للسيئات السالفة، قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (هود: 114). وقال سبحانه: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (طه: 82). وقولهصلى الله عليه وسلم : “وأتبع السيئة الحسنة تمحها” .
فكانت من مواعظ نوح عليه السلام الحسنة ترغيب قومه في استغفار ربهم، والإيمان به وبرسوله وإفراده بالعبادة، وبيّن لهم ولمن جاء بعدهم ثمار قانون الاستغفار الرباني، والتي من أهم ثماره:
﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾:
أي: ينزّل الأمطار على بلادكم غزيرة وافرة، وجاء استعمال فعل “يرسل” بدل “ينزِّل”، لما في الإرسال من معنى تأدية المرسَل مهمة كلَّف من أرسله أن يؤديَها، وحدّد له وظيفته فيها، وهذا ما يسمّى “الإرداف” عند علماء البديع، وهو اختيار لفظ بدل لفظ آخر هو الأصل في تأدية المعنى، وذلك لغرض بلاغي.
وجاء إطلاق “السماء” على الأمطار؛ لأنها كانت في جهة العلو سحاباً، فهي سماء، إذ كل ما هو في جهة العلو بالنسبة إلى ساكن الأرض سماء لغة، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء لغة
والمقصود بالسماء هنا – والله أعلم- ماء المطر، وإن كان من أسمائه عند العرب السماء، وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل .
– “عليكم”: أي: على أرضكم وبلادكم ومزارعكم لمنافعكم وسقياكم وسقيا أنعامكم، ودوابّكم .
– “مدراراً”: أي: إن استغفرتم ربكم يرسل المطر عليكم متتابعاً، كثير الدرور والغزارة، فيكثر الخير والخصب الغلال والثمار، ويعم الرخاء والاطمئنان، والسعادة والاستقرار .( الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، 29/ 142).
﴿ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ﴾:
المال والبنون من أولى مطالب الإنسان في الحياة الدنيا، وهما مزيّنان للناس فيها، وقدم الأموال لتعلّق قوم نوح بها، في المرتبة الأولى، وأما معظم الناس فالأولويات عندهم جاءت في قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ (آل عمران: 14).
﴿ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾:
“ويجعل لكم” أي في الدارين “جنات” أي بساتين عظيمة، “ويجعل لكم أنهاراً ” يخصّكم بذلك عمّن لم يفعل ذلك، فإن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً .( البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،8/ 169).
إنَّ الاشتغال بطاعة الله سبب يوجب زيادة البركة والنماء، وانفتاح أبواب الخيرات، وإدرار الأمطار، وزيادة الغلال، ووفرة الثمار، وقد وعدهم الله على الطاعة بخمسة أشياء: إنزال المطر، والإمداد بالأموال، والبنين، وجعل الجنات “البساتين”، وجعل الأنهار .
وعن الحسن البصري: أن رجلاً شكا إليه الجدب فقال: استغفر الله، وشكا إليه آخر الفقر، وآخر قلة النسل، وآخر قلة ريع أرضه، فأمرهم كلهم بالاستغفار، فقال له بعض القوم: أتاك رجال يشكون إليك أنواعاً من الحاجة، فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فتلا له الآية “فقلت استغفروا ربكم”.


