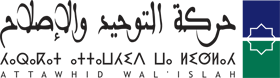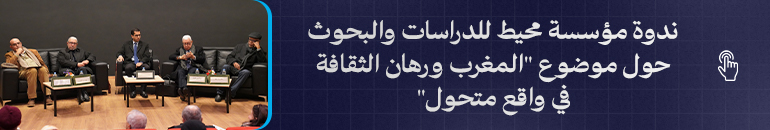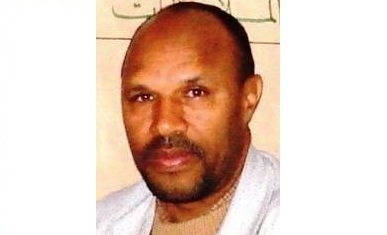الدستور والنظام السياسي المغربي – نورالدين قربال

توطئة:
سبق أن تحدثنا على جدلية الدستوري والسياسي، وفي هذه الإطلالة سنتحدث عن المقتضيات الدستورية في علاقتها بالنظام السياسي المغربي. أول ما يتبادر إلى الأذهان هو الحديث على النظام السياسي انطلاقا من التأصيل والشرعية المؤسسة لمشروعية الممارسة.
في هذا الإطار من الواجب أن نميز هذا التأصيل المعرفي على مستوى الفقه الدستوري بين الاختيار المعياري وآخر علمي مهني. الذي يعمق روح الثقة في النظام السائد. ثقة مؤسسة على منتوج سياسي خضع لتدافع اجتهادي تداخل فيه المحلي بحمولته التاريخية والاجتماعية والحضارية والعلمية الذي يترك مسافات لانتعاش العلوم المهتمة بهذا الموضوع والدولي بحجة التطوير والتجديد في إطار الثابت والمتحول.
إن التأصيل الدستوري لطبيعة النظام السياسي مجهود فكري وسياسي، يتباين في مفهوم السلطة، وكيفما كانت الاجتهادات فإننا نؤكد كما سبق تداوله أن السلطة توزيع عادل للقيم الديمقراطية بين الجميع. لهذه الاعتبارات يركز الدستور على منظومة مبدئية تؤطر طبيعة النظام السياسي. في هذه الحالة يمكن اعتماد المنهج المقارن مع استحضار الخصوصيات كما هو الشأن بالنسبة لجميع التجارب الدولية. من تم يستحضرا لدين والتاريخ والأنثروبولوجيا السياسية في بسط النظام السياسي في الدراسات الدستورية إضافة إلى المشترك العالمي.
إن مسلسل تحديد طبيعة النظام السياسي المغربي مرتبط بالنصوص الدستورية كوثيقة، والقانون الدستوري كدراسة ومقاربة، والدستورانية المصاحبة للمسلسل من الوضع إلى التعديل، وهذا غير كاف بل نستحضر كذلك ما اصطلح عليه بالأعراف والتقاليد. بين هذه الثنايا المنهجية تنمو الاجتهادات التي تعتمد بالإضافة إلى ما ذكر علوم أخرى نحو السياسة والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا وغيرها.
في هذا الإطار فالمباحث في هذا الاتجاه ليست توقيفية ولا تحنيطية وإنما توفيقية وتجديدية وحداثية، تخضع للتدافع المعرفي الذي بدونه تفسد الأرض.
الشرعية الدستورية والنظام السياسي المغربي
لقد تأثرت المدرسة الدستورية المغربية بثقافة “صاحب الحماية” الذي كان يبحث على شرعية السلم والأمن من خلال استحضار المكون التراثي للنظام السياسي. بعدما عجزعن فرض اجتهاداته المصاحبة للحماية في وضع الطبيعة الملائمة للنظام السياسي بالبلاد، ولا نستغرب أن النخبة المغربية بكل تلويناتها وضعت مشروع دستور سنة 1908 والذي اتسم بالجدية والمصداقية والواقعية، لكن تسربت الحماية سنة 2012 فنهجت منطق الناسخ والمنسوخ. فظلت الإيديولوجية حاضرة بثقلها إلى سنة 1962 حيث طرح منطق التأصيل الدستوري والسياسي لطبيعة النظام بمشاركة نخبة أجنبية. اعتبر هذا حسب المتتبعين تطورا ملحوظا خاصة عندا أقر بالملكية الدستورية. في هذه المراحل يمكن استنباط أمور أساسية:
1.جمع التجربة الأولى الدستورية بين المعطى المحافظ والحداثي.
2.إحالة القضايا الشائكة على القضاء العادي عندما يعجز الدستور عن حلها.
3.السياسة حاضرة في هذا المسار الدستوري والمؤشر هو وجود حوالي ست سنوات بين الاستقلال ووضع أول دستور: 1956-1962. لكن من باب فك طلاسم هذه المرحلة وضع تشريع عاد يهم تأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية التجمهر وحرية التعبير لأن السؤال الجوهري أنذاك متعلق بالاختصاصات بين المؤسسات الدستورية خاصة على مستوى تقاسم الحكم.
طرح عند البعض جدلية الديني والدستوري، بالنسبة لطبيعة النظام، خاصة عندما تمت دسترة البعد الديني باعتبار التباين بين الخصوصية الدينية الإسلامية والخصوصية الدينية المسيحية. ساهم في هذا النقاش البعد الإيديولوجي الذي انبثق من القطبية العالمية والحرب الباردة. كل هذا حسب تقديري قلص من الإيقاع التنموي عبر العصور، وبقي التدافع الإيديولوجي السياسي حاضرا في كل اللحظات.
مما زاد الأمر حيوية هو انتقال هذا التدافع من البعد السياسي إلى الأبعاد الاكاديمية. فطرح سؤال الشرعية دستوريا وسياسيا. كان الرهان هو اعتماد الحلول السياسية لأن القرار السياسي هو المنطلق في التغيير السوسيولوجي. من ضمن القرارات الاستراتيجية هو دسترة مفهوم البيعة باعتبارها تعاقدا بين النظام السياسي والأمة. بذلك أصبح لمفهوم إمارة المومنين مقتضيات دينية وسياسية تخضع لمنطق التجديد والمرونة.
نخلص من هذه الإطلالة إلى ما يلي:
-إن إدراك العلاقة بين الدستور والنظام السياسي تلزمنا اعتماد مقاربة سياسية وبرلمانية واجتماعية وديمقراطية.
-إن التطور الذي عرفه الارتباط بين الدستور والنظام السياسي كان وليد حركية علمية وسياسية تحاول التوفيق بين ما عرف بالأحكام السلطانية والملكية الحديثة.
-إن الأصل المعتمد في كل هذه الدراسات هو توفير أجواء الثقة بين المؤسسات والأمة، وإبداع طرق التواصل وتأصيلها دستوريا وعرفيا.
-إن إنجاح هذه الثقة على مستوى الدراسات الدستورية له مؤشرات على مستوى العلاقات العمودية والأفقية التي غالبا ما يتعامل معها باحتشام نحو المواطنة وقيمها المعرفية التي يلخصها التوازن بين الحقوق والواجبات.
نختم هذه الإطلالة الدستورية في علاقتها بالنظام السياسي المغربي، من خلال تأصيل السلطة والاختصاصات انطلاقا من المقتضيات الدستورية، التي تعتمد السمو في هرم الترتيب القانوني بالمملكة. وهذا تقدم إيجابي عندما أصبح الفاعل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ينطلق من الدستور والعودة إليه. ثم التحاكم عند القاضي الدستوري حسب المقتضيات التشريعية للمحكمة الدستورية.
لذلك أثناء تقويم العلاقة الذكورة في هذه الإطلالة لابد من استحضار بعض مضامين الدستور خاصة على مستوى التكاملية بين التشاركية والتمثيلية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها، والحريات والحقوق الأساسية، والمؤسسات الدستورية، والطبيعة الدستورية والاجتماعية والبرلمانية والديمقراطية للنظام السياسي المغربي، وسيادة الأمة التي تمارس مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها الذين يختارون بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، وتستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة نحو الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. كما ورد في الفصل الأول والثاني للدستور.