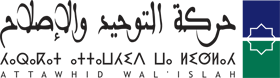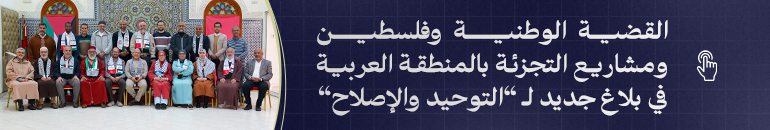الخرق كنداء : في إمكان المعنى وسط هشاشة التنظيم – كوثر الرايس
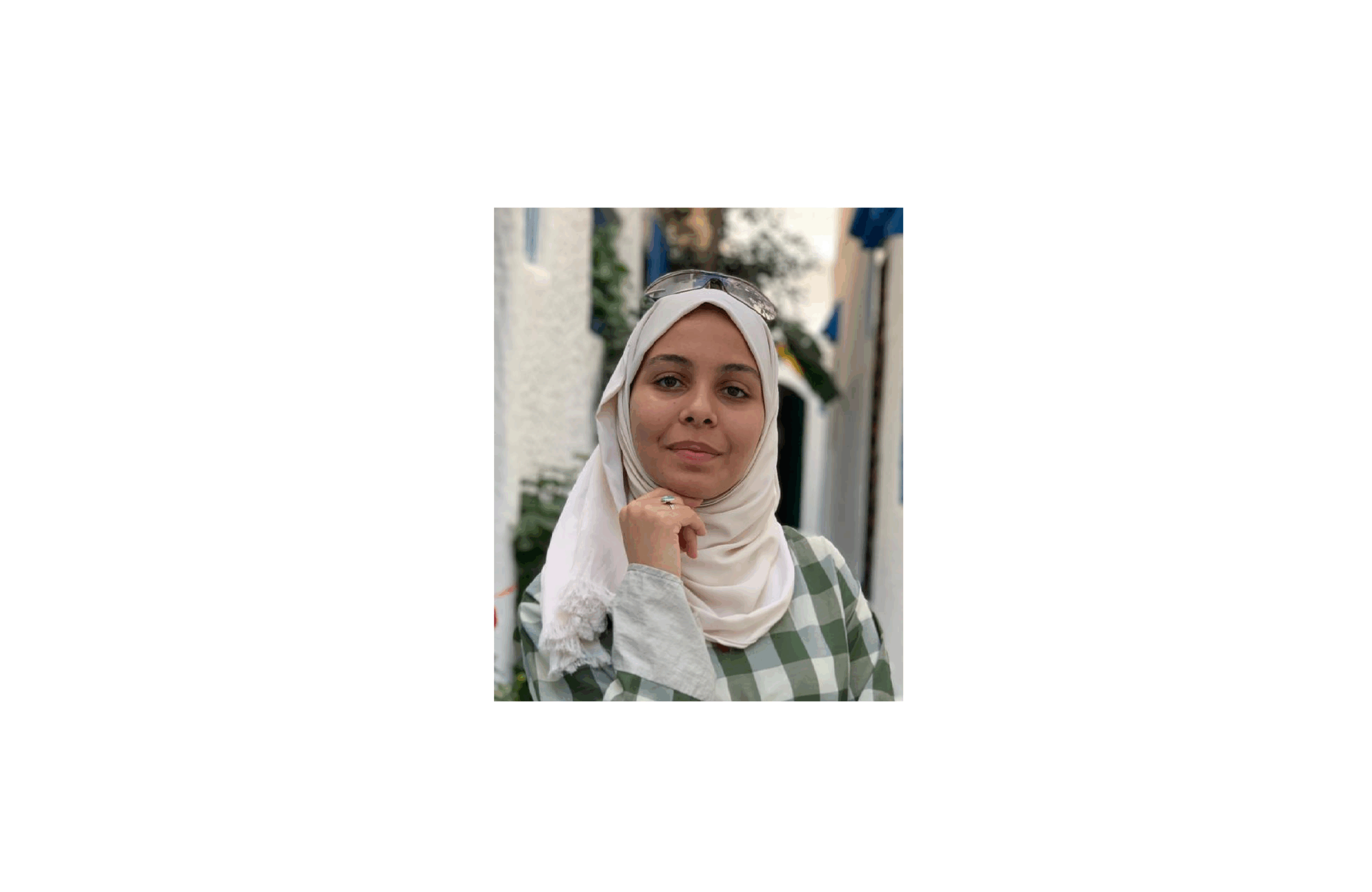
في دهاليز المعنى وعتبات التشكّل الجمعي، حيث تتصارع الإرادات لا على البقاء فحسب، بل على صياغة معايير البقاء ذاتها، ينبثق العمل التنظيمي لا كخيار نفعي عابر، ولا كآلية تدبيرية ميكانيكية، بل كمقام وجودي مركّب، تتواشج فيه الأنطولوجيا بالسياسة، ويتعانق فيه العيني بالمجرد. فالتنظيم، إذ يُنظر إليه من مقام التأمل العميق، لا يُختزل في إجراءات ولا في لوائح، بل ينهض ككينونة دلالية، كقصدٍ متعالٍ يتوسل الوسائط ولا يذوب فيها.
من هنا، فإن الجدوائية التنظيمية لا تستقيم بوصفها محصلة عددية تُقاس على مقياس الإنجاز الظاهر أو الانضباط الشكلي، وإنما تُفهم بوصفها قدرة على اجتراح المعنى وسط تشظي الواقع، وعلى تمكين الفعل من التشكل ضمن الأطر دون أن يُختنق بها. وكما أشار إدموند هوسرل: “النسق ليس هو الغاية، بل هو أثر الغاية وقد لبس لباس التوسط”. وبهذا المعنى، لا يكون التنظيم غاية في ذاته، بل يُرتجى كأداة لإنتاج الوجود-مع، أي تلك الحالة التي تتجاوز الجمع العددي إلى الالتحام القيمي.
وإذا ما سلّمنا بأن كل كيان بشري هو معرض للاهتزاز، فإن العمل التنظيمي، بحكم تعقيده وتشابك مستوياته، لا مناص له من أن يشهد لحظات الخلل، التي قد تتخذ هيئة خرق، أو تمظهرًا لانفلات رمزي، أو تراخٍ في تماسك البناء. لكن الخطر، كل الخطر، ليس في حصول الخرق ذاته، بل في القراءة الساذجة التي تُنزله منزلة الزلزال الذي لا يُبقي ولا يذر، أو في الانفعال الطهراني الذي لا يطيق رؤية العطب إلا كخيانة. إن هذا التمثل، في عمقه، يُظهر خوفًا من الحياة أكثر مما يُظهر حرصًا على النظام.
فالخرق – متى قُرئ بوعي تأويلي – لا يُعدّ انكسارًا جوهريًا، بل لحظة انكشاف، فرصة لإعادة الفهم، بل ومجالًا خصبًا لإعادة التأسيس. إنه لحظة «تجلٍّ» بالمعنى الهيغلي، حيث تتعرّى الفكرة من أوهامها لتُعاد إلى أصلها الجدلي، إلى صراعها الداخلي، الذي هو جوهر صيرورتها. وكما عبّر غاستون باشلار: “ليس العقل الحق هو العقل الذي يتجنب الصدمة، بل هو الذي يتولد منها”. فالخرق ليس بالضرورة انكسارًا في المعنى، بل قد يكون انعتاقًا منه.
بل إن التمترس خلف منطق الانسجام المطلق، ورفض الاعتراف بحدوث الخرق، قد يُفضي إلى ما يسميه ميشيل فوكو بـ”استبداد الخطاب”، حيث تغدو البنية معبودة، والنص مقدّسًا، والممارسة منزّهة عن السؤال. وهو استبداد أشد فتكًا من الخلل، لأنه يصادر إمكانية التجاوز. أما التنظيم الحيّ، فهو ذاك الذي يملك الشجاعة على الإنصات للخلخلة، لا كفزع، بل كنداء. كصرخة تطالب بإعادة الإنصات إلى نبض الجماعة، حيث الفعل أكثر صدقًا من الشعارات، والنية أسبق من الميثاق.
ولئن كان التنظيم ساحةً للصراع، فهو صراع نبيل، لا على السلطة، بل على المعنى. والخلاف فيه ليس عرضًا مرضيًا، بل علامة على اشتغال الفكر، على تحرك الإيمان في الأفق العملي. وهنا نستحضر بول ريكور حين قال: “الهوية تُبنى من جراحها، لا من مديح مراياها”، فهل ثمة تنظيم يُبنى إلا من أعطابه؟ وهل من فعل جماعي لا ينهض على ركام اللحظات المتعثرة؟
ثم إن من يتهيب الخرق خوفًا على التنظيم، يُغالب طيفًا من المثالية المفرطة التي لا تطيق هشاشة الواقع. لكنه واقع التنظيم، كما الواقع الإنساني، مشوب دومًا بالنقص، موشوم بالخطأ، ومجبول على التصدع. إن التنظيم الذي يحتمل الشك، ويصون التعدد، ويُجيد الإصغاء لحفيف الانحراف، هو وحده القادر على الاستمرار، لأنه وُلد من صراع لا من سكون، ومن محبة لا من سلطة.
وعليه، فإننا لا نخشى على التنظيم من الخرق، بل من الصمت عليه، من تحويله إلى تابو لا يُمسّ، من تلك القداسة الزائفة التي تُحيل التنظيم إلى صنم. أما التنظيم الحرّ، العاقل، النابض، فهو ذاك الذي ينهض من الرماد، ويجد في كل شقّ إمكانًا للضوء، في كل خلل شرارة تأويل، وفي كل عطب دعوة للعودة إلى الأصل: أن نكون معًا، لا لأننا بلا أخطاء، بل لأننا نؤمن أن المعنى يُبنى بيننا، لا فينا وحدنا.