الإضعاف الممنهج لتدريس العلوم الفيزيائية في المغرب – الحبيب عكي
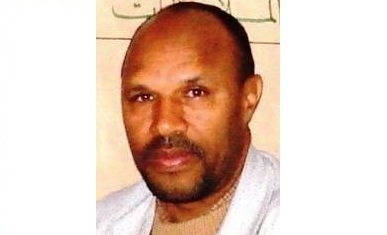
أين منا جلال وهيبة تلك السنوات الماضيات، حيث كان التلميذ تملؤه مشاعر الفخر والاعتزاز، لمجرد أنه كان يدرس العلوم وتوجه إلى إحدى التوجهات العلمية، على جلال قدرها، وأهمية معارفها ومتعة تجاربها، واستعمالها المكثف والضروري واليومي في الحياة العامة، في تشكيل العقلية العلمية للتلميذ، ونحت أسلوبه المنطقي في التفكير والتعاطي مع المشكلات والبحث عن الحلول للمستجد من الحالات.. في تعلم البرهنة والاستدلال والاستنباط والاستقراء، والتحليل والتركيب والتفكيك والملاحظة والاستنتاج على نهج (Claude Bachelard : O.H.E.R.I.C).. في الحكم على صحة الفرضيات والخلاصات من خطئها.
فإذا بالبرعوم اليافع وسيرا على نهج أساتذته وقدواته في علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض يصول ويجول في مختلف طرق التحليل، الطريقة العبثية (l’absurde) التقابلية (la contraposée) التكرارية (récurrence) التحليل والتوليف (analyse-synthèse).. يقنعك عند المناقشة، ويحيرك عند السؤال، ويبهرك عند الإجابة، ويحنتك أنت والسبورة عند المشاركة، وفي كل شيء يمارس بالعفوية والسليقة عمق التفكير وبراعة التحليل، ومهارة حل المشكلات وفن اتخاذ القرارات، واقتحام المستجدات، ويجعل كل من يراه لا يملك إلا أن يقول: فعلا، كانت هناك دراسة، وكانت هناك مردودية، واستفادت منها الأجيال.
اليوم مع تقدير كل المجهودات المبذولة، لم يعد شيء يسعف على ذلك، ولا حتى على نصفه أو ربعه أو شيء من ذلك. فما الذي حصل؟ وكيف فقدت المدرسة المغربية وهج تدريس العلوم، وربما، إلى درجة أصبح فيها سعي التلميذ إلى الظهور بالشغب، أفضل عنده من الظهور بشيء يسمى العلوم أو الآداب؟ وربما، إلى درجة أصبح فيه التوجيه إلى (Sciences Cuisines) و (Sciences Promenades) يساوي عنده التوجيه إلى العلوم التجريبية والعلوم الرياضية والتكنولوجيا والمعلوميات إن لم يكن مقدما عليها أفراد الهدر المدرسي وجماعات الفصل وجحافل التكرار؟ وبالتالي، لا غرابة أن يفقد المجتمع بحبوحة ما كانت تسمى بالتخصصات العلمية والوظائف التقنية والرقمية على أهميتها وتميزها ووفرتها آنذاك، لا غرابة أن نفقد بالأخص مساراتها العلمية تقليدية كانت أو مستجدة، مع ما يتيحه ذلك من استكمال الدراسات العليا في شعبة من شعبها ومسلك من مسالكها، مع ما يؤدي إليه ذلك أيضا عند الجادين والطموحين من البحث العلمي والتجارب والابتكارات التي تنهض فعلا بتنمية الوطن وتبصم على تقدم الأمة ومساعدة الإنسانية في معاركها ضد التخلف والانحراف، بدل المفترى عليه اليوم من أوهام النهوض والتنمية البشرية بمشاريع “السانجير” و”الهندية” والماعز والخرفان والأرانب والدجاج.
الواقع، أنه قد تظافرت العديد من النكسات وضرباتها القاضية على منتجعات العلوم، وكانت تصورية وجو ممارسة وممارسة صفية وإشعاع ثقافي..، وكانت في كل مرة تأخذ من قوة العلوم وعزمها حتى أصبحت المسكينة على ما أصبحت عليه اليوم من الترهل والعياء وفقدان البريق والمعنى “لا أرضا تقطع ولا ظهرا تبقي”. وفي مجال تدريس العلوم الفيزيائية مثلا، وقبل البحث عن حلول ومقترحات النهوض، يمكن تفصيل هذه النكبات والنكسات على الشكل التالي:
1 – على مستوى التصور: جاء بعض قادة “الإصلاح” أيام الميثاق الوطني، وتدبيرا لأزمة قلة الأطر والفضاءات، قالوا إن مادة العلوم الفيزيائية كغيرها من المواد، وبالتالي لا مبرر بأن تحظى بشيء يميزها عن غيرها ولا ينبغي، خاصة وأن التلميذ في مجرد المرحلة الإعدادية والاستكشافية لمختلف المواد ولم يتخصص بعد في أي منها، وبالتالي ينبغي أن تتساوى عنده كل المواد، من هنا نقصوا عدد ساعاتها.. نقصوا معاملها إلى مجرد واحد يتيم، سنوا إمكانية حذف تدريسها بالتجارب عند غيابها، وحذف تفويجها استثناء عند الاقتضاء، الجرم الذي أصبح فيما بعد قاعدة مضطردة، ارتفاع عدد التجار في الكتاب المدرسي دون أية ميزة خاصة غير موضة الأسماء، تجاوزوا التعليمات الرسمية والإطار المرجعي رغم ما كان يقع من التذبذب بين التدريس بالعربية والفرنسية، وهكذا.. وهكذا.. حتى أصبحنا اليوم وكأننا أمام مادة استثنائية أدبية لا أساسية ولا علمية.
2 – على مستوى جو الممارسة المختبرية: وقد تحكم فيها توجهين أو ثلاثة:
أولهما قضى بالتقشف وعدم الإنفاق على تجهيز المختبرات بالعتاد التجريبي ووسائل الإيضاح على أهميتها البالغة وكونها نقطة انطلاق كل شيء في العلوم التجريبية مثل علومنا،
التوجه الثاني نظرة أمنية ضيقة تقضي بالحذر من المواد الكيميائية التي تمكث في المختبرات وما قد يصل إليها من أيادي المستثمرين في عمليات الإرهاب المدمرة، ما جعل الجميع أساتذة وتلاميذ يزهدون في كل ما قد يأتي من إضافات التجارب ويكتفون بدروس علمية جافة على السبورة (Physique sur le Tableau) بدون تجارب مثيرة للملاحظة والسؤال والحليل والتعليل، ومما ساعد على ذلك أيضا غياب أي تأمين للأستاذ في تعامله مع المواد المختبرية وخطورتها، ولا تعويضه عليها.. ولا حتى برمجة ساعتيها في استعمال زمانه،
أضف إلى ذلك الخصاص المهول في عدد محضري المختبرات، وتعثر حماس الدعوة إلى تعويض التجارب العملية بالتجارب الافتراضية الرقمية وهو في بدايته، ذلك لغياب تلك الوسائل الرقمية وبرمجياتها في المؤسسات من جهة، وعدم الإحساس بالملموس والعملي في تلك التجارب البديلة من جهة أخرى، أما عن فرق البحث والابتكار والتجديد والإبداع في المؤسسات وعلى مستوى المديريات والأكاديميات، فمجرد كلام للاستهلاك والتمني.
يحكي لي أحد أساتذة المادة أنه كان بداية تعيينه قبل حوالي ثلاثة عقود، ومن فرط ما كان يعطي الطابع التجريبي حقه ومستحقه في تدريس المادة، كان يقوم في كل حصة وفي كل فصل بستة إلى ثمانية مجموعات من التلاميذ للتجارب، ويدير كل ذلك بدينامية الجماعة وببراعة، ويكون مستوى الفهم عند التلاميذ ومستوى مشاركتهم عاليا، وينعكس كل ذلك في مستوى تحصيلهم العلمي وتفكيرهم المنطقي، ومستوى النقط التي يحصلون عليها ومستوى النجاح الذي يحققونه، بل مستوى القدرة على المتابعة في التوجهات العلمية دون صعوبات ولا هوس الساعات الإضافية، واليوم – مع الأسف – ينتهي به المسار نتيجة كل الإكراهات السابقة والمتفاقمة إلى تجربة واحدة يقوم بها هو ذاته أمام السبورة، والتلاميذ في شغبهم واكتظاظهم لا يبالون، وقد يرى منها بعض المنتبهين شيئا وقد لا يرونه، وقد يقوم بدل كل ذلك بتجربة واحدة أخرى افتراضية رقمية إذا ما توفرت لديه آلة العرض (Data show) وأسعفته لوازمها البرمجية النادرة وروابطها الكهربائية الميتة.
3 – وعلى مستوى الممارسة الصفية: أصبح الأستاذ يمارس تدريسه في ظل مذكرات مقيدة للمبادرة والعطاء والتجديد والإبداع، ومع تلميذ – كان الله في عونه – مع ما يعانيه من تدني مستواه العلمي والمعرفي والتربوي واللغوي، مع صدمة إعادة فرنسة المادة فلا يستطيع التعبير والتواصل كما كان يفعل أيام التدريس بلغته العربية. يسأله الأستاذ في الفرض الكتابي أسئلة ذات أجوبة اختيارية، نعم أو لا؟ فيؤشر الطيب على كلا الاختيارين، ويسأله الأستاذ حدد شكل الجسم، مربع أم مستطيل، أو مكعب، فيجيب الطيب: إنه مربع مستطيل يشبه المكعب. أما عن الاشراف التربوي فقد قرأت أنه قد بلغ أرقاما قياسية يستحيل معها كل شيء غير الكذب على الذقون ( 128/1 يعني مفتش واحد ل128 أستاذ)، وهكذا إذن: ضعف المستوى، فرنسة المقرر، اكتظاظ القسم بعدم التفويج، غياب التجارب، هشاشة التكوين والإشراف، وننتظر النتيجة، وطبعا تأتي كما يخطط لها المخططون، تكرار، وتثليث، وطرد واستعطاف وإعادة المطرودين في دوامة تزداد ولا تتراجع. فاللهم لا شماتة.
4 – على مستوى الدعم والتواصل والاشعاع ونشر الثقافة العلمية: الحقيقة، أن أساتذة المادة والمشرفين على تأطيرها تربويا وعلميا، يتحملون أيضا جزء من المسؤولية رغم كل الاكراهات والتحديات، بدء من ضعف إلى غياب أي إطار قانوني ومهني يجمعهم كمهتمين وممارسين على غرار غيرهم في بعض المواد الأخرى في إطاراتهم المدنية المحلية والوطنية ولما لا الدولية، تأخذ على عاتقها كيفية النهوض بتدريس المادة عبر الممكن من الفرق التربوية والبحثية التجديدية.. الممكن من المنابر والوسائط والمنصات التفاعلية الثقافية التواصلية الاشعاعية، كمجلة متخصصة لتقاسم الخبرات والتجارب والبحوث تدعم طبعها الوزارة وأكاديميتها، أو موقع إلكتروني تفاعلي مع مختلف المستويات والفئات والهيئات، أو قناة أو صفحة رسمية ومفعلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا إلى ما يمكن إنشاؤه من أندية علمية بالمؤسسات التربوية لدعم تعلمات وعلمية وتواصل التلاميذ، واحتضان شغفهم في القيام بالتجارب وبحوثهم في بعض الظواهر والإشكالات/ ومحاولات تركيبهم للممكن من الأجهزة والمركبات، إلى غير ذلك مما يدعم نشر الثقافة العلمية في المؤسسات وتعميمها في المجتمع.
ويبقى أن تدريس هذه المادة العلمية التي هي العلوم الفيزيائية، لها أهمية كبرى في حياة التلاميذ وتشكيل عقولهم ومنطقهم في التفكير والتعامل مع المواقف والمستجدات والظواهر الحياتية والأشياء التقنية والآخرين، وهي مادة تستعمل في كل جوانب ومجالات الحياة وبشكل يومي مكثف، وهي من صميمها في كل شيء: في تحديد الأشكال وقياس المسافات، في الموازين والقياسات، في أدوات الكهرباء والآلات، في الألوان والصباغات، في المواد والصناعات، في الخلائط والفلزات والأشابات، في حركات السيارات وأنواع الطاقات..
ويحكي تاريخ الدول المتقدمة أنها ما تمكنت من نهضتها إلا عندما جعلت الثقافة العلمية ثقافة شعبية بدل الجهل والخرافات والتفاهات والفضائح والإشاعات. فهل انتهى دور العلوم الفيزيائية في المجتمع ولم نعد نحتاج إليها في معرفة ظواهر الماء والهواء، الضوء والكهرباء، الخلائص والخلائط، الاحتراقات والاختناقات، الطاقيات والفلكيات، الالكترونيات والروبوتات، الرقميات والمعلوميات؟ بلى، إنها الحياة، وروعتها وقبحها، ومنطق عقلها وخفقان قلبها، وتفاعلاتها وتحولاتها، وأمنها وسلامتها، وعقرب ساعتها وبوصلة توجهها، وشمس ضيائها ورقاص نهضتها. فمتى نعيد لتدريسها اعتباره اللائق؟ كيف ومتى وبأي مدى وهو اللازم والمطلوب؟






