الأسْبَلَة أو الثورة المائية التي لم تقع – الحبيب عكي
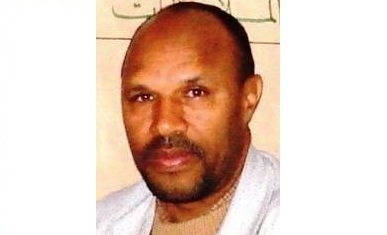
أتذكر إبان ذروة وطيس المؤتمر الدولي للمناخ coop22، كيف أن صحافيا قد زار منطقة الجنوب الشرقي للمملكة، فأزبد وأرعد تضامنا وترافعا بشأن ما استعره من غياب المرافق الصحية العصرية في المنطقة، مع ما يسببه ذلك من إذاية و”حكرة” لساكنة الجهة، هي في الأول وفي الأخير، هضم لحقوقها البيئية، مع أن نوع المرافق الصحية الموجودة في المنطقة، صحيح هي تقليدية ترابية.. بدائية غير عصرية ولا أنيقة.. ولكنها إرث حضاري قديم (شيخ الدار) يناسب الساكنة بكونه نظاما إيكولوجيا متكاملا، وبما تستفيد من فضلاته المنزلية التي تتخمر في تلك المرافق وتصبح سمادا جيدا لمزروعاتها في الحقول والواحات، طالما استعاضت بها عن الأسمدة الكيماوية المهلكة بأثمنتها المرتفعة الباهضة وأضرارها الجانبية البالغة؟.
من سمع مثل هذا الصحافي، وكل الأشخاص والهيئات المشاركة في تلك القمة على كثرتها.. قطاعات ومؤسسات وجمعيات.. وما استحدثته من مخططات وبرامج وشراكات ومشاريع وميزانيات، لا يخامره شك في أن ثورة إيكولوجية ستقوم في العالم وليس في المغرب فحسب، لكن مع الأسف، ها قد مرت القمة.. وبعدها قمم وقمم متتاليات، وقد وصلت اليوم ربما إلى القمة coop30، ولازالت الأوضاع البيئية في العالم ككل في مجملها هي الأوضاع، إن لم تكن في جوانب بيئية منها قد تراجعت إلى الأسوأ كما في مجال الماء والهواء. فأين يكمن الخلل؟، وهل مشاكلنا البيئية لا تستحق منا ومن بعض المسؤولين غير بعض البهرجة والاستعراض المناسباتي، سرعان ما يخبو بعدها بريقها وازدحامها وكأنها قد حلت وهي لم تحل بل ربما تعقدت؟.
فلو أخذنا من الإشكالات البيئية إشكال الماء وحده وفي أبسط مستوياته وأدناها وهي توفير الماء الشروب للجميع، في ظروف جيدة وخدمات مصونة وتكلفة مناسبة، باعتباره حقا مشروعا، ففي الوقت الذي نجد فيه أن التراث المائي في الحضارة الإسلامية، يحكي على أن المسلمين كانوا ممن أبرع في هذا المجال المائي توفيرا وتوزيعا جريانا وجمالا في حدائق غناء..، وبدوافع عقائدية على رأسها جمالية القرآن في حديثه عن الجنة، ومبدأ: “خير الصدقات سقي الماء”، ومبدأ: “الأسبلة”، يعني جعله صدقة جارية في سبيل الله، ومبدأ: “في كل ذي كبد رطب أجر”، ما جعلهم يتشبعون بثقافة “الوقف” لتجسيد هذه القيم المائية الخالدة، فحفروا العيون والآبار، ووقفوا المجاري والأنهار، وملئوا الصهاريج وخزنوا الأمطار، وسقوا بها الحقول والأشجار، والحدائق والبهائم والأطيار، والحجاج في طوافهم وقوافل الأسفار وعمار المساجد في الأسحار، ديدنهم في كل ذلك اعتقادهم الفعلي والعملي بأن الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار.
واليوم، ونحن نعتقد نفس المعتقد، ونعقد قمما مناخية، ولدينا برامج سياسية تنموية، وجمعيات بيئية ومجالس ترابية، وننظم ندوات علمية ونخطب خطبا منبرية، صحيح يكفيها مردودية أن حوالي 86% من الساكنة أصبحت مرتبطة بالشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب، ولكن لا تزال نسبة العالم القروي والأرياف فيها لا تتعدى ربما حوالي 40%، بعيدا عن هذا وعودة إلى صحافينا الغيور على المرافق الصحية في الجنوب الشرقي وعالمه القروي. أين هذه المرافق في العديد من الفضاءات العمومية، والمؤسسات التربوية، والشوارع العمومية، والمخيمات الصيفية، والمحطات الطرقية، والأسواق الأسبوعية؟، والمدارات السياحية، والحدائق العمومية، والمنتجعات الترفيهية، والملاعب الرياضية..، بل حتى ما يوجد منه – قليله أو كثيره – في أسوأ حالة صحية، يهم القائمين عليها أكثر من النظافة والارتفاق الحسن، ما ينتزعونه من المواطن المضطر مقابل الارتفاق وأي ارتفاق، وهكذا أصبح المسكين – مع أسبلة العصر – يدفع مقابل الأكل والإدخال .. ويدفع مقابل التبرز والإخراج ؟.
هناك العديد من أوجه التطوع و”الأسبلة” الصدقة الجارية التي ينبغي أن نحييها ونحافظ عليها اليوم كما يلزم، علنا نساهم بشكل ناجح وفعال في رتق ما أصاب مجال مائنا العمومي الشروب من إهمال لا يطاق نتجت عنه معاناة يومية شاملة ومستدامة تطال الجميع، لكن، يمكن الإسعاف فيها وإلى حد كبير بجهود المخلصين من المسؤولين والغيورين من المواطنين عبر قطاعات حكومية مسؤولة وهيئات مدنية مواطنة ومجالس ترابية تنموية كل تنافسها ومصداقيتها في التعاون على العديد من المشاريع التنموية المواطنة وعلى رأسها مشاريع “الأسبلة المائية عبر الوطن:.. كترميم “السقايات”.. حفر الآبار.. تحويط العيون.. بناء “نطفيات” الأمطار.. توفير المضخات.. تثمين “الخطارات”.. توفير الماء للمساجد.. الحمامات الشعبية والشلالات السياحية والمسابح الترفيهية.. التسبيل على حراس المرافق الصحية العمومية ومنظفيها.. صهاريج الطيور والدواب.. السقاية في أماكن الحفلات والتجمعات.. السدود التلية الصغرى.. آبار لماء الرعاة في الواحات.. وقوافل المسافرين في الصحراء …
إنها مسؤولية جماعية ويكفي أهلها ما ورد فيهم وبشرهم به حديث رسول الله(ص): “سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره: “من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته”، سنن ابن ماجة. فكفانا من التجاذبات والحسابات الفارغة، إلى العمل والتعاون، ولنترك الحساب لصاحب الحساب إلى يوم الحساب.


