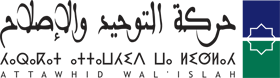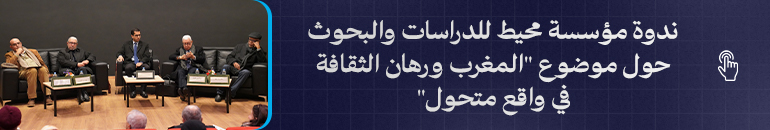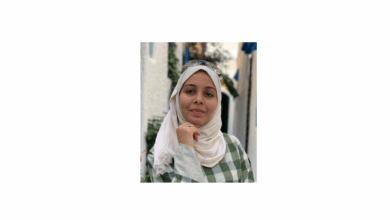وحدة القضايا بدل وحدة الإطار: نحو نظرية جديدة للفعل الطلابي المغربي – مصعب شرعي

منذ عقود، ظل حلم توحيد الحركة الطلابية في إطار نقابي جامع حاضرا بقوة في الوعي الجماعي للطلبة المغاربة. ولم يكن هذا الحلم مجرد طموح تنظيمي، بل كان تعبيرا عن أمل في تجاوز الانقسامات الفكرية والتجزيء الفصائلي الذي نخر الجسد الطلابي، وتحقيق وحدة قادرة على الدفاع عن قضايا الطالب المغربي وصون استقلالية الجامعة.
وقد تجسد هذا الطموح، في مرحلة تاريخية مفصلية، من خلال تجربة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التي مثلت نموذجا للوحدة الممكنة، حينما استطاعت احتضان عددا من المكونات السياسية والاتجاهات الفكرية في فضاء نضالي مشترك. غير أن هذا النموذج ما لبث أن تآكل من الداخل، تحت ضغط التناقضات الإيديولوجية واستعصاء إدارة التعدد، حيث غلبت عليه نزعة الإقصاء الممنهج، التي مارستها بعض المكونات، خاصة ذات المرجعيات الماركسية، بحق تيارات أخرى، على رأسها المكون الإسلامي، من خلال العنف الرمزي المادي.
ولم يكن هذا الإقصاء نتيجة موقف مبدئي من اختلاف المرجعيات فحسب، بل هو جزء من ثقافة أعمق، تشكلت داخل بعض التنظيمات، مفادها احتكار تمثيلية النقابة باسم “التقدمية”، وتكريس تصور أحادي للهوية الطلابية، جعل من العمل الوحدوي وسيلة للضبط لا مجالا للتعدد، وللإلحاق لا للتعايش. وقد تراكمت هذه السلوكات عبر سنوات، وكرست في الذاكرة الطلابية مشاهد العنف والتخوين، وأسهمت في تآكل الثقة داخل الحقل الطلابي، وجعلت من مطلب الوحدة، على نبله، شعارا أجوف ترفعه ذات الأطراف التي أسهمت في إجهاضه.
ورغم محاولات متكررة لإحياء الفكرة الوحدوية، فإن استدعاء النموذج التقليدي للوحدة، دون مراجعة نقدية للشروط التاريخية التي أفضت إلى انهياره، بات يمثل عائقا أمام تجديد الفعل الطلابي بدل أن يكون رافعة له. وقد تزامن هذا مع تحولات عميقة مست بنية الجامعة نفسها، وسلوك الطالب المغربي الذي بات أكثر انكبابا على همومه اليومية، وأقل انجذابا خلف القضايا السياسية العامة والفكرية. كما أن التنظيمات الطلابية فقدت الكثير من زخمها التعبوي وشرعيتها التمثيلية، وقد تفاعلت هذه التحولات مع اختيارات الدولة التي ساهمت، بدورها، في تحجيم العمل النقابي وتقنين الفضاء الجامعي، مما زاد من تعقيد شروط الوحدة.
إن التمسك بالماضي دون مساءلته، وتحويله إلى إطار مغلق يعيق المبادرات الجديدة، لا يمكن إلا أن يعمق الانغلاق، ويزيد من تفاقم أزمة العمل الطلابي. فالحاجة اليوم ليست إلى استعادة النموذج كما كان، بل إلى تجاوز عقدته، وبناء تصورات بديلة تعترف بالتحول، وتؤسس لأشكال نضالية واقعية تتسع للتعدد، وتعيد للطالب مركزيته كفاعل لا مجرد تابع.
أولا: ملامح الأزمة في مشروع الوحدة الشاملة
لم تعد الفصائل الطلابية تعبر فقط عن تباينات سياسية، بل اتسع التباعد بينها ليشمل اختلافا جذريا في المرجعيات الفكرية والمنظومات القيمية، وتحول في كثير من الأحيان إلى منطق إقصاء ورفض تام للاعتراف بالآخر. وفي غياب أي أفق للتكامل، فقد تحول الإطار المشترك إلى ساحة صراع دائم على الشرعية، وفضاء لمحاولات متكررة لإعادة تشكيل الهوية الجماعية وفق منطق الهيمنة لا التقاطع. وقد عمقت الذاكرة الجماعية للأطراف هذا الانفصال، إذ لا تزال مثقلة بصور العنف المعنوي والمادي الذي طبع علاقة الفصائل ببعضها خلال العقود الأخيرة، وهو ما جعل أي مبادرة وحدوية محاطة بسياج من الشك، ومقرونة في لاوعي الطلاب بمخاطر التوظيف والسيطرة.
غير أن هذا التفكك في الحقل الطلابي لا يمكن فهمه فقط من خلال مسؤولية الفصائل وممارساتها الإقصائية، بل يتعين تحليله ضمن بنيات أعمق، تعد فيه الدولة فاعلا بنيويا أساسيا. فقد ساهمت السياسات الرسمية، سواء عبر تدبير الزمن الجامعي، أو عبر ضبط الحريات داخل الحرم، أو من خلال تغييب البعد السياسي من التكوين، في إضعاف شروط النضال المشترك، وتشجيع التشرذم الفصائلي، بل أحيانا توظيف بعض المكونات في تكريس إقصاء ممنهج ضد خصومها. وقد تجلى ذلك بوضوح منذ بداية الثمانينات، حين أجهضت تجربة “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” بحظره سنة 1981، وهو الحظر الذي لم يكن نتاج قرار سلطوي منفرد، بل نتيجة التقاء موضوعي بين رغبة الدولة في تحجيم الحقل الطلابي، وضعف النضج السياسي في إدارة التعدد داخل النقابة. وما تلا ذلك من محاولات متكررة لإعادة بعث الإطار النقابي سرعان ما اصطدم بإرث الصراع، وبدخول المكون الإسلامي إلى الجامعة، وما رافقه من محاولات الإقصاء والعنف، مما ساهم في تجذير القطيعة وترسيخ مناخ من انعدام الثقة. وهكذا، لم يعد المشكل مقتصرا على الانقسام، بل بات يشمل تفتيتا مستمرا للمجزأ نفسه.
ويزيد من تعقيد المشهد غياب أي جهة مرجعية تحظى بشرعية رمزية وقبول مشترك، يمكن أن تؤطر الحوار بين الفصائل أو تواكب بناء شروط العمل المشترك. ونتيجة لذلك، تفقد دعوات الوحدة معناها العملي، وتستقبل غالبا كخطابات مموهة تخفي طموحات الهيمنة تحت غطاء الوحدة. وفي هذا السياق المتأزم، لم يعد الطالب المغربي يشكل الامتداد الطبيعي للأجيال النضالية السابقة، التي تميزت بدرجة عالية من التسييس والانخراط التلقائي في العمل النقابي. فقد أعادت التحولات السوسيو-ثقافية والاقتصادية صياغة علاقته بالجامعة وبالفعل النضالي، فبات يميل إلى منطق المنفعة المباشرة والمطالب العينية أكثر من ميله إلى الاصطفافات الإيديولوجية الصلبة.
وهكذا، لم تعد مركزية الانتماء الفصائلي كما كانت في السابق، بل صعدت مكانها هوية طلابية جديدة: واقعية، حذرة من الصراعات القديمة، ومشروطة بنتائج ملموسة. ولم يعد العمل النقابي يقاس بما يرفعه من شعارات أو ما يحمله من خلفيات فكرية، بل بما يحققه فعليا من تحسين في شروط الحياة الجامعية.
ثانيا: استعادة مركزية الطالب
إن أبرز مظاهر الاختلال في الخطاب الوحدوي هيمنته على هاجس التنظيم، بدل أن يتمحور حول الطالب باعتباره الغاية والفاعل الأساس. فقد تم اختزال فكرة الوحدة في تمثيل داخل النقابة وفي موقع داخل الهيكلة، بدل أن تفهم باعتبارها أداة لتحسين أوضاع الطلبة وتحصين الفضاء الجامعي من التراجع والتفكك. هذا التصور التنظيمي الضيق، الذي لم يشذ عنه إلا بعض الاجتهادات القليلة كتصور “معالم الحل الاستثنائي” لفصيل طلبة الوحدة والتواصل، أفرغ مفهوم الوحدة من قيمته الأخلاقية، وحوله إلى وسيلة تنازع رمزي بين المكونات.
لقد أدى هذا الانزياح نحو هاجس التنظيم والتموقع داخل البنية النقابية إلى تهميش الوعي الطلابي كعنصر فاعل في تقرير أولويات النضال، واختزال الوحدة إلى “ترتيب فوقي” بين الفصائل، بدل كونها تعبيرا عن حاجة جماهيرية نابعة من الواقع الجامعي نفسه. وهكذا، لم تعد الوحدة أفقا تحشد حوله التعبئة الطلابية، بل تحولت إلى موضوع تفاوض نخبوي يجري بمعزل عن التفاعل المباشر مع الطالب، وهو ما زاد من فجوة الثقة، وأدى إلى تراجع المشروعية الرمزية للخطاب الوحدوي ذاته.
إن أي مقاربة جديدة للفعل المشترك لا يمكن أن تبنى إلا على استعادة الطالب كمحور مركزي ومصدر أصيل للشرعية. فهو من يحدد أولويات النضال انطلاقا من تجربته الحية داخل الحرم الجامعي، وهو من يزن جدوى المبادرات بميزان أثرها الواقعي لا بشعاراتها النظرية، وهو وحده من يمنح العمل الطلابي مشروعيته الجماهيرية لأنه المعني الأول بنتائجه.
لكن استعادة مركزية الطالب لا تعني فقط استحضاره كشعار، بل تقتضي وعيا عميقا بتحولاته القيمية والمعيشية، والانصات لأسئلته الجديدة التي لم تعد تنبع من مرجعيات إيديولوجية صلبة، بل من واقع اجتماعي هش، وتحديات يومية ضاغطة. ولذلك، فإن أي خطاب وحدوي لا يتكامل مع هذه التحولات، ويستمر في مخاطبة الطالب بلغة التنظيمات لا بلغة الحاجات، سيظل خطابا متجاوزا لا يلقى صدى في الوعي الطلابي الجديد، ولن ينجح في بناء مشروعيته الجماهيرية.
وفي ضوء ذلك، لا ينبغي النظر إلى الوحدة كغاية في ذاتها، بل كوسيلة لخدمة الطالب وصون كرامته داخل الجامعة. وكل وحدة تتجاهل حاجات الطالب الفعلية، وتقصي وعيه وتفضيلاته، لا تعدو أن تكون عبئا إضافيا على كاهله، بدل أن تكون مكسبا نضاليا في صالحه.
ثالثا: نحو هندسة نضالية جديدة: التنسيق المحلي كبديل واقعي
لم يعد ممكنا، في ظل المعطيات الراهنة، التشبث غير الواقعي بالوحدة الشاملة على المستوى الوطني، لا من حيث الشروط التنظيمية ولا من حيث المناخ الطلابي العام. فالأفق العملي الذي بات يفرض نفسه اليوم هو أفق “الوحدات الميدانية المرنة”، المبنية على تنسيقات موضوعية وواقعية تنشأ داخل فضاءات محلية محددة، وتتأسس على قضايا جماهيرية ذات طابع ملموس ومشترك. هذا التحول في النظر إلى العمل الوحدوي لا ينبني على قطيعة مع مبدأ الوحدة، بل يعيد تعريفها ضمن شروط قابلة للتحقق، بعيدة عن التجريد أو التعميم النظري.
فالوحدة الميدانية، كما يقتضيها هذا التصور، تجد فعاليتها في ارتباطها بسياق مكاني وزماني محدد، مثل كلية معينة أو حي جامعي معين، وبملف مطلبي واضح المعالم. هذا التحديد يجعل من التنسيق أداة عملية قابلة للتنفيذ، ويمنح الفاعلين إمكانيات أوضح لبناء الثقة المتبادلة، وتحقيق أهداف قابلة للقياس. كما أن اختيار القضايا ذات الطابع الجماهيري – من قبيل السكن الجامعي، أو تحسين جودة التكوين، أو الدفاع عن الحريات الأكاديمية، أو مناهضة التطبيع – يوفر قاعدة صلبة للتلاقي بين مختلف الحساسيات، بما تتسم به هذه القضايا من قدرة على تجاوز الاصطفافات الفصائلية، وتمثيلها لمطالب يتقاسمها عموم الطلبة.
غير أن هذه الصيغة التنسيقية لا يمكن أن تنجح إلا إذا بنيت على ميثاق داخلي واضح يضبط العلاقة بين الأطراف، ويمنع منطق الاستحواذ أو التوظيف الفصائلي، ويكرس قيم الشفافية والتشاركية. فكل وحدة ميدانية ناجحة تحتاج إلى تعاقد أخلاقي وتنظيمي يجعل من الالتزام قاعدة، ومن احترام الخصوصيات شرطا أساسيا لضمان الاستمرارية.
ثم إن من متطلبات هذا النموذج المرن، الانفتاح على مختلف أشكال التجريب، وتجاوز هاجس الصيغة المركزية أو الإطار الجامع. فالتنسيقات المحلية لا تحتاج إلى إذن مركزي أو توافق شامل، بل إلى إرادة مبادرة تنطلق من الواقع وتحاول التأثير فيه. إننا إزاء نضال يتشكل من الأسفل، عبر مراكمة التجارب، وتوسيع مساحات الفعل المشترك، لا من خلال فرض نماذج جاهزة أو انتظار لحظة توافق وهمية.
رابعا: من مركزية الفصيل إلى مركزية المشترك: نحو تجديد الفعل الطلابي
إن التحول من منطق “وحدة التنظيمات” إلى أفق “وحدة القضايا” لا يفهم باعتباره إلغاء لخصوصيات الفصائل الطلابية أو مصادرة لمشاريعها الفكرية والسياسية، بل هو في جوهره دعوة إلى تجاوز منطق التموقع والصراع على الشرعية، والانتصار لثقافة التلاقي حول القضايا التي تعبر عن هموم الطلاب المشتركة وتطلعاته الفعلية. فهذا النموذج لا يتصادم مع حق كل مكون في الحفاظ على هويته ومتابعة مشروعه التأطيري والسياسي، والاستمرار في الاستقطاب والنقاش والتأثير، بل يفتح أمام الجميع إمكانية الاشتغال المشترك على أرضية نضالية متوافق عليها، دون أن يطلب من أي طرف أن يذيب خصوصيته أو يتنازل عن مرجعيته.
هذا المسار، القائم على تقاطع الإرادات بدل تصادمها، يتيح إعادة الجامعة إلى مكانتها الطبيعية كمجال لتشكل النخب وبلورة الوعي الجماعي، وكفضاء مفتوح لتجريب المبادرات وبناء الثقة واستعادة تقاليد الحوار والانخراط الجماهيري. كما يعيد للفعل الطلابي موقعه الريادي في معادلات التغيير، ويمنح الجامعة القدرة على تخريج أطر تعبر عن نبض المجتمع، وتحمل تطلعاته، وتؤثر لاحقا في دوائر القرار؛ لا باعتبارها مجرد امتداد لحساسيات سياسية قائمة، بل كمصدر متجدد للإرادة والبناء الجماعي.
ومع الإقرار بأن وحدة القضايا ليست وصفة جاهزة، بل مسار معقد يتطلب إنضاج شروطه الثقافية والتنظيمية، فإن الاكتفاء بانتظار اكتمال هذه الشروط دون مبادرة، لا يؤدي إلا إلى مزيد من الجمود. لذا، فإن خيار التجريب الميداني، داخل فضاءات محلية محددة، يمثل مدخلا واقعيا لكسر هذا الجمود، وصناعة نماذج وحدوية ملهمة. فحين يلمس الطالب نجاعة الفعل المشترك، ويعاين أثره المباشر على حياته الجامعية، يصبح التشبث بالأطر التنظيمية التاريخية أقل صلابة، وتتاح أمام مختلف المكونات – بما فيها التي تتبنى مواقف متصلبة – إمكانيات لإعادة النظر في اختياراتها. ذلك أن المرجعية الجماهيرية التي تؤطر بعض الفصائل، وعلى رأسها المكونات الماركسية، قد تدفعها إلى مراجعة نوستالجيا الصراع، متى تحركت الجماهير خارج منطق القطيعة، باتجاه التنسيق حول قضايا ملموسة تمس مصالحها المباشرة. وهكذا، تصبح النماذج الناجحة أداة حية لإعادة تشكيل الوعي، لا من خلال الخطاب، بل من خلال الممارسة.
خاتمة:
لقد شكل حلم الوحدة الشاملة داخل الجامعة المغربية لحظة وعي نضالي كبرى، انبثقت من سياق تاريخي كانت فيه الجامعة ميدانا للتفاعل الفكري والنضال السياسي والاجتماعي، غير أن الإصرار على استنساخ هذا الحلم خارج شروطه وسياقاته، دون نقد ذاتي جريء ولا مراجعة صريحة للتجربة، جعل منه عبئا رمزيا يثقل الحاضر، بدل أن يكون أفقا ينير المستقبل.
إن ما يطرحه هذا المقال لا يلغي قيمة الوحدة بوصفها مبدأ نضاليا أصيلا، بل يعيد وضعها في إطارها الواقعي، كغاية لا تتحقق بالشعارات أو النوايا، بل ببناء شروطها العملية والثقافية والتنظيمية. فالوحدة الحقيقية لا تبنى على التماثل القسري ولا على تصفية الخصوصيات، بل على تقاطع الإرادات حول ما هو جامع وملموس، دون مصادرة ما هو متميز وخاص. وهي بهذا المعنى، ليست صيغة هيكلية فوقية، بل ممارسة يومية تنمو من الأرض وتستجيب لحاجات الطالب وهمومه.
لقد آن الأوان لتجاوز “نوستالجيا” الوحدة المغلقة، والانخراط في بناء نظرية جديدة للفعل الطلابي، تضع الطالب في المركز، وتعلي من قيمة المشترك، وتنصت لتحولات الواقع الجامعي. وحدة القضايا ليست تراجعا، بل خطوة نحو الأمام؛ نحو جامعة فاعلة، وطلبة مؤثرين، وحركة طلابية متجددة، تعرف من أين تبدأ، وإلى أين تتجه.
ومن هنا، فإن استعادة الجامعة لدورها كفضاء منتج للنخب، وكطليعة للتغيير المجتمعي، تمر عبر تجديد الفعل الطلابي وتجذيره في التربة الاجتماعية الجديدة، بما يتيح تشكل أطر أكثر وعيا بمسؤولياتها، وأقدر على التأثير في رسم السياسات العمومية وصناعة القرار. وهي مهمة لا تنهض بها الشعارات، بل تبنيها التجارب، وتصقلها المبادرات الصادقة، وتمنحها المشروعية مشاركة الطالب فيها وانخراطه الفعلي في توجيهها.
ومع ذلك، فإن هذا الفعل، وإن انطلق من مستوى محلي محدود، يحمل في طياته قابلية التراكم والتوسع، مما قد يعيد الطالب إلى قلب التوازنات الجامعية والمجتمعية. ولذلك، فإن أي مسار وحدوي، حتى وهو في بدايته، يتطلب من الفاعلين وعيا مبكرا بمسؤولياته، ويقظة تجاه احتمالات إعادة إنتاج أخطاء الماضي التي فتحت المجال سابقا أمام التدخلات الخارجية، وأضعفت مناعة الحقل الطلابي، وأجهضت مبادرات واعدة.